كانت رحلاتي في ألمانيا على وشك أن تظهر لي لمحة عن التجربتين الألمانية والسورية في أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وكيف شكلتا الطرق التي ينظر بها اللاجئون والمجتمعات المضيفة إلى أنفسهم وإلى بعضهم بعضاً.
23 / أيلول / سبتمبر / 2023

*مع العدالة: المصدر “مؤتمر السوريين الأمريكيين للميثاق الوطني”
في 17 أيار/ مايو 1686، وصل حوالي 15 من “الكالفينيين” الفرنسيين، المعروفين باسم “الهوغونوت“، إلى مستوطنة صغيرة خارج “نورمبرغ” في ما يعرف الآن بألمانيا، هرباً من الاضطهاد الكاثوليكي في وطنهم فرنسا. لقد كانوا الأوائل من بين العديد من هؤلاء اللاجئين الذين رحب بهم “كريستيان إرنست“، حاكم براندنبورغ-بايرويت. مع وصول المزيد من الهوغونوت، وكذلك اللوثريين وغيرهم من البروتستانت من أجزاء مختلفة من الإمبراطورية الرومانية المقدسة، نمت المستوطنة ببطء. أصبحت مدينة جديدة أسسها اللاجئون ومن أجلهم، وأصبحت تُعرف باسم إرلانجن.
بعد ما يقرب من مائتي عام من إقامة آخر قداس في الكنيسة باللغة الفرنسية في إرلانجن، كانت موجة جديدة من اللاجئين، الذين تجاوز عددهم عدد الهوجوينوت، والذين فروا من نوع مختلف من الاضطهاد، يتوافدون إلى ألمانيا. لقد دخلوا البلاد على أمل البدء في حياة جديدة، أكثر أمانًا وازدهارًا.
وعلى غرار “المرغريف“، اتخذت المستشارة الألمانية في ذلك الوقت، “أنجيلا ميركل“، قراراً تاريخياً في عام 2015 بفتح الأبواب على مصراعيها لأولئك الذين جاءوا لطلب اللجوء، ومعظمهم من سوريا. ومثل مارغريف أيضاً – الذي كانت أراضيه لا تزال تعاني من فظائع حرب الثلاثين عاماً (1618-48) – لا بد أن ميركل قد أدركت أن الترحيب بهؤلاء الوافدين الجدد الشباب والمهرة يمكن أن يفيد بلد إقامتهم الجديد، مع تزايد شيخوخة السكان والحاجة المتزايدة إلى الرجال والنساء الأصحاء الذين يمكنهم العمل.

حتى يبدو أن التاريخ سيتذكرهم بنفس الطريقة. رأيت نافورة منحوتة في حديقة في إرلانجن تحيي ذكرى مآثر إرنست من خلال تصويره مع اللاجئين الذين رحب بهم. وبالمثل، بدأت الصور والجداريات التي تصور ميركل تظهر في سوريا بعد فترة وجيزة من قرارها التاريخي بالترحيب باللاجئين. أطلق عليها السوريون اسم “ماما ميركل” باللغة العربية، على غرار ما أطلق عليها الألمان اسم “موتي”، وكلاهما يعني الأم.
لقد ترك الهوغونوت واللاجئون السوريون على حد سواء وراءهم بلدانا يضطهد فيها رئيس دولة مطلق الناس دون أي اعتبار لحرية الضمير. لا بد أن كلاهما شعر بالسعادة لوجودهما في مكان أكثر أماناً لكنهما ما زالا يكافحان من أجل تسميته بالوطن. وصل كلاهما إلى بلد نفسه يتعامل مع تاريخه الحديث من إراقة الدماء والحرب. كانت حرب الثلاثين عاماً صراعاً وحشياً ومدمراً لدرجة أنه وفقاً لكتاب المؤرخ “بيتر ويلسون“، “مأساة أوروبا“: “كشفت استطلاعات الرأي العام التي أجريت في ستينيات القرن العشرين أن الألمان وضعوها على أنها أكبر كارثة لبلادهم قبل الحربين العالميتين، “الهولوكوست“، والموت الأسود “.
كانت رحلاتي في ألمانيا على وشك أن تظهر لي لمحة عن التجربتين الألمانية والسورية في أوجه التشابه والاختلاف بينهما، وكيف شكلتا الطرق التي ينظر بها اللاجئون والمجتمعات المضيفة إلى أنفسهم وإلى بعضهم بعضاً.
نزلت من القطار في محطة إرلانجن في آذار/ مارس 2021، وهي محطتي الأولى في زيارتي الأولى لألمانيا. لقد كنت حتى الآن أزور بشكل تقليدي أكبر وأبرز المدن في كل بلد أسافر إليه للمرة الأولى، لكن إرلانجن قدمت لي فرصة مغرية لإعادة التواصل مع الأصدقاء القدامى من سوريا، الذين لم أرهم منذ سنوات – وإقامة مجانية.

قد مرت سنوات منذ أن غادرت أنا ومعظم الأشخاص الذين أعرفهم سوريا، التي كانت مسرحاً لحرب وحشية منذ عام 2011. مثل مئات الآلاف من السوريين، قام أصدقائي في إرلانجن برحلة محفوفة بالمخاطر عبر بحر إيجه من تركيا إلى اليونان. عندما تقاسموا قارباً مطاطياً عبر المياه الغادرة التي قتلت آلافاً آخرين، كانت هذه هي المرة الأولى التي يغادرون فيها البلد الذي ولدوا فيه. وبينما كانوا يسيرون عبر البلقان في طريقهم إلى ألمانيا، طعن أحدهم من قبل حشد من الغوغاء الذين سرقوا ممتلكاته.
تجاربهم هي نموذج مصغر لتجارب السوريين الآخرين في ألمانيا، الذين يشكلون الآن ثالث أكبر مجتمع من الأجانب في البلاد. الابن الأكبر، البالغ من العمر 32 عاماً، بعد أن أنهى درجة الماجستير في جامعة محلية، يعمل الآن في شركة صناعية كبرى. في الآونة الأخيرة، حصل على الجنسية الألمانية. على الرغم من سعادته بشكل عام بما حققه، إلا أنه ينظر بشوق إلى الحياة الاجتماعية والدفء الذي اعتاد عليه في المنزل، والذي تمنعه عزلة هذه المدينة الصغيرة في جنوب ألمانيا. إنه يكافح مع مالك العقار البافاري النموذجي، الذي يجلس في المنزل طوال اليوم كما لو كان ينتظر أياً من مستأجريه لإحداث أدنى ضوضاء في المبنى من أجل توبيخهم. الصديق الآخر الذي لدي هناك، 29 عاماً، لم يكن يعرف شيئاً سوى حياة الراحة والترفيه والرومانسية. وهو يعمل الآن في متجر بيورو واحد ويكافح مع اليأس والوحدة والإدمان على ألعاب الفيديو، التي يشاركني فيها العديد من السوريين الآخرين الذين أعرفهم في ألمانيا.
- عندما كنت الشخص الوحيد الذي أعرفه الذي كان يتعلم اللغة الألمانية في المدرسة الثانوية، لم أكن لأصدق أنه بعد بضع سنوات، سيعيش أكثر من نصف مليون سوري في ألمانيا، مع بذل العديد من أولئك الذين تركوا وراءهم كل ما في وسعهم للسير على خطاهم. ثقافياً وتاريخياً، ليس هناك الكثير الذي يربط البلدين معاً. ارتبطت ألمانيا في أذهان السوريين بأمرين رئيسيين: الحرب العالمية الثانية والتقدم التكنولوجي والصناعي.
تعرفت على الثقافة الألمانية لأول مرة من خلال “كانتاتاس باخ وشوبرت“، والتي ما زلت أعتبرها أكثر من أي نوع آخر من الأغاني. كانت هناك أيضاً الترانيم التي غنيتها في الجوقات في حلب ودمشق، بما في ذلك تلك التي كتبها مارتن لوثر نفسه، مثل (“القلعة عظيمة هي إلهنا”)، مذكراً بموقفه الرائع ضد أقوى السلطات في ذلك الوقت: البابا والإمبراطور الروماني المقدس. وجدت اللغة الألمانية لغة جميلة وقضيت ثلاث سنوات في دراستها، والتهام أعمال غوته وشيلر وهاينه وغيرهم.
عندما قرأت عن التاريخ الأوروبي في العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث في مدرستي وفي مكتبة جدي في سوريا، كنت أتوق لاستكشاف هذا التاريخ مباشرة. لكن هذا لم يكن سهلاً. بدأت ثورة 2011 عندما أصبحت بالغاً، ثم تحولت إلى حرب حطمت، من بين أمور أخرى، آمال السوريين في الحصول على أي نوع من التأشيرة للسفر إلى الخارج. في عام 2015، كنت قد بدأت العمل كصحفي ولم أرغب في سلوك الطريق المحفوف بالمخاطر عبر البحر الذي سلكه العديد من أصدقائي وأقاربي. اخترت بدلاً من ذلك البقاء وتقديم تقارير عن الحرب. في عام 2017، عرض علي تدريب داخلي مع “سي إن إن” في برلين، ولكن عندما طلبت مني السفارة الألمانية في بيروت المجيء من سوريا إلى لبنان للحصول على موعد، أخبرتني أن طلب التأشيرة الخاص بي قد رفض. وبعد أقل من شهر، اضطررت إما إلى الفرار من البلاد على الفور أو مواجهة تداعيات خطيرة على عملي. ذهبت إلى السودان، ثم إلى لبنان، حيث اضطررت للعيش بشكل غير قانوني.
منحتني تأشيرة اللجوء الفرنسية الفرصة للاستقرار في بلد جديد، حيث أشعر الآن بالأمان والتمتع بحقوقي الكاملة. كان أسعد مكسب على الإطلاق حتى الآن هو القدرة على السفر بحرية، أولاً باستخدام وثيقة سفر اللاجئين والآن باستخدام جواز سفر فرنسي، وكلاهما سارعت إلى استخدامه في أقرب وقت ممكن، وأصبحت مسافراً بشهية لا تنقطع، ولم أقضِ أكثر من ثلاثة أو أربعة أسابيع متتالية في المنزل. بعد رحلاتي الأولى إلى اليونان وإيطاليا وهولندا، حان الوقت للذهاب إلى ألمانيا.
كنت أدرك بالفعل أن الألمان يترددون في الانغماس في الكثير من الفخر بماضي أمتهم، بالنظر إلى ما أدى إليه هذا في القرن الماضي. لكنني فوجئت برؤية كيف أن اهتمامي بتاريخ البلاد – حتى قبل توحيدها تحت حكم القيصر فيلهلم الأول وبسمارك في النصف الثاني من القرن 19، ناهيك عن الحربين العالميتين في القرن 20 – جعل كل شخص قابلته هناك تقريباً غير مرتاح. يبدو أن غالبية الألمان الذين تعاملت معهم يتفقون على أن بلادهم فقدت حقها في الاحتفال بثقافتها وتراثها. يبدو أن العديد من السوريين الذين كانوا هنا لسنوات قد تبنوا نفس المواقف تجاه النظر إلى الماضي. فقد نشأ هؤلاء السوريون، بعد كل شيء، في ظل نظام يشبه الاشتراكية القومية من نواح كثيرة. إنهم يعرفون جيداً كيف يمكن توظيف الفخر بالتاريخ في صياغة أفكار خطيرة حول القومية والسلطة.
عندما أكون في بلد ما، فإن كل ما أعرفه عنه يتدفق بحرية حول ذهني. أتلو الآيات، وأدندن الألحان، أكرر الأقوال لنفسي وأتطوع بمعلومات مملة يميناً وشمالاً. ولكن عندما بدأت شارد الذهن وأنا أصفّر الرباعية السلسلة لهايدن خلال رحلة قصيرة بالقطار من إرلانجن إلى نورمبرغ، تحول وجه رفيقي في السفر إلى اللون الأصفر. “لا يجب أن تفعل ذلك!”همست. كنت أعلم أنه كان على حق، لأنه تم استخدام اللحن للنشيد الوطني الألماني، وعلى الرغم من أن المقطع الأخير من كلمات الأغاني الأصلية لا يزال يغنى حتى اليوم، إلا أنه اشتهر بسطره الأول، الذي تم حظره منذ ذلك الحين بسبب ارتباطه بالنازية. لكنني واجهت اللحن لأول مرة لا في النشيد الوطني الألماني ولا في الرباعية الوترية لهايدن. كان ذلك في أغنية من التراتيل البالية التي يمكن للمرء أن يجدها في المقاعد الخشبية للكنائس البروتستانتية في الشرق الأوسط، والتي تسمى “الأغاني الروحية للكنائس الإنجيلية”، وهي مألوفة فقط لبضعة آلاف من السوريين الذين يترددون على كنائس الأقليات.

بمجرد وصولي إلى نورمبرغ-بالمناسبة أول مدينة تتبنى الإصلاح-تخطيت زيارة ما قد يكون الموقع الأكثر وضوحاً لزوار المدينة المعاصرين: المحكمة التي وقعت فيها محاكمات مجرمي الحرب النازيين بعد الحرب العالمية الثانية. بينما يبدو أن الجميع يعتقدون أنه، بصفتي سورياً وصحفياً، يجب أن تقتصر اهتماماتي بالكامل على التاريخ الجيوسياسي الحديث، أردت فقط رؤية المتحف الألماني، الذي يمتلك أكبر مجموعة من الفن الألماني في البلاد؛ منزل “ألبرخت دورر“، أحد أكثر فناني عصر النهضة الشمالية ذكاء؛ وقلعة القرون الوسطى التي تحتل مكانة مهمة في تاريخ الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
- في معظم المدن الألمانية الصغيرة التي انتهى بي الأمر بزيارتها، رأيت بشكل أساسي نوعين من الناس: الألمان المتقاعدون ينزلون من الحافلات ويخرجون من الحانات، غالباً بمساعدة عصا، وشباب سوريون يقدمون الطعام في المطاعم، ويسحبون الصناديق في المستودعات ويبيعون البقالة في المتاجر.
لم أكن متأكد تماماً من شعوري حيال اللقاءات العديدة مع السوريين الذين كنت أعرف أنهم ينتظرونني في ألمانيا. العدد الهائل من السوريين في ألمانيا يمكن أن يجعلني أشعر بأنني على حافة الهاوية. وغالباً ما يكون هذا هو الحال بالنسبة للسوريين في الخارج، لأن المرء لا يعرف أبداً من هو المتعاطف مع النظام السوري أو مع جماعات المعارضة المتطرفة، أو من يريد تصوير كل زميل سوري على أنه “أخ” على أساس الروابط الدينية أو الاجتماعية المفترضة. يعتقد العديد من السوريين المحافظين في الخارج أنه من واجبهم مراقبة الأعضاء الآخرين في الشتات للتأكد من أنهم لا يتأثرون في “العادات الغربية” المتمثلة في شرب الكحول وعدم مراعاة الشعائر الدينية أو التقاط أفكار غريبة حول الحرية الجنسية أو المساواة بين الجنسين.
من المؤكد، بينما كنت أتحدث العربية مع صديق سوري في نورمبرغ ذات يوم، سمعنا رجل سوري استقبلنا بالتحية الإسلامية التقليدية، “السلام عليكم”. أنا عموماً أمتنع عن إضفاء نكهة على لغتي بأي شعور بالانتماء الديني، ولم أستخدم هذه التحية أبداً. صديقي، أكثر دبلوماسية مني، أعطى الرد المناسب، “وا عليكم السلام”. نطقت بكلمة بسيطة “مرحبا”، حيث بدا متشككاً من واحد إلى آخر. “هل تعيش هنا؟” سأل. “لا”، أجبته وأخبرته أنني أعيش في باريس. “باريس! كم هو جميل»، أجاب. “دعني أرحب بك مرة أخرى، السلام عليك!” كرر، وأصررت بالرد عليه بـ: “مرحبا!” ثم نظر إلى صديقي وسأله: “هل صديقك مسيحي؟” لقد عشت في بلدان ذات أغلبية مسلمة لمدة 25 عاماً، ومع ذلك كانت هذه هي المرة الأولى التي أضع فيها في مثل هذا الموقف.
خلال فترة إقامتي في الشمال، مكثت مع صديق قديم آخر من سوريا. كانت قصته مختلفة عن قصة صديقي في بافاريا. في أحد أيام عام 2013، جاء لتناول العشاء في شقتي في مدينة دمشق القديمة وانتهى به الأمر عالقاً معي لمدة أسبوع كامل. وقد أدت الاشتباكات بالقرب من المكان الذي كان يعيش فيه إلى إغلاق الطرق، مما جعل العودة إلى المنزل محفوفة بالمخاطر البالغة. خلال ذلك الأسبوع، قتل أحد معارفنا المشتركين بقذيفة هاون على بعد ميل واحد من منزلي. لقد اهتز كلانا بشدة بسبب الحدث، وتقدم على الفور بطلب للحصول على تأشيرة ألمانية بعد قبوله في إحدى الجامعات هناك. في غضون عام، سافر.
جاء بعض السوريين إلى ألمانيا بطريقة مماثلة: على متن طائرة وبتأشيرة طالب، دون المخاطرة بحياتهم من خلال الثقة في المهربين، والإبحار في قوارب مطاطية وعبور الحدود سيراً على الأقدام. وتصور العديد منهم أن هذا من شأنه أن يجنبهم وصمة العار التي يواجهها طالبو اللجوء في كثير من الأحيان، ولكن سرعان ما ثبت خطأهم، لأن أولئك الذين لديهم ميول كراهية الأجانب نادراً ما يهتمون بهذه الاختلافات التقنية.
من أجل الحصول على تأشيرة طالب ألمانية، يتعين على المرء فتح “حساب مصرفي محظور” – أي حساب لا يمكن سحب الأموال منه إلا على أقساط شهرية صغيرة – وإيداع أكثر من 10000 يورو فيه. هذا لإثبات أنه يمكن للمرء أن يعتني بنفسه مالياً أثناء إقامته في ألمانيا. ومع ذلك، يأتي معظم طالبي اللجوء بأموال قليلة جداً، خاصة بعد دفع آلاف الدولارات للمهربين للوصول إلى ألمانيا. عليهم الاعتماد على “مكتب التوظيف” للحصول على بدل شهري حتى يجدوا وظيفة ويمكنهم إعالة أنفسهم. لاحظت أن أصدقائي في بافاريا، عندما كنا نتحدث باللغة العربية في مكان عام، كانوا يحرصون على عدم قول “مركز التوظيف” صراحة، لكنهم يقولون شيئا مثل، “لا يزال يأخذ المال من … أنت تعرف ماذا” ، لتجنب سماعه من قبل أي شخص قد يخمن أنهم ما زالوا يعتمدون على أموال الرعاية الاجتماعية.

في الواقع، لا يزال العديد ممن وصلوا في عام 2015 يعيشون على هذا البدل اليوم، مما يغذي الرواية اليمينية المتطرفة بأن اللاجئين هم المسؤولون عن الضغط على الإنفاق الاجتماعي. في حين أن القوى الأكثر كراهية للأجانب نادراً ما تهتم بما إذا كان شخص ما قد جاء كطالب أو طالب لجوء، فإن السوريين الذين حاولوا باستمرار شرح كيف أن “وضعهم مختلف” غالباً ما خلقوا توتراً بين السوريين أنفسهم. ألقى البعض باللوم على الآخرين لعدم اندماجهم بشكل جيد أو عدم العمل الجاد، بينما رأى آخرون أن السوريين الذين لديهم الوسائل للقدوم كطلاب ومفاتيح الاندماج الاجتماعي في ثقافة مختلفة تماماً يجهلون الامتيازات التي سمحت لهم بالحصول على مناصب أكثر فائدة في الجامعات وأماكن العمل الألمانية.
أثناء وجودي في بافاريا، لاحظت أن بعض السوريين الذين تحدثت إليهم أصبحوا “بافاريين مخلصين” لدرجة أنه لم يستطع المرء حتى إقناعهم برؤية أي دولة ألمانية أخرى على قدم المساواة مع المملكة السابقة والناخبين والدوقية. “هذه هي ألمانيا الحقيقية”، قالوا، مراراً وتكراراً. لكن خارج بافاريا، فوجئ الألمان والسوريون على حد سواء عندما قلت إن بافاريا هي الجزء المفضل لدي من البلاد. وقالوا إن البافاريين فخورون جداً وقوميون للغاية – وهو أمر محظور في ألمانيا – ويعتقدون أنهم أفضل من أي شخص آخر.
كتب غوته في “فاوست“، “كان هناك شيء رائع”. (“نحن معتادون على الناس الذين يحتقرون ما لا يفهمونه.”) كان هذا صحيحاً بالتأكيد بالنسبة للكثيرين الذين ترددوا في الترحيب بأذرع مفتوحة بالعديد من اللاجئين القادمين إلى بلادهم في عام 2015 وربما حتى في عام 1686. كما ينطبق على العديد من السوريين الذين قدموا إلى ألمانيا ورفضوا العديد من جوانبها، مفضلين أو شعروا بأنهم مجبرون على العيش مع أشخاص من نفس البلد أو المنطقة في مجتمعات موازية، تكاد تكون مستقلة تماماً عن السياق الألماني الأكبر.
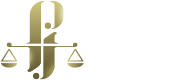
لا أستطيع أن أدعي، بعد بضعة أسابيع قضيتها في البلاد، أنني قادر على تشريح ما يعنيه أن تكون ألمانياً اليوم وكيف يمكن للبلاد أن تتعامل مع ماضيها دون رفضه تماماً. كما لا يمكنني أن أطمح إلى تلخيص مدى تغير حياة ما يقرب من 800000 سوري في ألمانيا على مدى السنوات الثماني الماضية. ولكن بعد أن أتيحت لي الفرصة الرائعة لإلقاء نظرة خاطفة على كليهما، يمكنني القول إنها سلطت الضوء على كيف تغيرت أنا أيضاً منذ مغادرتي سوريا، بعد أن اختبرت الحياة في لبنان وفرنسا، مع زيارات كل شهر إلى مدن مختلفة تعلمني المزيد عن الإنسانية وتاريخها.

 Eng
Eng