يبدو الانشقاق في سوريا، على سبيل التخصيص، كأنه تحوُّلٌ بطيء صائر وصاعد، نما في الذهنيّة السورية مذ بدأ مُلك الأسد الأب وحكمه الديكتاتوري، الاستبدادي، العسكري، الأمني، إلى أن "شقَّ" طريقه بوضوح وجلاء في الثورة على الأسد الابن ونظامه التي اندلعت في العام 2011.
06 / أيار / مايو / 2021

*مع العدالة | علا شيب الدين

نشرت فصول هذا الكتاب بموافقة الكاتبة
(2)
مفهوم الشارع
بما أن اللغة ليست مجرّد قواعد وكلمات، بل هي انعكاس للحضارة والثقافة، وللرّوح البشرية، وبما أن المفاهيم موضوعات للغة، وأدوات للفكر وتشكيل للعقل في آن واحد؛ فإن ثورات “الربيع العربي”، لم تضعضع الكثير ممّا في الواقع فحسب؛ بل خلخلت ربما بعضاً ممّا في الذهن أيضاً، وقدَّمت الدليل على وهم المفاهيم المحسومة، المطلقة، الصالحة لكلّ زمان ومكان، وسلطويتها.
قد يكون “الشارع” هو المفهوم الأهم الذي حرَّضت الثورات نفسها، العقل على ضرورة إعادة قراءته ومراجعته، في ضوئها، ما دام للمفهوم، أي مفهوم، دلالات زمانيّة ومكانيّة. فقد كشفت الثورات ما يثوي تحت ذاك المفهوم من مغالطات، إذ ارتبط مفهوم الشارع في أذهان الناس ردحاً طويلاً باللاأخلاق، إلى حدّ ما، وأُترِع بمعاني الرعاعيّة والعواميّة وازدراء الآداب العامة ومبادىء الحق والأخلاق، أو جرى تقليصه إلى مجرّد امتداد يرتاده اللصوص ومدمنو المخدرات والمتسوّلون والحثالة. لطالما كان الهاجس الأكبر للمربّين، آباء كانوا أو أمهات أو رجال دين، أساتذة أو ساسة، هو تحذير الناس، باعتبارهم “قاصرين”، من الشارع وثقافته. فما على الشخص إلا أن يخطئ أي خطأ، مهما كان في منتهى الهامشيّة والصغر، حتى يُشتَم ويُهان ويُعتبر “ابن شارع”. غير أنّ الثورات في العالم العربي، ولّدت مفهوماً جديداً للشارع المعتاد، فمن الشارع نفسه انطلقت صيحات مطالبة بأنبل القيم الإنسانية وأشدّها عمقاً، وعبره حصل الإصرار على إسقاط الشرّ الطاغي والفساد المستشري الذي طالما استفحل في البلاد العربية منذ عقود. ضجّ الشارع بالناس الثائرين على الظلم والقهر والتهميش والإقصاء، وعلى الاستبداد والديكتاتورية. إنّه الشارع في مفهومه الجديد إذاً، بوَّابة التغيير والانعتاق.
****
جاء في «لسان العرب» أنّ الشَّارِع: “هو الطريقُ الأَعظم الذي يَشْرَعُ فيه الناس عامّة، وهو على هذا المعنى ذُو شَرْعٍ من الخَلْق يَشْرَعُون فيه، وكلُّ دانٍ من شيء، فهو شارِعٌ، والدارُ الشارِعةُ التي قد دنت من الطريق وقَرُبَتْ من الناس”. وفي «الصِّحاح في اللغة» جاء الشَريعَةُ: “مَشْرَعَةُ الماءِ، وهو موردُ الشاربةِ”. قد تخطر على بالنا، أثناء التوغل في عمق المعاني تلك، تساؤلات من قبيل: لماذا لم يعلِّمنا أهلونا ومدرّسونا، وغير هؤلاء ممن تولّوا مهمّة تربيتنا، كيف نجيد مكابدتها وترجمتها سلوكاً وممارسة، فيما أمعنوا في ترهيبنا من الشارع ومن مغبّة الخروج إليه حتى، فكيف بالانتماء؟! لماذا أصرّوا على أنّ البيت مغلق النوافذ والأبواب أفضل، وأنّ القصْر أجمل وأعظم، وأنّ تنظير المدرسة أهم من تجربة الشارع؟! لماذا والشارع بكلّ ذلك الصّخب المهم، جرى تشويهه ونسف كل ما ينتمي إليه؟!. كان الشارع دوماً، بالنسبة إلى السلطة، هو الـ”خارج” في المعنى الذميم للكلمة، مقارَنة بـ “الداخل” (البيت)، ما أدى إلى ضمور فكرة الفضاء العام، كون الشارع مظهر من مظاهر الفضاء العام كالساحة والحديقة العامة، والدولة. هكذا استحوذت السلطة على الفضاء العام واحتكرته، من خلال ذمِّه بطريقة تُبعد الناس عنه وتقصيهم. انطلاقاً من الدلالات اللغوية المعجميَّة نفسها، يمكن القول: إن ثقافة السلطة قد طمَرَت المعاني الأصليَّة للشارع، كالشروع أو البدء أو المباشَرة والمبادَرة، والشريعة أو القانون والنظام والتشريع. لقد طمرت السلطة المعاني تلك، لكي تتمكَّن من قتل الروح الفردي المبادِر، الطامح، العازِم والتوَّاق، وكسر إرادة من شأنها الخروج على نَصِّها، أي نَص السلطة، وعلى موقفها من كل شيء، وبالتالي التبعيَّة التامة لها. ولكي تتمكَّن كذلك من إشاعة الالتباس والغموض والكذب الملازِم لـ أو اللازم عن التواري، والاختباء والاختفاء في “الداخل” (البيت)، عبر تهميش وذم “الخارج” (الشارع)، باعتباره وضوحاً وانكشافاً وجلاء.
حقاً إنّ الشارع قد ينطوي على ما ليس بمحمود، شأنه في ذلك شأن كلّ الأمكنة في كل الأزمنة. لكن الثورات كشفت عن جانب آخر له، كان غائباً عفواً أو مغيَّباً، قصداً وقسراً. استعرت الثورات لتعيد الاعتبار إلى شارع مهمَل منذ زمن بعيد، معلنة بدقة لماذا كانت السلطة، بأشكالها ومتاهاتها ودهاليزها كافة، لا تريد للشارع أن يحتلّ مكانة جيّدة في عقول من تربّيهم. لقد أدركنا، مع ثورات الشعوب في العالم العربي، لماذا كان الشارع يُقلِق الحكّام أكثر ما يُقلِق، ويرتعد أولئك خوفاً من أي صوت يتسلَّل منه. كان الشارع يرعبهم على الرغم من صمته المطبق، وكان خطراً أعظم يمسّ وجودهم “المقدَّس الأبدي”. عرفنا ذلك كله، وما قد نعرفه لاحقاً قد يكون أخطر.
****
ما عاد الشارع شارعاً. ما عادت المعاني الملصقة به هي ذاتها. لقد فُهم الآن، أي في زمن “الربيع العربي”، كواقع، أو كحدث اقترن بقيم الحق والخير والجمال والعدل والحرية. إنّه الشارع الذي منه تفتّحت ورود شباب ثائر على الظلم والتعسّف واستباحة الكرامة الإنسانية. الشارع “الآن” هو منبع حرية وانعتاق، شارع أحرار لا حثالة. صار له الكلمة الفصل في تغيير مسار التاريخ، وصار من شيم المرء الشريف الشجاع الانتماء إليه. انقلبت الأمور رأساً على عقب، ولم يعد قول: “ابن شارع” شتيمة، إلا في ذهن السلطة، كل سلطة، مثل أنظمة الحكم العربية التي طالما اعتبرت الهاتفين للحرية من الشارع “حثالة، جراثيم، جرذاناً، مندسِّين، مخرِّبين، متآمرين، خونة، عصابات مسلّحة، متمرّدين، تكفيريين، “قاعديين”، شُذّاذ آفاق وإرهابيين”.
****
اللافت للانتباه هو ذلك، الشعور بالرَّهبة أو بالقصور والتقصير أمام الشارع. شعورٌ دفع ببعض القوى السياسية التقليديّة المعارِضة، سواء كانت شخصيات مستقلّة أم أحزاباً، إلى “الانضمام”، في معنى ما، إلى الشارع المنتفِض الذي استحال معارَضة جديدة مختلفة، وبارعة في فاعليتها نظرياً وعملياً، وكذا الأمر بالنسبة إلى المثقف الحر. تفوَّق الشارع على المكتب مثلاً، فمَن يدافع عن الحرية عبر بحث أو مقال أو عبر مقابلة إعلاميّة، عقابه أقل وطأة ربما من عقاب ذاك الذي يهتف للحرية من قلب شارع، أدنى ما يُقال فيه إنه معمَّد بالرصاص الحيّ. حتى أنّ ثمة حذراً شديداً صار من الواجب أن يطغى على لغة من يريد الانضمام إلى الشارع أو إعلان تأييده، إذ ينبغي أن تكون لغة تكرِّس فكرة اللّحاق بالشارع، لا ادّعاء تمثيله أو الوصاية عليه. مردّ ذلك، على الأغلب، إلى القدرات العظيمة التي أبداها الشارع في التغيير، وإلى التضحيات النبيلة الشجاعة، والثمن الباهظ الذي قدّمه الثائرون من قلب الشارع، فكل ثائر إما صار شهيداً أو معتقلاً أو مفقوداً، وإما مشروعاً لذلك كله، في كل مرَّة يخرج فيها إلى الشارع متظاهراً ثائراً، خصوصاً في سوريا. أليس الشارع الثائر هو مَن أسقط الطغاة واحداً تلو الآخر؟! أليس الشارع نفسه مَن دفع طاغية تونس زين العابدين بن علي إلى الهروب، ووضع طاغية مصر محمد حسني مبارك في قفص الاتهام ممدّداً على سرير، بعد خلعهِ، وهو نفسه من دارت حرب طاحنة امتدت شهوراً بينه وبين طاغيته معمر القذافي، إلى أن لقي الأخير مصرعه، وهو من قاد طاغيته علي عبد الله صالح إلى حد الاحتراق ثم خلعه وإرغامه على مغادرة السلطة؟! وهو ما قد يحدَّد مصير حكّام آخرين في هذه المنطقة؟
صار للشارع كلمته وصوته ومفهومه، ما عادت حقوق الإنسان وقيم الحداثة والتنوير والديموقراطية تطلّ من أبراج عاجيّة هنا وهناك، لأنّ الوعي بات يدرك أنّ هذه هي مسار تاريخي يصنعه كلّ فرد يمضي فيه، وأنّها فعل شاق وإصرار على السَّير قدُماً، مهما كانت الطريق موحِشة وعرة. فالديموقراطية طريق، تجربة حية ومكابدة، تدريب للذات وتهذيب لها.
****
مفهوم الانشقاق
في موازاة القراءة السياسية لفعل الانشقاق، أي القراءة الآنيّة التي تأخذ في الاعتبار الغاية من الانشقاق أو نوايا المنشق وأسباب انشقاقه ودوافعه ومراميه ونتائجه؛ يبدو أن في الإمكان التأمّل في “الانشقاق” كمفهوم. يبدو أيضاً، أن في الإمكان الانتباه إلى أن تعبير” انشقاق” الذي من شأنه الانعتاق من النظام أو الانسلاخ عنه، فردياً أكان أم جماعياً أم شعبياً(ثورة)، أكثر انسجاماً ربما، مع ثورات “الربيع العربي”، من تعبير “انفصال” الذي قد يبدو إيقاعه، في المستوى اللغوي، أقلّ حدّة، على الرغم من أن كلتا الكلمتين تفيدان المعنى ذاته سياسياً. فوقْع كلمة انشقاق على الأذن المستمعة، ثم على الذهن، ربما يثير حماسة خاصة، ودافعاً إلى انفلاق حقيقيّ قد يكون ثاوياً مثلاً، تحت قافٍ تتوسط الكلمة وقاف تُنهيها، أو خلف سخطٍ ونزَق تشير الكلمة إليهما في مبناها، ومعناها الذي طالما تُرجم على الأرض.
يبدو الانشقاق في سوريا، على سبيل التخصيص، كأنه تحوُّلٌ بطيء صائر وصاعد، نما في الذهنيّة السورية مذ بدأ مُلك الأسد الأب وحكمه الديكتاتوري، الاستبدادي، العسكري، الأمني، إلى أن “شقَّ” طريقه بوضوح وجلاء في الثورة على الأسد الابن ونظامه التي اندلعت في العام 2011. يصبح الانشقاق هنا، بمثابة نضوج، وثمرة معرفة حقيقية، ومعاينة يومية شاقة لنظام أُريدَ الانشقاق منه وعنه. عبر فعل الانشقاق نفسه، تحرّكَ تاريخ السوريين الثائرين، كأنه أعلن بداية أو نهضة، وغدت المعرفة بالذات أكثر وضوحاً وحكمة وصدقاً.
من شأن الاستبداد الذي طالما ساد وتجذَّر، صبِّ التنوع والحيوية والخصوبة والكثرة والتعدد في قالب واحد، وتجفيف هذه كلها حتى تغدو في نهاية المطاف (كتلة) صلبة عصيّة على الحركة. ضمن هذه الكتلة غُيِّب الإنسان الفرد، وضاعت كل فاعلية حرة من شأنها العمل الذي يسهم في صناعة التاريخ، فأمسى الإنسان الفرد خارج التاريخ والزمن كحركة. وبما أن الاستبداد محكوم بالمطلق، بالأبدية والسديمية، حيث لا تغيير، لا تطور، لا صعود، لا هبوط، لا إيقاع، لا حركة، لا دينامية… كأنه العدم؛ فإن الانشقاق باعتباره فعلاً حركيّاً، خلخل السكون، هزّه رجّه رضّه وشلّعه، فحرّك التاريخ معلناً بدايته، وإذ يبدأ التاريخ، يبدأ القانون والتشريع والتنظيمات السياسية والمدنية، فالروح الفاعل الذي طالما كان مطموراً في لجّة العماء(الكتلة)، قد انبلج عبر الانشقاق، لينير، ويميِّز، ويشكّل. سوريا التي حُكِمت عقوداً طويلة من خلال ديكتاتور هو واحد أوليّ تجلّى في واحد ثانٍ، وثالث، ورابع…؛ إلى أن أمست “سورية الأسد”، بدت كأنها كانت في صيرورة شاقة اندلع منها أخيراً فعلٌ مختلف وخلاّق، فجّرَ الواحد. إنه الانشقاق إذاً، ذاك الفعل المختلف المتمرد على الواحد المتكتِّل، ومفتِّت الكتلة.
****
إن الخلخلة الكبرى الناجمة عن الانشقاق عن “النظام الكتلة”، من شأنها تفجير الإبداع أيضاً، أي الخلق المنبثق من التمايز والتناقض، إذ لا إنتاج من التماثل المطلق الذي يمهر نظام الاستبداد المتكتل. المراقب المـتأمل لطبيعة الوجود الإنساني قد يستشفّ أن جلّ الإنتاجات الإنسانية الأخلاقية والجمالية والعلمية، والحضارية عموماً، قد وُلدت من صميم الصراع والتناقض والاختلاف، ومن المواجهة بين الإرادات، والتطلّع إلى إثبات الوجود ومنحه معناه ومغزاه، في قبالة وجودٍ آخر أيضاً له معناه ومغزاه. إضافة إلى ذلك، فقد بيَّنت التجربة أن دولة الحق والقانون المأمولة لن تتجسد سوى بانتصار قوى النور والحرية على قوى الظلام والعبودية. ما النظام الأسدي إذاً، سوى كتلة لا متمايزة، لا متشكّلة، يلفّها السكون المطلق حيث الكل ممزوج في الكل في حلٍّ من العماء، وإذ يحدث الانشقاق عن الكتلة هذه، تزهر الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والروحية، وتدبّ الحياة في أوصال بشر لطالما كانوا طوال عقود كأنهم أصنام أو آلات لا تفكر، لا تعقل، لا تشعر، لا تريد، ويبدأ بعدئذ التمرّد على اختزالٍ حوّل الإنسان الفرد إلى مجرد كائن بيولوجي فاقد المعنى في الحياة.
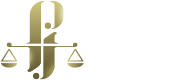
يطرق الانشقاق “النظام الكتلة” فيشظّيه؛ وينقل العقل من عالم المشابهات والتوافقات، إلى عالم التناقض والتعارض، عالم المخاطرة والمغامرة المتحرِّر من التدجين والتّسييس والتأطير. هكذا؛ يكون الانشقاق، في معنى ما، نزوحاً عن القديم المترهّل وما ينطوي عليه من أزمات عميقة ما عاد العيش في ظلها ممكناً. إنه نزوح تتفتّح منه ومعه قوى شبابية حيوية ذات فاعلية وحركة، قوى قد تثبت تفوّقها على أسلافها، كونها الجديد الذي لا تستطيع القوى القديمة المترهّلة أن تقضي عليه وتعيد الأمور إلى نصابها الكسول الخامل ذي السكون الكئيب القاتل. لقد “انشقّ” الشعب السوري، “شاقاً” لنفسه طريقاً. غدا الانشقاق بمثابة سيل جارف يواجه مستنقع نظام متكتل. وعليه، دخل الطرفان، أي الشعب الثائر المتحرك و”النظام الكتلة”، في صراع وجود، صراع إرادات متنافرة متخارجة. بدا الشعب مع هذا التخارج، توّاقاً إلى إخراج البلاد من حال السلب والعماء، بعد الإجهاز على”النظام الكتلة” عبر “شقّه”.
على أن أهمّ ما يعزّزه الانشقاق من الناحية الأخلاقية والقيمية، هو الاعتراف بالخطأ والرذيلة، توقاً إلى الصحيح والفضيلة، كونه دليلاً على حجم الانحطاط الأخلاقي الذي اعترى “النظام الكتلة”، وإذ يعلن المرء انشقاقه عنه، يعلن في الآن عينه، الثورة على ذاته أيضاً، مريداً بذلك تنظيفها، سعياً وراء تفتّحها من جديد على عالم آخر تزدهر فيه الأخلاق الضرورية لأن يحيا البشر في ظلها كبشر.


 Eng
Eng