لقد عاش السوريون العلويون أكثر من نصف قرن من حكم آل الأسد على هامش الحلم الوطني، محكومين بشبكة كثيفة من الأوهام والمخاوف التي صنعها النظام حولهم ومن أجلهم، وعلى أساسها استثمر دماءهم وحاول أن يحدد مصيرهم في معاركه المفتوحة من أجل البقاء.
25 / آذار / مارس / 2025

مع العدالة: مقالات وآراء
المصدر: “موقع درج” -وائل السواح

مرت أسابيع على المجزرة التي ارتكبتها قوات تابعة لتركيا في الساحل السوري. وقد تبدو مقالتي هذه – لذلك السبب – في غير مكانها، وكأنها تريد أن تنكأ جرحاً كاد يندمل. سوى أن الحقّ لم يندمل، ولن يفعل ما لم نواجهه بشجاعة ونعالجه بحكمة.
في لحظةٍ كان يفترض أن تكون بداية الخروج من نفق الاستبداد الطويل، انفجرت النار في الساحل السوري، وجرى الدم مجدداً، ولكن هذه المرة تحت راية السلطة الجديدة، لا النظام الذي سقط.
يمكن القول طبعاً إن المسؤولية تقع على عاتق النظام، ولن نكون مجانبين للصواب حين نقول ذلك، فأربع وخمسون سنة عجفاء، قاحلة، مليئة بالاضطهاد والفساد والتمييز لا بدّ أن تكون مسؤولة من جميع الجوانب: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأخلاقية. وبقايا النظام المدفوعة من إيران المهزومةِ سياسياً وعسكرياً في سوريا كانت بلا شك المسؤولة عن افتعال المجزرة.

مسؤولية النظام تعود أيضاً إلى محاولاته المستميتة تفريق السوريين طائفياً وتفريغ سوريا من الحس الوطني الجامع والإحساس بالمواطنة، الذي يعرف المواطنين بسوريتهم فقط وليس بأي انتماء آخر. وقد جهد الأسدان، ومعهم سدنتهما، لتخويف العلويين السوريين من الغالبية السنية، باعتبار هذه الغالبية كتلة صمّاء واحدة تتربص بالأقليات لتلتهمها فور سقوط الأسد.
لقد عاش السوريون العلويون أكثر من نصف قرن من حكم آل الأسد على هامش الحلم الوطني، محكومين بشبكة كثيفة من الأوهام والمخاوف التي صنعها النظام حولهم ومن أجلهم، وعلى أساسها استثمر دماءهم وحاول أن يحدد مصيرهم في معاركه المفتوحة من أجل البقاء.
ولعل المأساة العلوية، كما تجلت خلال سنوات الثورة السورية وما قبلها، ليست سوى صورة مكثفة لتاريخ طويل من التهميش، أعقبه استغلال سياسي ممنهج، انقلب فيه المُضطَهد بالأمس إلى أداة طيّعة في يد الطاغية، تُحرّكها العصبية والخوف من المجهول.
«مأساة العلوي السوري»
لم يكن عسيراً على حافظ الأسد أن يقرأ مشهد الريف السوري قراءة دقيقة. كان يعلم أن العلويين، مثل غيرهم من فئات الريف، قادمون من تاريخ قاسٍ من الفقر والحرمان، وأن شعورهم المزمن بالغبن، اجتماعياً واقتصادياً، يجعلهم هدفاً سهلاً لخطاب يتاجر بـ “إعادة حقوقهم” السليبة.
ولكنّ الأسد الأب، الذي انقلب على رفاقه العلويين وغيرهم في “الحركة التصحيحية،” لم يكن معنياً حقيقة بتنمية الريف أو رفع العلويين من قاع المجتمع، بل كان مشروعه أشبه بإعادة توزيع الفقر، بدل تحقيق الرفاهية. فبدلاً من تمكين العلويين اقتصادياً أو ثقافياً، أو بناء بنية تحتية حقيقية لمناطقهم، زجّ بأبنائهم في مؤسسات الجيش والأمن، وحوّلهم إلى أدوات في معركة السلطة، حتى باتوا لاحقاً العمود الفقري لأجهزة البطش التي بناها نظامه.
هذا الاندماج القسري في مؤسسات الدولة الأمنية لم يُخرج العلويين من فقرهم، بقدر ما حاصرهم في مربعات العشوائيات، ومكّنهم من قبض رواتب ضئيلة تضمن لهم البقاء على قيد الحياة، لا العيش الكريم. ومع اتساع دائرة الاستغلال، انتقل الريفي العلوي إلى هامش المدينة، لا إلى قلبها. كانت دمشق، على سبيل المثال، تضيق بالآتين من قراهم، فتدفعهم إلى أحياء مخالفة مثل حي “الـ 86،” حيث تكدّسوا في بيوت لا تمتّ إلى العمران بصلة، يسرقون الكهرباء والماء، ويتعايشون مع مؤسسات دولة لا يرون فيها إلا وسيلة لتمرير يومهم. لقد عاشوا على حافة المدينة، وعلى حافة الحلم، فلا هم أبناء الريف بعدما انقطعوا عنه، ولا هم أبناء المدينة التي لا تعرفهم إلا موظفين صغاراً، أو عسكريين يُرهبون الناس، فيكرهونهم.
تراكمت هذه المأساة الفردية لتصبح مأساة جماعية، حين وجد العلويون أنفسهم مأسورين في حلقة مغلقة: وظيفة في الأمن أو الجيش أو مبنى الإذاعة والتلفزيون وجريدة الثورة، أو في الجمارك والمصالح الحكومية الأخرى؛ وبيت مخالف في حي عشوائي، وثقافة متواضعة، ووعي هش بأن هذه الحياة “مكسب” لا ينبغي التفريط به. أما من جرّب الخروج عن هذه المعادلة، مثل المئات من رفاقي الذين شاركتهم الفراش واللقمة والحلم في سجون تدمر وصيدنايا وأقبية فرع التحقيق العسكري وفرع فلسطين، فسرعان ما كانوا يُحاصرون من مجتمعهم هم، قبل النظام، باعتبارهم خونة “يهدمون البيت على رؤوس أصحابه،” لأن الخوف قد أصبح العروة الوثقى التي تجمع الطائفة خلف النظام.
على أن الأسد لم يكتفِ بالاستغلال، بل ضخّ في عقولهم سردية الخطر السنّي، وغذّى فيهم هواجس الإبادة. ومع انطلاق الثورة السورية، وجد النظام فرصته الذهبية لتكريس هذه السردية: ها هم “الإرهابيون السنّة” يهددونكم، وها أنتم – من دون جيشـ “كم” – ستُذبحون، وتُطردون من بيوتكم، وتُفصلون من وظائفكم. وفي غياب خطاب معارض واقعي يقدّم بديلاً واضحاً يُطمئن الخائفين، كانت النتيجة أن اصطفّت الطائفة، أو غالبها، خلف النظام، ليس حباً فيه، بل خوفاً من مصير مجهول.
هكذا كرّس نظام الأسد معادلة مفزعة: أنت معي، إذاً أنت آمن. أنت ضدي، إذاً أنت عدو وستنتحر. هذه المعادلة خنقت كل صوت مختلف داخل الطائفة، حتى غدت الغالبية أسيرة خطاب الخوف، وأضحت المشاركة في القتل والدفاع عن النظام – ولو على حساب الأخلاق والوطن – “ضرورة وجودية”.
«تراجيديا العلويين»
لكن، على الجانب الآخر من هذه الحكاية، كان هناك واقع لا يرحم. أرقام الموت التي حصدت شباب الطائفة العلوية تُعدّ بعشرات الآلاف، لا فرق في ذلك بين من قاتل في الدفاع الوطني وذاك الذي كان يخدم في فرع أمني، كلاهما سيقا إلى جبهات النظام، يُقتلان ويُشيّعان في طقوس حزينة يغيب عنها الوعي الحقيقي بمسببات الكارثة. كل ذلك يمر، فيما تبقى القناعة السائدة أن “الفتنة” سبب البلاء، لا النظام.
وإذا تعمّقنا أكثر في السوسيولوجيا العلوية، نلاحظ أن بيوتهم وعقاراتهم في قراهم الأصلية قد تفتت في تقسيمات الورثة أو صودرت بذرائع شتى، وأن أراضيهم لا تُنتج ما يكفيهم، وأن المدينة لم تحتضنهم إلا كغرباء، فظلوا معلقين بين فردوس قريتهم المفقود ومدينة لا تنتمي إليهم. ومن هنا، تزداد حاجتهم الى الوهم، والى من يطمئنهم بأنهم “باقون،” ولو تحت السقف المنهار لنظام الأسد.
يذكّرنا هذا المصير، الذي لا يستطيع الفرد فيه الهرب من قدره، بالتراجيديا الإغريقية التي كانت تحكم على المرء بمصيره؛ حتى قبل ولادته. ولعلنا كيف حكمت النبوءة القاتلة حياة أوديب. العلويون في سوريا محكومون بقدرهم الذي رسمه لهم الأسد: التبعية والخوف، أو الموت. ولكن إلى متى؟ وأي مصير ينتظرهم حين يسقط النظام الذي لطالما ربط مصيرهم بمصيره؟
الواقع أن هذه المأساة لن تُكسر إلا إذا وُجد خطاب جديد – وطني، صادق، لا شعاراتي – يقدم للعلويين الأمان الحقيقي، لا وعدَ الإبادة. خطاب يدعوهم إلى عقد اجتماعي جديد، قائم على المساواة والكرامة والمواطنة، لا على الثأر أو المحاصصة أو العزل. غير أن هذا الخطاب مفقود اليوم. فالمعارضة أخفقت في مقاربة المسألة العلوية برؤية واعية، والنظام يواصل استثمار الطائفة حتى آخر قطرة دم.
العلويون ليسوا كتلة صمّاء، فمنهم المثقف والعسكري، القاتل والضحية، المؤيد والمعارض. ولكنهم جميعاً، بهذا القدر أو ذاك، أسرى سردية النظام التي خنقت أحلامهم وحاصرت وعيهم، وجعلتهم أدوات في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل. واللحظة التي يدرك فيها العلوي العادي أنه ليس محكوماً بخيارات الأسد، بل يملك الحق في خيار آخر – تلك اللحظة هي بداية الخلاص من المأساة التي امتدت أكثر مما يجب، وطالت أكثر من اللازم.

«في المتاجرة بفكرة العدالة الانتقاليّة»
على رغم خروج الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بخطاب تطرّق فيه إلى هذه الفظائع، إلا أنه لم يُسمِّ الجناة، ولم يُحدّد آليات محاسبتهم، ما أعاد إلى الأذهان جرائم سابقة، في حمص وغيرها، طُمست من دون محاكمة. هذا الغياب للمحاسبة يفتح الباب أمام شكل من أشكال العدالة التي تقوم على الثأر وليس العقوبة، ويغذّي الخوف الشعبي من تكرار ممارسات النظام السابق تحت غطاء جديد. وقد أدّت هذه الجرائم إلى تفكك مجتمعي واسع، وتنامي النزوح من الساحل، ويأس يتغذّى من فقدان الثقة في السلطة الجديدة وخياراتها، ومن هشاشة الأداء السياسي والإداري.
المشكلة ليست فقط في فظاعة ما حصل، بل في أن السلطة الناشئة لم تُحسن بناء مؤسسات دولة وطنية ومدنية، بل وُجهت إليها انتقادات متزايدة بأنها تُقصي شرائح واسعة من السوريين، وتُسيطر عليها عقلية سلفية تتجاهل مبادئ الشراكة والمواطنة. ويجري ذلك كله في بلد لا يزال مفتتاً بين شمال تسيطر عليها الفصائل التابعة لتركيا، وشمال شرقي يسيطر عليه الكرد، وجنوب شرقي يسيطر عليه الأميركان، وجنوب تحت سيطرة الميليشيات المحلية، وبادية لا تخلو من بقايا داعش. ولا يزال الجيش غير موحّد، ولم يُشرك الضباط المنشقين ذوي الخبرة في إعادة تشكيله، فيما بقيت فصائل عدة تحتفظ بسلاحها خارج مظلة الدولة، وارتكب بعضها جرائم موثقة، يُجرى الآن تضمينها في تقارير حقوقية.
في هذا المناخ، تنتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم فكرة العدالة الانتقالية، فيتحدث بها ممثلو الحكومة والمنظمات الحقوقية وأطراف المعارضة القديمة وكتاب الأعمدة ونجوم اليوتيوب. على أن هؤلاء جميعاً لا يتفقون على مضمون لهذه الفكرة. ويعتقد البعض أن العدالة الانتقالية هي تلك التي أحققها أنا نفسي ولنفسي فتقضي على عدوي الذي سبق أن أذاني.
والحال أن العدالة الانتقالية، بتعريف المركز الدولي للعدالة الانتقالية، هي استجابة المجتمعات لإرث الانتهاكات الجسيمة والصّارخة لحقوق الإنسان، وموضوعها الأساسي الضحايا، قبلَ أي اعتبارٍ آخر، فنراها تصبُّ جلّ تركيزها على حقوقهم وكرامتهم بصفتهم مواطنين وأشخاصاً على حدّ سواء، وهي تسعى إلى المُحاسبة على الأضرار الّتي تكبّدها هؤلاء وإلى انتزاع الإقرار بها وتحقيق الإنصاف في شأنها. وهي بذلك، إنّما تدلّ على الطّريق المؤديّة إلى إبرامِ عقدٍ اجتماعيّ جديدٍ يشملُ المواطنينَ جميعهم ويحفظُ حقوقَ كُلٍّ منهم.
هنالك خمسة أعمدة للعدالة الانتقالية، والمساءلة هي واحد من هذه الأعمدة: الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وتخليد الذكرى، والمصالحة المجتمعية لضمان عدم التكرار. ومن شأنِ هذه الاستجابات، أنُفِّذَت منفردة أم مجتمعة، أن تؤازر المجتمع في الانتقالِ من النّزاع إلى السّلام المُستدام، ومن الحكم الاستبدادي إلى الدّيمقراطيّة، ومن تكبّدِ إرث انتهاكات حقوق الإنسان الجماعيّة إلى احترام حقوق الإنسان، ومن ثقافة الإفلات من العقاب إلى ثقافة معاملة المواطنين معاملة كريمة.
كتب مالك داغستاني قبل أيام مقالاً بالغ الأهمية حذّر فيه من إعادة إنتاج ممارسات نظام الأسد الإجرامية تحت راية الثورة، ودعا إلى رفض أي تبرير لجرائم تُرتكب بحق المدنيين العلويين الأبرياء بعد سقوط النظام. وأكد داغستاني أن العدالة لا تتجزأ، وأن حماية سوريا الجديدة تبدأ من الاعتراف الصريح بالانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، من دون مواربة أو تبرير أو إنكار، لأن التغاضي عنها أو إنكارها يهدد بتقويض أسس الدولة المنشودة، ويمنح فلول النظام ومن يشبهونهم فرصة لإفساد المسار الانتقالي.
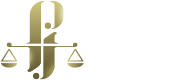
وأنهى مقالته الجميلة بما أتمنى لو أنني كنت أنا كاتبها: “يجب الخجل ووقف هذه المهزلة، وإلّا كيف سنقطع، مرة وإلى الأبد، مع نظام الأسد، وكانت واحدة من سماته إنكاره، بطرق غبية، جرائمه التي طاولت عموم البلد. يجب أن تتوقفوا فوراً، فليس باسم الثورة، ولا حتى باسم سوريا الجديدة، يمكنكم عقد تلك المقارنات السطحية بين ما تفعلونه اليوم وبين ما فعله إعلاميو الأسد ممن لم يمتلكوا ما يكفي من الضمير، ما جعلهم لا يرون القتلى من أهلكم! فهل تريدون أن تكونوا مثلهم بلا ضمير؟”

 Eng
Eng