إلى أيّ حدّ يمكننا إقناع المجتمع المحلّي (بفئاته المذكورة) بضرورة استعادة "حكم القانون"؟ وبالتالي تطبيقاً جديّاً للعدالة الانتقاليّة؟
24 / تموز / يوليو / 2018
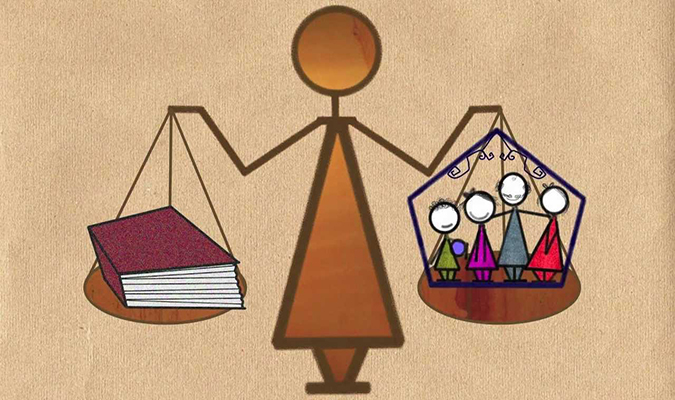
*بقلم: داريوس الدرويش
تعني العدالة الانتقالية في أحد التعريفات الأكثر انتشاراً أنها: مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات. بالنظر إلى الوضع السوري، نجد أنّ الدولة السوريّة تعاني فعلاً من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (القتل، الاغتصاب، الاختفاء القسري، مصادرة الممتلكات… الخ)، وأنّ معظم هذه الانتهاكات تحصل في أثناء فترة الانتقال من النظام الديكتاتوري الشمولي، إلى نظام يريده السوريّون أكثر حريّة.
وهذا ما يدعو للبحث عن آليات لتطبيق العدالة الانتقالية في سوريا. تعدّ المصالحة الوطنيّة من الأهداف الأساسيّة لتطبيق العدالة الانتقاليّة، فعبر آليات المحاسبة والتعويض (النفسي والمادي)، يتمّ التخلّص من الإرث الماضي من انتهاكات حقوق الإنسان، وعبر تطبيق معايير حاسمة وصارمة في احترام حقوق الإنسان عند بدء عمليّة تطهير وإصلاح مؤسسات الدولة (الأمنيّة بشكل خاص)، يمكننا تفادي حصول انتهاكات مستقبليّة لحقوق الإنسان تقود إلى مرحلة أخرى من عدم الاستقرار والنزاع الأهلي. عند الحديث عن تطبيق آليات العدالة الانتقالية في سوريا، تواجهنا عدّة معضلات جوهريّة، فكريّة وعمليّة، لعلّ أبرزها هو الوصول إلى فهم تفصيلي “للمجتمعات السوريّة”.
حيث أنّ هذه الآليات تبنى من الأسفل للأعلى، بأسلوب يقارب حياة المجتمعات المستهدفة، ويعالج مشاكلها الأساسيّة، التي تختلف من مجتمع إلى آخر باختلاف الموروثات الثقافيّة، والعادات الاجتماعية والأعراف. ولعلّ الاعتراف بتعدد البنى الاجتماعيّة في سوريا هو الخطوة الأولى نحو تطبيق سليم للعدالة الانتقالية. وما يستتبع من تعدد المجتمعات في سوريا هو تعدد أهمية أشكال الانتهاكات المرتكبة بحقه، أو، بتعبير أدق، اختلاف أهميّة هذه الانتهاكات بين منطقة وأخرى. فالوضع في محافظتي حمص والحسكة على سبيل المثال يتشابه من حيث الأهميّة القصوى لانتهاك حقوق الملكيّة (الاستملاك والمصادرة) أو حالات وضع اليد على الممتلكات الخاصّة للسكّان، حيث تفسّر هذه الإجراءات على أنّها محاولة من النظام الديكتاتوري بتغيير التركيبة السكانية لدوافع سياسيّة-فئويّة (طائفيّة أو قوميّة)، وبالتالي فإنّ هذا التغيير يستهدف الوجود القانوني والفيزيائي للضحايا على الأرض، كمجموعات بشريّة مختلفة عن “المستوطنين”، خاصّة في مناطق التماس بين المكوّنات السوريّة. بينما نلاحظ أنّ هذه الانتهاكات ليست بذات الأهميّة في مناطق أخرى، لا “تعاني” من وجودها على خط التماس. وكما يوجد اختلافات في “نوع الانتهاكات”، هناك اختلافات في تحديد “زمن الانتهاكات” الواجب الرجوع إليه بين المجتمعات السوريّة، فالمجازر في حماة وحلب التي حدثت في الثمانينات من القرن الماضي لم يتمّ نسيانها بعد، والإحصاء الاستثنائي للكرد في منطقة الجزيرة في الستينات ما تزال آثاره باقية حتّى الآن. فالفترة الزمنيّة التي ستشملها آليات العدالة الانتقالية تختلف من منطقة إلى أخرى، وما قد يناسب مجتمعاً ما، لن يناسب بالضرورة مجتمعاً آخر. إنّ التفصيل الدقيق لهذه الاختلافات لا بدّ أن يكون نابعاً من المجتمعات نفسها حتّى تكون “دقيقة” بحق؛ وهذا يتضمّن عملاً مشتركاً ضمن البنية الاجتماعيّة نفسها، يشمل القيادات المحليّة التقليديّة والحديثة، الضحايا وممثّليهم، وذوي الاختصاصات العلميّة المتعلّقة بهذه الانتهاكات (الحقوقيين، الأطباء، علماء ودارسوا علم النفس… الخ).
وهنا يكمن تحدٍ حقيقي: إلى أيّ حدّ يمكننا إقناع المجتمع المحلّي (بفئاته المذكورة) بضرورة استعادة “حكم القانون”؟ وبالتالي تطبيقاً جديّاً للعدالة الانتقاليّة؟ أعتقد أنّ الإرث الهائل من الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام بشكل مباشر، جعلت إمكانيّة إيمان الضحايا بقدرة أجهزة الدولة تحت سيطرة النظام الحالي على تحقيق العدالة شبه مستحيلة، فاستشراء الفساد والمحسوبية في الجسم القضائي منذ بدايات صعود النظام وحتى الآن، ومحاكمة قطاعات واسعة من المعارضين للنظام أمام محاكم تتّبع إجراءات مسيّسة، أفقدتا السلطة القضائيّة استقلاليتها، وبالتالي ثقة الشعب فيها، وبقدرتها على تحقيق العدالة إذا ما تمّ الاحتكام لهذا القضاء. كما أنّ عدم قدرة المعارضة حتى الآن على إنشاء بديل حقيقي للنظام في المناطق التي تسيطر عليها، بديل يؤمّن الأمن الأساسي للمواطنين، كالحماية من الجرائم، والحماية ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وبديل يؤمّن قضاءاً كفؤاً وغير مؤدلج، أدى في مجمله إلى تزايد الهوّة بين المجتمع وحكم القانون، وأضعف إمكانية تقبل المجتمع وتطبيقه لآليات العدالة الانتقالية، لا سيما بوجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تقوم بها بعض قوّات المعارضة، أو من المحسوبة عليها. بالنظر إلى هذه المشاكل، وغيرها الكثير، نجد أنّ البدء بتطبيق حقيقي وشامل لآليات العدالة الانتقاليّة في المرحلة الراهنة أمراً في غاية الصعوبة، إلا أنه يمكن اتخاذ خطوات فعالة تمهد الطريق لهذه الآليات للعمل مستقبلاً. فالعدالة الانتقالية تحوي، بالإضافة للإجراءات القضائيّة، إجراءات غير قضائيّة، والمقصود بها هو “التعويض، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات، تخليد الذكرى… الخ)”، وهناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به قبل الحصول على نتائج ملموسة على الأرض.
يعتبر التوثيق من المداخل الرئيسية لتطبيق آليات العدالة الانتقالية، القضائيّة وغير القضائيّة معاً، فيعمل التوثيق على تحديد من هم الضحايا، وما هي درجة تعرضهم للانتهاكات، كما أنّه يحدد في كثير من الأحيان الجناة أيضاً. لذلك فمن الضروري البدء من الآن بالتوثيق العلمي للانتهاكات، وحتّى مراجعة التوثيقات الماضية من أجل تدعيمها بالأدلة. ولكن، وبسبب وجود الكثير من الجهات التي تمتهن التوثيق، إما كجهات مستلمة للوثائق، أو جهات موثّقة تفتقد ربّما للمصداقيّة الاجتماعيّة، نجد أن الطريقة المثلى للتوثيق أن تتمّ عبر آليات نابعة من المجتمع، وتتقبّلها القوى الاجتماعيّة والسياسيّة الموجودة في المنطقة، لتحقيق غايتين رئيسيّتين:
الأولى: زيادة ثقة المجتمع المحلي بآليات التوثيق، وبالتالي توثيق انتهاكات أكثر عدداً وأشدّ خطورة.
الثانية: ضمان عدم ضياع الوثائق مادياً وقانونياً، أي حماية قيمتها القانونيّة من كافّة المشاكل التي يمكن أن تفقدها المصداقيّة أما المحاكم بكافة أشكالها، كالانقطاع في “سلسلة الحيازة”، أو بيع بالوثائق. إنّ البدء بالمشاركة الاجتماعيّة في بناء العدالة الانتقاليّة يمكن أن يتم عبر عدّة وسائل: مثل بناء لجان الحقيقة والمصالحة في المحافظات بمشاركة القوى المحليّة الفاعلة، كالمجالس المحليّة والقوى الثوريّة والسياسيّة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، أو رجال الدين والشخصيات الوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. وحتى لو لم توفي هذه اللجان بالأشكال القانونيّة الاعتياديّة لتشكيلها، إلا أنها ستكون عاملاً مساعداً في بناء استراتيجية وطنيّة للعدالة الانتقالية تنطلق من النظرة المحليّة لهذه الاستراتيجيّة، وتجمّع هذه الأجزاء المحليّة في حالة وطنيّة عامة. كما أنّ آفاق تطبيق العدالة الانتقاليّة يتعلّق بمدى تقبّل المجتمع السوري للمفاهيم المتعلّقة به بشكل أساسي.
فالعدالة الانتقاليّة بوصفها أساساً فكرة حديثة في العالم بشكل عام، وبالأخص في الشرق الأوسط، لا بدّ وأن تلاقي بعض المعارضة قبل تبنّيها من المجتمع، ولا بدّ من أن تشكّل حلاً حقيقيّاً للمشاكل التي تستهدفها في ذهنيّة المجتمع حتى يتقبل العمل بها. وللوصول إلى هذا الحد لا بدّ من دراستها بشكل جوهري ومعرفة مدى ملائمتها للحالة السوريّة، وكذلك العمل على نشر الوعي بالعدالة الانتقاليّة ضمن الفئات الاجتماعية الفاعلة. ولا بدّ من وجود قناعة لدى العاملين في هذا الشأن بأنّ العدالة الانتقاليّة ليست قالباً جاهزاً يتم تطبيقه على المجتمعات، إنما هي آلية تفاعليّة تنتج قوالبها الملائمة لكل بيئة تعمل فيها. ولا بدّ أيضاً للعاملين في مجال العدالة الانتقاليّة أن يساهموا في نشر مفاهيمها الحقيقيّة بالطرق المناسبة، والابتعاد عن العواطف السلبيّة أو الإيجابيّة تجاه حالة التغيير القائمة في سوريا. ولا بدّ أن يكونوا على اطلاع واسع بالعدالة الانتقالية وآلياتها، فمن الخطورة بمكان التصوير بأنّ “الملاحقة القضائيّة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر تحمّلاً للمسؤوليّة” على أنها “إفلات من العقاب للأقل تحمّلاً للمسؤوليّة”، رغم أنّ مبدأ “عدم الإفلات من العقاب” هو المبدأ الأساسي الذي تبنى عليه العدالة، وتؤيّدها مفاهيم العدالة الانتقاليّة بشدّة. إنّ العدالة الانتقاليّة، في حال المقاربة الصحيحة لها، تعتبر حلاً جديّاً يمكن العمل عليه حاليّاً في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ومستقبلاً في كافة أنحاء الدولة السوريّة، ومن الممكن أن تكون بديلاً للحل في الكثير من المشاكل التي لا يمكن للقضاء التدخّل فيها، كما أنّها تزيح أعباءً هائلة عن الدولة بمجال التعويضات، التوثيق، وإصلاح مؤسسات الدولة.
* المركز السوري للعدالة الانتقاليّة – مسعى
.
.

 Eng
Eng