لم تكن هناك تهمة جرمية، مجرد اشتباه في الخروج في تظاهرات سلمية يكفلها الدستور أصلاً، مع أنها لم تثبت على صاحبنا.
08 / تموز / يوليو / 2021

*مع العدالة | محمد برو
“قَالَ قَائِلٌ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ”
(10) سورة يوسف
من هنا أتى عنوان رواية “غيابات الجب” التي يحدثنا فيها بطل الرواية وكاتبها “د. جمال طحان” عن تجربته في الاعتقال، في سجون نظام الأسد، التي تحتل تصنيفا عالمياً متقدماً في قسوتها وبشاعتها، حتى صارت مضرب مثل في التغييب خلف الشمس، وأصبح الناجي من تلك السجون، أوفر حظاً وأشد إدهاشاً من ذي النون الناجي من بطن الحوت.
الملفت للنظر تلك الاستعارة، التي تحيلنا دون لبسٍ إلى ما فعله أخوة يوسف بأخيهم، وهو الإلقاء به في غيابة الجب بدل قتله، وكأنهم بهذا يستعيضون عن القتل الجسدي بالقتل المعنوي، الذي يغيب الضحية ويكفها عن الفعل، وهذا بالضبط ما يفعله النظام المستبد بمن يشتبه بمعارضتهم له.
لكن شتان بين هذا وذاك، فعالم غيابة الجب الذي يتحدث فيه الناجي عن سجون باتت شهرتها تطبق الآفاق، لهول ايغالها في التعذيب والقتل، والعبث القميء بأرواح الأبرياء المتهمين.
تمتد أحداث الرواية بدأً من عام 2011 عام بدء التظاهرات السلمية في سورية، والتي كانت شرارة الانطلاقة للثورة، وصولاً إلى عام 2015 حين يستقر بطل الرواية لاجئاً ومنفياً بفعل القهر في تركيا.
على مدى خمسمئة وثلاثين صفحة، تقودك الرواية في منعطفات الذاكرة التي ما تفتأ تنبثق من هنا أو هناك، وهي تتلوى تحت سياط الجلادين وروائح الدم والقيح، وأصوات المعذبين وشتائم الجناة.
هذه ذاكرة القهر الجمعية، التي يتشارك بها السوريون عامةً، والناجون من المعتقلات على وجه أعمق، تمتلك ذات المفردات والصور الرهيبة التي عاشوها جميعاً، منذ استيلاء نظام الأسد على السلطة عام 1970 وحتى يومنا هذا.

هي ذاكرة مشبعة بنمط متكرر وقذر من أقذع الشتائم والإهانات، التي اعتاد مسوخ النظام وجلادوه استخدامها مع ضحاياهم، وهم يتوارثونها كابراً عن كابر، ذاكرة مشبعة بأصوات المعذبين والسياط التي تنهال على الجلود فتمزقها، والملابس التي غرقت بالدم والقيح ومزقٍ من الجلد والشعر، الركلات والصفعات التي تنهال دونما سبب وكيفما اتفق، رائحة الشواء البشري، صراخ مستمر يعرفه المعذبون لا ينتج إلا عن الصعق بالكهرباء، التهديد المستمر بجلب الشقيقات او الأمهات أو الزوجات ليتركن فريسة مشاعة للجلادين، أجراس غرف التحقيق والتعذيب التي تجلب برنينها العذاب القاتل، العطش القاتل حين يلتصق اللسان بسقف الحلق وتعجز الضحية عن الصراخ، احتقان البول الطويل وعجز الكلى والمثانة على الاحتمال، الجوع الطويل حيث يصبح رغيف الخبز الجاف حاضراً في جميع الأحلام الليلية.
- لم تكن هناك تهمة جرمية، مجرد اشتباه في الخروج في تظاهرات سلمية يكفلها الدستور أصلاً، مع أنها لم تثبت على صاحبنا.
تقلبك الرواية في منعرجات الذكريات بين أزقة حلب القديمة الضيقة وروائح صابون الغار والجبنة التي لا تشبهها جبنة أخرى بين حجرات منزل الجد وحكاياته وصحبته لسبطه الأكبر، وبواكير المعرفة والذاكرة الأولى، سوق الهال وباب الأحمر وحمامها الشهير.
في الأسابيع الأولى لتجربة الاعتقال، تبقى الذاكرة البعيدة والقريبة تلِّح على السجين، وتبقيه متأرجحاً بين فضاء الخارج الرحب، وغيابات الجب، وشيئاً فشيئاً تبدأ تلك الذكريات بالخفوت والتنحي جانباً، ليهيمن السجن بظلامه وقسوته، فيستبيح كامل حياة السجين ووقته وحتى أحلامه، وهنا يدرك السجين أنه قد استحبس واستكان لقدره المفتوح على الشقاء الأبدي، استكانة “سيزيف” لقدره، لكن تبقى لعبة الفرار إلى الذاكرة مهارة يمتلكها السجين المقاوم، للهروب إلى حريته الذاتية، وهذا ما غزل حوله طويلاً الرئيس البوسني الأسبق “علي عزت بيكوفيتش” في كتابه “هروبي إلى الحرية”.

تنمو لدى السجين في عتمة الزنزانة، حواس شديدة الإرهاف، فهو يعرف من نبرة صوت السجين الجديد، إن كان خائفاً منكسراً أو صلباً مقاوماً، فها هو “السجين حازم يلفظ اسمه بكل ثقة وبثبات، لا تداخله خشية”.
بطلنا بالرغم من نيله درجة الدكتوراه، ونشره للكثير من الكتب والدراسات، وظهوره المتكرر كأستاذ متحدث عبر شاشات التلفزيون، ونشاطه الثقافي الذي يعرفه القاصي والداني، ونصاعة صفحته لدى الأجهزة الأمنية، التي لم تجد في تاريخه أي سلوكاً عنفياً أو عدائياً، إلا أن هذه الأجهزة لن تفرج عنه دون أن تغمسه بالوشاية بأصدقاء له لم يكن لهم من ذنب.
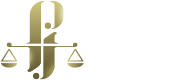
ليس بالإمكان الإحاطة بهكذا شهادة أو محاولة تلخيصها أو اختصارها، فكل تفصيلٍ فيها هو وثيقة على ما ارتكبه هذا النظام بحق الشعب السوري.
تجمع الرواية إضافة للقدر الهائل من تفاصيل أقبية التحقيق، ونوع الحياة المهينة التي يحياها السوريون في ظل هذا النظام، تجمع إليهما تفاصيل دقيقة وغنية من الحياة الحلبية وخصوصيتها ونكهتها وتوابلها المميزة.
هذه الشهادة الجديرة بالقراءة المتئدة، تقول في ظلالها إن كلَّ سوري يحمل ذاكرةً من الألم والمعاناة، متشابكة مع ذاكرة باقي السوريين، ومتفردة عنها بآنٍ معاً، ليصبح توثيق تلك الذاكرة مسؤولية جماعية كي تكتمل الصورة وتبلغ الإدانة مقصدها العادل، ولتخرج من تلك الغيابات حكاياتنا جميعاً، وليحفظها أبناؤنا وأحفادنا كي لا يحدث هذا مرةً أخرى.

 Eng
Eng