لا شيء أسهل في سجن صيدنايا من القتل أو الموت؛ بالإعدام الميداني الذي كان يطال عدداً يتراوح بين الخمسين والثلاثمائة، مرتين في الأسبوع، بحسب تقدير أحد الشهود، أو بالإعدام بطريقة غير مباشرة.
28 / تموز / يوليو / 2020

*المصدر: رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
مدخل
يقدم هذا الكتاب شهادات معتقلين سابقين في سجن صيدنايا أثناء الثورة السورية، ورواية شقيقة أحدهم عن الزيارة التي قامت بها العائلة إلى السجن لرؤية ابنها، وشهادة زوجة أحد المختفين قسرياً ممن بلغهم خبر غامض عن وجود رجلهم في صيدنايا الذي يعد صندوقاً أسود تقريباً.
يقدّم الشهادة الأولى سجين قديم من الإسلاميين، حُوِّل إلى صيدنايا في أيار 2011، بعد اندلاع الثورة بشهرين تقريباً، يوم كانت السلطة تنهي ملف السجناء السياسيين السابقين، ومعظمهم إسلاميون، وتبدأ بتحويل المتهمين بالانشقاق من العسكريين إلى هذا السجن. ومنذ ذلك الوقت المبكّر بدأت معالم التعامل الوحشي مع المعتقلين على ذمة قضايا الثورة، فقد كانوا يتعرضون للضرب المبرّح بالعصيّ الخشبية والمعدنية على أي مكان من أجسادهم بما فيها رؤوسهم. “لم يكن ذلك ضرباً، بل إعداماً عن طريق الضرب”؛ كما يقول الشاهد الذي يؤكد وقوع ضحايا في كل حفلة تعذيب كانت يد السجانين تُطلق فيها لمعاقبة ضابط من أي رتبة وإذلاله، طالما أنه هنا متهم بخيانة الوطن الذي “أكل من خيره”.
خلال أشهر سيفرّغ السجن من نزلائه القدامى الذين كانت الإدارة تتحاشى الصدام معهم على خلفية الاستعصاء الطويل الذي نفذوه في 2008، وسيمتلئ بسجناء الثورة من عسكريين ومدنيين سيزداد عددهم حتى الاكتظاظ المريع خلال السنوات اللاحقة.
اعتقل معظم العسكريين من قطعاتهم بناء على تقارير أمنية تتهمهم بالتخطيط للانشقاق بعد أن وضعتهم السلطات بسرعة في مواجهة المحتجين. إثر التحقيق معهم في فروع المخابرات العسكرية في المدن المختلفة، وأحياناً دون تحقيق، يحوّلون إلى الفروع المركزية لهذا الجهاز في دمشق؛ فرع شؤون الضباط (293)، فرع الأفراد (291)، فرع فلسطين (235)، فرع التحقيق (248) وغيرها. يقضي المعتقلون في هذه الأفرع مدداً متفاوتة يتعرضون فيها للتعذيب بوسائل متعددة أبرزها الدولاب والشبح، وهو تعليق السجين من الكلبشات التي بيديه ورجلاه تكادان تمسان الأرض، لساعات أو يوم أو أكثر. ينتهي التحقيق غالباً باعتراف المتهم بكل ما نسب إليه، وعندها يُحوّل إلى سجن صيدنايا الذي لم تكن سمعة وحشيته المجانية قد انتشرت بعد، مما قد يحمل السجين على الاعتقاد أنه تخلص من عذابه أخيراً.
يُسلَك المحوّلون في “جنزير” واحد، وهو أن تبقى إحدى حلقتي الكلبشة في معصم السجين والحلقة الثانية في الجنزير المعدني الذي يضم الجميع. يصعدون إلى وسيلة الانتقال المعتادة في حالات كهذه، وهي سيارة بصندوق معدني مغلق تدعى “سيارة اللحمة” لأنها تشبه سيارة نقل الذبائح من المسلخ. لا أحد يخبرهم شيئاً عن وجهتهم، فهم مجرّدون من أي حقوق. يقدّر بعضهم الطريق من طوله ومساره فيستنتجون أن الوجهة صيدنايا. وعندها يبدأ من يعرف شيئاً عن رهبة هذا السجن بقصّه على الآخرين الذين يسودهم الرعب وتلهج ألسنتهم بالدعاء المضطرب.
عند الوصول إلى باب المبنى الأحمر (المرسيدس)، وهو الرئيسي والأشد فظاعة من المبنى الأبيض، يُفتح باب الصندوق ويبدأ عناصر الشرطة العسكرية، المسؤولة عن هذا “السجن العسكري الأول” في البلاد، برميهم على الأرض بسرعة، وسط شتائم بالأعراض، وكأنهم عمال يرمون أكياس بصل من شاحنة. ستكون الكدمات التي تحصل نتيجة ذلك التدحرج أسهل ما سيواجهه السجناء الذين سيُقادون إلى بهو كبير حيث سيتلقون ما يسمى حفل “الاستقبال”، وهو جولة تعذيب بدئية قاسية يتعرض لها أي معتقلين منقولين إلى فرع جديد أو مركز احتجاز ضمن المنظومة الأمنية السورية. تزداد شدة “الاستقبال” كلما صعد المرء درجة في سلم أهمية الفرع، أما في صيدنايا فهو الأشد، إذ يروي أحد شهودنا أن خمسة عشر سجيناً قتلوا، من أصل مائة كانوا في “الجنزير” الذي قدم فيه، أثناء “استقبال” صيدنايا الذي يستمر عدة ساعات ويؤمر فيه المعتقلون بالتعري بشكل كامل والسجود ليتلقوا ضرباً مبرّحاً من قبل عدد من العناصر يتنقلون بين هذا الجسد الملقى على الأرض والغارق في دمه وذاك، مختلطاً بدماء قديمة متجمدة، تماماً كأنك تدخل إلى مسلخ.
أثناء ذلك يسلّم السجناء “أماناتهم”، وهي الأغراض الشخصية التي بحوزتهم من وثائق ونقود، وتُسجّل ذاتياتهم التي تتضمن معلوماتهم الشخصية وأضابيرهم، ويبدأون بالتعرف على نظام السجن عبر التعليمات: في الأفرع تُستَخدم “الطماشات” لتغطية العين ومنع المعتقل من رؤية أي من المحققين، أما هنا فالتطميش ذاتي، ويكون بأن يطمِّش المرء نفسه برفع كنزته من طرفها الأسفل في الخلف الذي يُقلَب ليغطي الرأس، وبعد ذلك يضع يديه على عينيه، لا من طرف الأصابع بل من راحة الكف، كي لا تكون هناك فرصة لأن يرى أحداً. ومن يفتح عينيه سيُعاقَب باقتلاعهما.

أثناء تسجيل المعلومات الشخصية يتعرّض السجناء لأنواع الإهانة والتمييز. يروي أحد شهودنا أنه كان يجب على السجين ذكر اسم أمه حين يسأله من يدوّن الذاتية عن “اسم الشرموطة؟”. كما يحكي عن الاستقبال “الخاص” للأطباء والمهندسين والمحامين والضباط والصحفيين، إذ يتعرضون لتعذيب متفنّن نتيجة ما يشعره السجانون من عقد؛ فهم طائفيون، مناطقيون، حاقدون طبقياً، غير متعلمين، صغار تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً، وتظهر آثار كل ذلك في تعاملهم مع السجناء من حملة الشهادات العلمية أو الموقع الاجتماعي المرموق أو الميسورين مادياً أو الأكبر سناً… حتى صاحب الجسد الرياضي كان يثير غيظهم فيسعون إلى “كسر رأسه”!
عند انتهاء “الاستقبال” يتعلم السجناء درس “القطار” الذي سينفذونه دوماً عند تنقلهم كمجموعات هنا. وهو أن يمسك كل منهم بيديه خصر من أمامه وينحني ويضع جبينه على مؤخرة هذا السجين، وبهذه الطريقة كان من المستحيل أن يرى أحداً.
بعد أن يسحب السجانون الجثث من حصيلة “الاستقبال” يصيحون: “واقفاً واقفاً… قطار قطار قطار”، ثم يوجّهون أول واحد في “القطار” فينزل درجاً إلى الزنزانات التي يودع فيها القادمون الجدد لمدة تتراوح بين أسبوعين وستة أشهر.
تختلف مساحة الزنازين، التي كانت في الأصل “منفردات”، لكنها على الدوام مكتظة بعدد غير معقول. يروي أحد شهودنا أنهم كانوا 28 شخصاً في زنزانة بطول لا يتجاوز أربعة أمتار وعرض ثلاثة، بما فيها حفرة المرحاض، ويروي آخر أنهم كانوا تسعة في ثانية مساحتها مترين في مترين.
لن يدخل السجناء الزنازين دون حفلة ضرب جديدة وتلقي التعليمات: هنا كل شيء بأمر… تأكل بأمر وتشرب بأمر وتنام بأمر وتستيقظ بأمر. أي تصرّف من عندك ستكون عقوبته شديدة. الكلام ممنوع والهمس ممنوع. عندما تسمعون حركة في الممر يجب أن تأخذوا فوراً الوضعية “جاثياً” داخل الزنزانة. أما عندما يُفتَح بابها فيجب أن يكون الجميع قد صاروا بهذه الوضعية داخل المرحاض، لا واقفين هناك. من اليوم فصاعداً أنتم “ولاد شرموطة”. وهنا يسأل كل زنزانة وكان على الموجودين فيها أن يجيبوا “نحن ولاد شرموطة”. لم يخرج هذا الجواب قوياً ومتحمساً كما اللازم من إحدى الزنزانات، فعوقبوا بشدة على ما رآه السجان تراخياً!
في اليوم التالي، وربما بعده بيوم أو اثنين، سيتلقى السجناء وجبتهم الأولى. يُجمِع من أخذنا شهادتهم أن النقص الفادح للطعام كان أقسى ما واجهوه في هذا السجن، أسوأ حتى من الضرب الذي ربما يؤدي إلى الموت بسهولة. إذ كثيراً ما كان متوسط حصة الواحد نصف زيتونة ومقدار ملعقتين من الرز ونصف رغيف خبز خلال الأربع وعشرين ساعة.
السجّان مطلق اليد، يستطيع إخراج من شاء من الزنزانة وتعذيبه لأي سبب، أو ليتسلى فقط، كما قد يأمر السجناء بمد أياديهم أو رؤوسهم أو أرجلهم من الطاقة الموجودة أسفل الباب “الشرّاقة” ويضربهم عليها أو يهرسها ببوطه، وقد يعاقب زنزانة بإغراق أرضيتها بالماء في جو صيدنايا الشهير ببرودته. قد يستمر ذلك لأيام، وربما يكون السجناء عراة تماماً. ولا تُرفع هذه العقوبة، في الغالب، إلا بعد وفاة واحد من نزلائها.
بعد قضاء مدة الزنازين، التي يدخل في تحديدها مزاج السجانين وتقديرات غامضة من الإدارة، يُقاد المعتقلون إلى الأعلى ويودعون في المهاجع التي يُفترض أن الحياة فيها أقل سوءاً لكن هذا ليس قاعدة.
مهاجع المبنى الأحمر في صيدنايا ذات مقاسات موحدة، بطول سبعة أمتار وعرض خمسة، وفي زاويتها حمام. بلغ متوسط عدد نزلاء المهجع أثناء الثورة حوالي 35 سجيناً. لا شيء في المهجع سوى بطانيتين أو ثلاثاً لكل سجين. يتلقى الصاعدون من الزنازين التعليمات مجدداً: “بتقعدوا هون وأكلكن بيوصل لعندكن. صوت ما في وهمس ما في”. ثم يتعلمون الوضعية التي يجب أن يتخذوها بسرعة عند دخول السجانين أو فتح الطاقة “الشرّاقة” التي في الباب؛ وهي الوضعية “جاثياً” على ركبهم، أي بين الوقوف والجلوس، وجوههم إلى الجدار المقابل للباب وأيديهم خلف ظهورهم أو تغطي أعينهم، وبصفوف متتالية حسب عددهم.
يجري اختيار رئيس للمهجع من بين النزلاء، كيفياً أو حسب رغبته، وهو سيكون الصلة بين السجناء والسجانين. “رئيس المهجع شخص ميت” كما أخبرنا عدد من الشهود، لأنه دوماً أمام احتمال تلقي الضرب المبرّح لأوهى حجة أو حتى دون سبب. فكثيراً ما كان السجان يدخل إلى الجناح ويصيح من باب الممر: “عرصات المهاجع” أو “خنازير المهاجع”… “الكل يشلح بالشورت” ويضربهم ويخرج.
كانت أمور السرعة والتعداد شديدة الأهمية للسجانين، ودائماً تحت طائلة الضرب المؤذي. عندما يُحضرون الطعام كان السجان يعدّ حتى ثلاثة، وخلال ذلك على الشاويش أن يُخرج “القصعات” الفارغة من الوجبة السابقة ويُدخل الجديدة. بعد أن ينهي السجان العدّ سيغلق الباب الموارب على كل حال، سواء أغلق بشكل طبيعي أم أثناء حركة الشاويش الذي قد يُكسر أحد أعضائه بهذه الحركة وقد يموت فوراً. ولذلك لم يكن يتطوع للقيام بهذه المهمة إلا “فدائي” من المعتقلين على ذمة الثورة، أو “شّبيح” لم يعرف أن هذه الوظيفة هنا لا تمنح الحظوة والتنمر كما في الأفرع.
من النموذج الأول يُذكر الملازم أول رنس المصلح، وقد تبرّع أن يكون رئيس مهجع بدلاً عن شخص مريض اختاره السجان عشوائياً. وتلقى التعذيب والضرب دون أن يبلّغ عما يريده السجانون من أسماء “المعاقبين” مخالفي الأنظمة في الجناح.
ومن النموذج الثاني يذكر شاهد آخر مطرباً شعبياً اسمه شادي سعيد، كان قد أعرب عن ولائه منذ الزنزانة بموال يحيّي فيه بشار الأسد. وعند الصعود إلى المهاجع روى للمعتقلين قصة اعتقاله بسبب تورطه في استدراج مساعد في المخابرات لصالح إحدى مجموعات الجيش الحر، بعد أن أغرته بمبلغ كبير.
يدخل السجانون ليضربوا السجناء متى رغبوا. “في بعض الأيام كانوا يدخلون أربع مرات لضربنا” كما يقول أحد الشهود، فيما تحدث آخرون عن جولة تعذيب كل يومين أو ثلاثة. يستخدمون كل الوسائل المتاحة بين أيديهم: “قشاط الدبابة”، وهو السير الجلدي الذي يلتف على محرّك الدبابة، وهو يسلخ الجلد كلياً؛ وكبل التمديدات الكهربائية النحاسية المجدول مرتين والمعروف باسم “الكبل” الرباعي”؛ وأنبوب التمديدات الصحية الأخضر الذي يسمّونه “الأخضر الإبراهيمي”، في سخرية من أحد المبعوثين الدوليين لحل القضية السورية؛ و”الهروانة” التي هي أنبوب مصمت من السيليكون المضغوط الذي يستعمل للحم البلاستيك في الأصل، وهي لا تجرح ولا تكسر عظماً، لكنها إما أن تميت الشخص مباشرة أو تسبب له ألماً غير عادي؛ وبورية الحديد التي كان السجانون يطلقون عليها اسم “أم كامل”، وكانت قاتلة بضربتين أو ثلاثاً؛ والعصا الكهربائية؛ والدعس بالبوط العسكري.
فضلاً عن الضرب المزاجي والعقوبات العشوائية كان السجناء يتعرضون لما يسمّى في صيدنايا “دولاب السجن”، وهو جولة تعذيب ليلية شاملة تبدأ من أول مهجع في الطابق الأول وحتى آخر مهجع في الطابق الثالث. عن هذا الدولاب قال الشهود إنه لم يمض دون أن يخلّف جثة واحدة في كل مهجع على الأقل، ورغم ذلك كان السجناء المصطفون بالوضعية جاثياً يستعجلون وصول جوقة التعذيب إليهم ليتخلصوا من الرعب الذي يصيبهم من سماع الأصوات التي تشبه صياح أشباح وسط مدينة خاوية على حد وصف أحدهم.
تختلف منهجية التعذيب في صيدنايا عما يجري في أفرع المخابرات. فهناك يهدف التعذيب، في الغالب، إلى الحصول على المعلومات، وقد يحدث أحياناً بقصد الإذلال والتشفي، أما هنا فلا يهدف التعذيب إلى غير ذاته. “صيدنايا مكان خُصِّص لمعاقبة الثورة السورية”، كما عبّر شاهد آخر قال إن الفارق الثاني هو أن المحقق في الأفرع يستمر في الضرب حتى يحصل على ما يريد من معلومات أو اعترافات، أما إن كان الضرب عقوبة فإنه يستمر حتى يصرخ السجين الذي يُعدّ امتناعه عن ذلك تحدياً. أما في صيدنايا فعلى العكس، يُفترض أن تتلقى الضرب وأنت صامت، وكلما صرخت زادت عقوبتك.
في وقت ما يؤخذ السجين إلى مقر الشرطة العسكرية بحيّ القابون ليُعرض على “المحكمة الميدانية” في جلسة لا تتجاوز دقيقتين أو ثلاثاً يسأل القاضي فيها المتهم عما نُسب إليه ثم يطرده ويصدر الحكم الذي يبقى مجهولاً بالنسبة للسجين الذي لا يناله من هذه “المهمة”، كما تسمّى لدى السجانين، سوى الضرب ذهاباً وإياباً وقضاء ليلة سيئة في سجن الشرطة العسكرية الذي يتكوم فيه الموقوفون فوق بعضهم ويتناقلون الجرب والقمل ليعودوا بهما إلى مهجعهم ويصيبوا الآخرين فيه بالعدوى إن لم تكن قد تفشت من قبل.
من الناحية النظرية، يحق للسجين تلقي الزيارات بعد عرضه على المحكمة، بعد أن يكون قد قضى المدة السابقة في عداد المخفيين قسرياً. أما عملياً فكان بعض الأهالي يستطيعون “تأمين” زيارة خاصة بدفع رشاوى أو بالاستعانة ببعض ذوي النفوذ. وحتى الحصول على الموافقة على الزيارة العادية، كل ثلاثة أو أربعة أشهر، لم يكن يمر دون تعقيدات ومتابعات طويلة ودفع نقود.

يُخصَّص للزيارات يومان في الأسبوع، وتجري الأمور فيهما على شكل كرر سجناء متعددون وصفه. في الصباح يذيع السجانون أسماء من وردتهم زيارة فيستعد السجين للخروج من المهجع. يضربونه حتى يسيل منه الدم، وسط عبارات من نوع: “امشي يا ابن الكذا… يا ابن الكذا… بدك تاخد الرضا من تبع أمك؟! جاية مرتك تزورك؟ بتكون امبارحة كانت نايمة مع أخوك”. يجرّونه إلى غرفة كبيرة بطول 15 متراً وعرض 10 أمتار، يُجمع فيها من وردت أسماؤهم للزيارة من كافة الأجنحة. في الغرفة حلاق يمسك بماكينة لإزالة شعور المعتقلين وضربهم. يخرج السجين إلى الزيارة برفقة سجان واحد على الأقل. يقف بمواجهة شبك بينما يقف أهله وراء شبك آخر ومعهم عسكري آخر، وبين الشبكين يسير رقيب ليستمع إلى الحديث. قبل الزيارة يجري تنبيه السجناء إلى الكلام المسموح، وهو: “كيفكم؟ كيف صحتكم؟ أنا بخير. أموري تمام” وأشياء من هذا القبيل. يمنع أن يذكر أسماء لئلا تحمل رسائل! فيمنع مثلاً أن يقول: كيف حال أخي محمد؟! عليه أن يسأل بالمجمل: كيف إخوتي؟ كيف عماتي؟ كيف أخوالي؟
يعامل السجانون المعتقل أمام ذويه برفق محدود، ويكونون قد حذروه من أي مخالفة قبلاً: “مرجوعك لعندي وحسابك بعدين” في أفضل الأحوال، أما غالباً فكانوا يقولون: “ليكها أمك برّة… بعمل فيها كذا وكذا عالشبك”. يحصل هذا الحساب سواء خالف السجين التعليمات أم فعل ذلك أحد من ذويه بكلمة نزقة.
أما إن مرت الأمور بسلام، خلال الدقائق الثلاث المخصصة للزيارة، فإن السجان يخرج به، وبينما يودّعه أهله بأنظارهم يهمس في أذنه: “شد ظهرك… اعتز بنفسك”، وبمجرد أن يتجاوز المسافة الفاصلة يشوطه بقدمه فيقذفه أمتاراً إلى الأمام، عليه بعدها أن يخر ساجداً وينتظر كيس الملابس الذي أحضره الزائرون إذ سيُرمى على رأسه. ثم يأمره السجان: “واقفاً”، وهنا عليه أن ينهض ويفهم أن المقصود “راكعاً” طالما أنه عاد إلى حياته “الطبيعية”. في الغالب يحضر الأهالي كمية كبيرة من الملابس، وفي الغالب يصل منها إلى السجين أقل القليل، وخاصة ملابسه المستعملة من قبل، أما الثياب الجديد فيسرقها السجانون في أكثر الأحيان.
مرات كثيرة لا يتعرّف الأهل على ابنهم إلا بعد أن يناديه السجانون، بسبب التراجع المريع في وزنه وصحته وما تعرض له من تعذيب، وقد لا يتعرّف الرجل على أطفاله الصغار بسبب نموهم.
ورغم فرحته بلقاء أهله كان الكثير من سجناء صيدنايا يتبادلون التهاني إن لم يُذَع اسمهم يوم الزيارة، ويوصون من يأملون بخروجه أن يبلغ الأهل أن لا يكرروها لما يصاحبها من إهانات وتعذيب كثيراً ما كانت نتيجته الموت، كما في حالة القاضي نايف فيصل الرفاعي الذي قتل عقب تلقي زيارة من زوجته.
كان القاضي عسكرياً برتبة نقيب، اعتقل في آذار 2012 بعد استدعائه إلى أحد الفروع الأمنية للتحقيق معه في ما نسب إليه من التعاون مع الثوار وتسريب وثائق سرية عن أحكام بالإعدام أصدرها القاضي محمد كنجو حسن، رئيس المحكمة الميدانية. في السجن تعرض الرفاعي لتعذيب مضاعف وضرب بأشد الأدوات فتكاً. أمره السجانون بالتعري بشكل مستمر وكانوا يصبون عليه الماء البارد. تعمدوا إذلاله بشكل يومي. وعندما عاد من الزيارة الأخيرة ضربه مجند يدعى عيسى محمد، يقول السجناء إنه وحده قتل المئات منهم، ببورية معدنية على بطنه أدت إلى نزيف داخلي أودى بحياته في نيسان 2014. وحين بدأت عائلته بتجهيز مراسم العزاء منعوها.
يعود السجين إلى المهجع محاولاً تأويل كل كلمة سمعها من ذويه بشكل يفيد الخروج من السجن وسقوط النظام. فقد كان المعتقلون معزولين عن العالم الخارجي تماماً، وكانوا يستغلون الزيارة نفسها، واختلاط نزلاء المهاجع المختلفة في غرفة الانتظار لساعات، لتلمس أي خبر عن الخارج أو عن أحوال السجن نفسه.
كانت تتاح فرص نادرة لتهريب رسائل صغيرة جداً ضمن الملابس، إن لم تقع في يد السجانين أو يختلسوا هذه القطعة، لكن الأهالي في الخارج لم يكونوا يملكون من المعلومات واليقين ما يقولونه للسجناء.
في بعض الحالات كان المعتقلون يستنتجون شيئاً مما يجري ميدانياً في الخارج من ردة فعل السجانين وتوترهم وافتعالهم أي سبب لإنزال العقوبات. فإن صوحب ذلك بانقطاع الكهرباء أو الماء عنى ذلك أن المعارك اقتربت من السجن، وربما يسقط في يد قوات الثورة فيتحرر السجناء الذين كانوا، في تلك الأوقات، يتلقون الضرب المضاعف بينما يخالجهم الشعور بالانتصار.
يروي شاهد أن المعاملة اختلفت تماماً قبيل مؤتمر جنيف2، في كانون الثاني 2014، تراجع الضرب حتى انعدم تقريباً، شُغّلت التدفئة ومرّ مدير السجن في جولة، وبعدها مرّ الطبيب على كل المهاجع ليقدّر درجة تفشي الجرب، ووزع السجانون الدواء. استمر الوضع هكذا حتى فشلت المحادثات فعادت الأمور أسوأ من ذي قبل.
في أيار 2013 تمكنت إحدى فصائل الجيش الحر من اغتيال مدير السجن، العميد طلعت محفوض، مما كان له انعكاس على السجناء الذين أخذ وضعهم يتدهور. يروي الشهود أن الكارثة الحقيقية بدأت في هذا العام والسنوات التي تلته، إذ زاد التعذيب وتكررت العقوبات وصارت الدماء على الجدران وبدأت التصفيات وانتشرت الأمراض وصار الناس يموتون بعد أن تراجعت مناعة أجسادهم وصارت المياه تنقطع، أحياناً لسبعة أو ثمانية أيام متوالية، وبدأ الطعام يقل، وصار السجانون يسكبونه على السجناء أو يفرغونه على بلاط المهجع ويدوسونه، وأحياناً يرمونه في المرحاض، وصار طبيعياً أن يفتح السجان باب الجناح صباحاً ويسأل: “مين عنده فطيسة ولا؟” فيرد رؤساء المهاجع: “واحد… اثنان”.
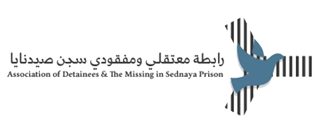
صاروا يحرمون بعض المهاجع من الطعام كنوع من العقوبة أو كيفياً أو ليوفروا على أنفسهم عناء التوزيع. وربما أعطوا كل حصة الجناح، المكون من تسعة مهاجع، لمهجع واحد وحرموا الآخرين. على كل حال كان الطعام المخصص للجناح يكفي مهجعاً واحداً، وكانت حصة الفرد من وجبات اليوم كله لا تشبع طفلاً صغيراً.
كان الحرمان من الطعام أمراً سهلاً ولأوهى الأسباب. عندما يحرمون مهجعاً من الطعام كانوا يحضرون حصته في الجاطات، يضعونها على بابه دون أن يعرف نزلاؤه إن كانوا سيدخلونها اليوم أم سيحملونها ويعطونها للمهاجع الأخرى. وهكذا كانوا يسمعون حصتهم تستقر وراء الباب لبرهة، ثم يشعرون أن الآخرين يأكلونها.
يقول أحد الشهود: “بعد مدة من وجودنا نسينا العالم الخارجي، نسينا أهالينا، نسينا لماذا نحن هنا، بل وتأقلمنا مع الضرب. صار الأمر الوحيد الذي يشغل بالنا هو متى سيأتي الطعام”.
صار السجناء شديدي النحافة، خدودهم غائرة وقفصهم الصدري بارزاً، لا يتجاوز وزن أسمنهم 50 كغ. وتحول كثير منهم إلى ما يشبه الذئاب التي يحاول أحدها الاستيلاء على حصة سواه كي يبقى على قيد الحياة، فقد تمضي أربعة أو خمسة أيام دون أن يحضروا شيئاً، ثم تصل وجبة تكون حصة الواحد منها ربع رغيف أو نصفه. اعتادوا تناول أوراق البرتقال وقشر البيض وعجو الزيتون ولم يعد ينتج عن الوجبة أي فضلات.
صار عدد الذين يموتون من الجوع أكبر من عدد من يقضون تحت الضرب. واندلعت الخلافات حول أدنى تفصيل من حصة الطعام. يروي شاهد من مهجع العزل الخاص بمرض السل أن اثنين من السجناء اختلفا على اختيار بيضة بناء على لون قشرتها، الأبيض أو الأحمر، وعلا صوتاهما فسمعهما السجانون وقرروا معاقبة المهجع وتوفقوا عن تقديم الطعام له خمسة أيام توفي خلالها البعض ومنهم أحد طرفي النزاع نفسه.
كان السجانون يحددون طريقة التعامل مع السائل الذي يأتي مع الوجبة، كالشاي والشوربة، حسب سخونته، فإن كان بارداً سكبوه على الأرض ليصنع السجناء من أياديهم ما يشبه المغرفة التي يجمعون فيها ما يستطيعون منه ويشربونه مع ما اختلط به من شعر وقاذورات، وأحياناً لا يصبرون فيضعون أفواههم على الأرض ويشفطونه. وإن كان السائل حاراً يدلقونه على رؤوس السجناء وهم في الوضعية جاثياً، فكانت بقايا أوراق الشاي تلتصق برأس من هو أمامك أو بكتف الذي بجانبك، ومن هناك كان عليك أن تأكلها.
تحول الطعام إلى حلم يراود السجناء في ليلهم ويتغزلون به في نهاراتهم، فصاروا يتجمعون، ثلاثة أو أربعة، فيتهامسون بطريقة طبخ الرز، أو البامية، أو الشاكرية، وأحياناً الحلويات، ويتلمظونها، وفي الليل يقسم بعضهم أنه أحس بطعمتها في فمه! صار السجناء من الساحل يحدثون أبناء المدن الداخلية عن طرق الصيد وأنواع السمك. اندلعت الجدالات في تفضيل طبخ كل منطقة على الأخرى. قد تعلو الأصوات ويشتد السجال، لكن تلك اللحظات كانت من أسعد أوقات السجناء لأنهم يعيشونها مع حديث الطعام.
بشكل متواز، نشأت في المهاجع تجارة تقوم على عملة هي “الخبز”، فمثلاً قد يبيع أحدهم حصته من المربى، وهو مقدار ملعقة تصل في الأوقات السعيدة، برغيف، وقد يشتري آخر، يمارس الرياضة قدر الإمكان، حصة آخرين من البيض كي يستطيع تناول بيضة كاملة في أحد الأيام، وقد يشتري أحد السجناء من آخر، وصلته زيارة، كنزة ليستر بها جسده أو يتقي البرد، مقابل ثلاثة أو أربعة أرغفة تُسدّد بمعدل ربع رغيف يومياً…
تطور الأمر في بعض المهاجع إلى درجة تكليف أحد التجار السابقين بتحديد “الأسعار” حسب حال “السوق”. وتدخل الشاويش لحسم بعض القضايا؛ مثل توحيد الأسعار داخل المهجع وضبط المنافسة ومنع التداول مع بعض الأشخاص الذين عجزوا عن إدارة مواردهم بحكمة فوقعوا في العجز. ونمت التجارة إلى البيع المركّب لنوع من “طبخة” يجترحها المرء، كخلط البيض وقطع الخبز باللبن المروّب بالماء.
كانت المياه تنقطع لأيام أحياناً بسبب أذية أصابت خط التمديدات الواصل إلى السجن، أو كعقوبة من الإدارة والسجانين. وحين كانت تشحّ صار كأس الماء يباع برغيفين من الخبز.
تتفوق عبثية أوامر السجانين على نفسها كل مرة، ما داموا مطلقي اليد بشكل كامل. يروي أحد الشهود أن طريقة الحلاقة كانت بأن يرموا إلى داخل المهجع بعدة ماكينات موصولة بشريط واحد ليستعملها السجناء. وفي أحد الأيام صدر الأمر: “الكل يحلق” ولم تصل الماكينات. أبلغ رؤساء المهاجع السجانين بهذا فأتاهم الأمر مجدداً: “دبروا حالكن”! اعتبر البعض أن هذا مجرد كلام لأن الطلب غير منطقي. في اليوم التالي جاؤوا، ولما رأوا أن أمرهم لم ينفذ أخرجوا رؤساء المهاجع وعاقبوهم حتى قتل منهم اثنان أو ثلاثة. ثم كرروا الأمر: “بكرة بتكون كل العالم حالقة”. كان التهديد جاداً إذاً!! أخذ المعتقلون ينسلون الخيوط من البطانيات ومن ليفة الجلي وينتفون شعورهم. حتى في هذا عليك أن تكون حذراً، فالبطانية أهم من السجين بكثير في صيدنايا، كما يقول شاهد آخر.
يصعب الاستحمام بالماء البارد في المهجع، ولذلك يتم إخراج السجناء أحياناً إلى الحمامات الواقعة في آخر الجناح. يُدخلون كل سبعة أو ثمانية سجناء إلى إحدى غرف الحمام سوياً ويفتحون عليهم ماء مغلياً أو فاتراً. في طريق الذهاب والعودة لا يتوقف الضرب بينما ينزلق المعتقلون ويتساقطون بسبب ضعف أجسادهم والمياه على الأرض.
يروي شاهد قضى في سجن صيدنايا سنتين أنه ذهب إلى الحمام مرتين، كانت إحداهما طويلة فاستمرت لثلاث دقائق أو أربع تحت الدوش! أما آخر فقال إن المدة التي كانت مقررة للحمام في جناحه هي عشر ثوان تقريباً، يحددها تعداد السجان: “واحد… اثنين… ثلاثة… أربعة… يلا يا عرصة! خمسة… ستة… سبعة… ثمانية… يلا يا عرصة!!… تسعة… عشرة!!”. عندما يلفظ الرقم الأخير على السجناء أن يكونوا جميعاً في الخارج، وقد أخذوا وضعية “القطار”.
كان لنقص النظافة، بالإضافة إلى شح التغذية وتكرار الضرب، دور كبير في الانتشار المريع لأمراض الجرب والسل وسواهما، مما أودى بحياة الكثيرين.
يختلف أداء الأطباء المكلفين في سجن صيدنايا، بحسب الشهود الذين اتفقوا على أنهم لم يروا طبيباً يعالج مريضاً أو يعاينه. قد يضربه في بعض الأحيان، كما في حالة الضابط رنس المصلح المشار إليه أعلاه، وقد يتطور هذا الضرب إلى القتل، كما في حال الطبيب الذي سمّاه السجناء “الجزار”. أما الطبيب الجيد فهو من يكتفي بمراقبة أجساد السجناء وحركتهم، ليحدد من يعجز أو يتباطأ فيمنحه رقماً ويحوله إلى “مشفى تشرين العسكري” الذي يتبع له السجن من الناحية الطبية.
هناك سيستنتج المرضى أنهم لن يدخلوا المشفى في الحقيقة، بل سيوضعون في زنزانة خاصة خارج مبناه حيث ربما أعطاهم أحد عساكر المشفى أدوية عامة، دون معاينة، وصرفهم عائدين، أو يُدخَلوا إلى المبنى لإجراء الفحوصات وقد يتعرضون للضرب من الطاقم، فضلاً عن الضرب في طريقي الذهاب والعودة بالسيارة المغلقة (براد اللحمة) ذاتها. أخبرنا أحد الشهود: “كنا حوالي 30 محالاً إلى المشفى، وعندما وصلنا إليه كان أربعة منا قد توفوا. في اليوم التالي أخذوني لوضع جثث من قضوا في أكياس. كانوا أكثر من 15 قتلوا على يد الشبيحة والأطباء”.
ينقل شاهد آخر رواية فظيعة عما يجري في زنزانة المشفى التي يفصل بينها وبين بابه طريق طوله حوالي 200 متر، مفروش ببحص أبيض كبير. ولأن السجناء حفاة ومرضى وضعيفون جداَ سيقع بعضهم ويعجز عن المشي فيضطر العساكر إلى شحطه أو سنده. وتوفيراً لهذا “العناء” كان المساعد المسؤول يعيّن للزنزانة شاويشاً من السجناء، ثم يأمر المرضى بأداء بعض الحركات، فمن توقع أنه سيعجز عن المشي يشير إلى الشاويش بشحطه جانباً وتصفيته باستخدام لفحة قماشية وعصا موضوعتين لخنق المريض. بهذه الطريقة كان أحد السجناء يقتل أربعة أو خمسة من زملائه مقابل أن يأكل طعاماً بكمية وفيرة يُقدّم هنا.
لا شيء أسهل في سجن صيدنايا من القتل أو الموت؛ بالإعدام الميداني الذي كان يطال عدداً يتراوح بين الخمسين والثلاثمائة، مرتين في الأسبوع، بحسب تقدير أحد الشهود، أو بالإعدام بطريقة غير مباشرة؛ كأن يضربوا المعتقل ضربات قاتلة على مناطق حساسة كالنخاع الشوكي أو الرأس أو المعدة، فضلاً عن الموت بسبب المرض أو الجوع أو التعذيب.
ربما يأتي السجان في الصباح فيسأل: “شبه هادا ولاك عرصة؟”، فيجيبه رئيس المهجع: “مات”. فيعاود السجان السؤال: “مات وإلا فطس؟” فيجيب: “فطس”. قال: “لا تكونوا أنتو قتلتوه ولاك؟” فيجاب رئيس المهجع: “لأ سيدي، مات لحاله”. يسأل السجان: “شو اسمه ابن الشرموطة؟”، ثم يقول: “طيب ماشي… حطه ببطانية وزتّه برّه”. يتولى ذلك اثنان من السجناء، عليهما أن يخرجا الجثة خلال خمس ثوانٍ يرافقها التعداد الصادر من السجان، فإن لم يكفِ الوقت سيتعرضان لضرب وحشي.
في مواجهة كل هذا لم يكن أمام السجناء سوى اللجوء إلا الله، سواء كانوا متدينين في السابق أم لا. ورغم أن الصلاة ممنوعة نهائياً تحت طائلة العقوبة الشديدة، إلا أن معظم الشهود الذين التقيناهم قالوا إنهم كانوا يصلّون بوسائل متحايلة، كالصلاة بالعيون أو جلوساً، فإن أتيحت لهم فرصة الصلاة بشكل عادي، بما تتضمنه من ركوع وسجود، فعلوا ذلك بكثير من الحذر. كما انتشرت في السجن جلسات تبادل تحفيظ القرآن، وقراءة سور خاصة منه بهدف الحماية أو درء الأذى. وقد روى أكثر من شاهد تجربته الشخصية المؤثرة في ذلك.
كان هذا فقط ما يمكن فعله في السجن، بالإضافة إلى تفسير الأحلام والتعلق بها. نظمت إحدى الزنزانات “دورة” في تاريخ سورية المعاصر، مرّت بسلام، في حين أن زنزانة مجاورة اقتطعت من طعامها القليل جزءاً صنعت منه أحجاراً للعب الضامة. ولما اكتشف السجان ذلك عاقبهم بإغراق زنزانتهم بالماء حتى توفي أحدهم.
لا يُعرف حتى الآن من ارتكب كل هذه الفظائع، فرؤية السجانين أمر شديد الخطورة في سجن صيدنايا. إذا صدف ورأيت وجه السجان سيكون مصيرك الموت. أما إن حدثته وأجابك، دون ضرب، فهو “ابن حلال”. ورغم وجود بعض من هم أقل شراً من الآخرين إلا أن تمييز هؤلاء عسير، وكثيراً ما انتهت القصص التي أوحت بدايتها بالتعاطف بمفاجآت غير سارة. اللهجة المعتمدة للسجانين هي اللهجة العلوية، لكن بعضهم كان علوياً بالفعل وبعضهم كان ينتحل هذه اللهجة كنوع من الاستقواء والتسلط.
لا توجد معلومات كافية عن هيكلية السجن وطاقمه، غير أن المدراء الذين تولوه خلال الثورة، كما رصدت الرابطة حتى الآن، هم:
العميد طلعت محفوض: منذ قبل الثورة وحتى مقتله في 7 أيار 2013. كان مدير سجن تدمر. من طرطوس، الدريكيش.
العقيد إبراهيم حسن: منذ مقتل محفوض وحتى نهاية 2013.
العميد أديب إسمندر: لشهرين في مطلع 2014. كان رئيس الشرطة العسكرية باللاذقية.
العقيد محمود معتوق: منذ شباط أو آذار 2014 وحتى وفاته في 12 كانون الثاني 2018. من اللاذقية.
العقيد حسين محمد: من اللاذقية.
أما الشهود الذين التقيناهم فقد ذكر معظمهم أسماءهم الحقيقية كما أوردناها، إلا إذا اقتضى الأمر إخفاءها لسبب أو لآخر، كما في حالات (أبو الفتح؛ أبو عمر؛ محمد؛ أبو أنس الحموي؛ أم علي).
رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا

 Eng
Eng