برزت الإرادة الشعبية قوّة لها قدرة لا حدّ لها على الإزاحة، فما ضجّت به الشوارع العربية يمكن وصفه بـ"طقس لغويّ"، مزّق عباءة اللغة "العاديّة". إنه نثر ينثر، ليعيد ترتيب الأشياء محرِّراً إيّاها من كلّ حَسْمٍ وحتميّة. هو طقس يبدأ بالشعب ولا ينتهي..
05 / أيار / مايو / 2021

مع العدالة | علا شيب الدين
(1)
الإهداء:
إلى كل مَن اختار المخاطَرة، متجاوِزاً خطر الالتفات إلى الوراء، أو البقاء في الوسط، قاصداً العبور إلى الحرية توقاً وشوقاً… إلى شعب يريد…
ويدرك أن الاستبداد خطر، وأنّ الديموقراطية جهة مقابِلة، تستحقّ المخاطَرة دونما وَجَل ولا حَذَر… والسلام على أرواح أُزهِقت وهي تحاول العبور…
 نشرت فصول هذا الكتاب بموافقة الكاتبة
نشرت فصول هذا الكتاب بموافقة الكاتبة
مقدمة
1
قد لا نجانب الصَّواب، إذ نتفكّر في “الرّبيع العربيّ”. في ما هو ثورات “ولادة الإنسان”، في منطقة من العالم شهدت موتاً حقيقيّاً للإنسان واقعاً ومفهوماً، إذ أُلقي به خارج التاريخ، أو إلى هامشه، على مرّ عقود طويلة استفحل فيها نزوع غريزيّ إلى السيطرة، مارسته أنظمة قائمة على قهر الإنسان واستعباده، فما الاستبداد سوى شكل مرير وبشع من أشكال الاستعباد فكراً ونهجاً وممارسة.
إنَّ الكلام عن ولادة جديدة للإنسان قد يرتبط بسؤال كالآتي: مذ إضرام التونسيّ (محمد البوعزيزي([1])، النّار في جسده احتجاجاً على واقع ظالم، واندلاع الثورات بعد تلك الواقعة واحدة تلو الأخرى، من بلد عربيّ إلى آخر؛ هل نحن أمام منعطف جديد في تاريخ المنطقة قد يفرز أنماطاً جديدة من المجتمعات، عبر تغيّر جوهر هذه المجتمعات، أي الإنسان؟. ربما تبدو الإجابة عن السؤال هذا أكثر حيويّة إذا ما قرأنا ثورات “الرّبيع العربيّ”، قراءة علميّة تستند إلى قوانين اجتماعية تشكّل نظاماً عاماً تسير وفقه حركة المجتمعات في تغيّرها وتطوّرها. فعلى الرّغم من تميّز الثورات الاجتماعية/الشعبية تلك، بعفويّة يصعب معها الحديث عن “قوانين”، فقد يحقّ لنا التفكّر فيها، انطلاقاً من قوانين اجتماعيّة ربما تقترب من قوانين الطبيعة وتحاكيها، على اعتبار أن ثمّة حياة اجتماعيّة وحياة طبيعيّة، وطبيعة بشريّة وطبيعة طبيعيّة؛ وكما تعمِّد الحياة الطبيعيّة الزَّلازل والبراكين والعواصف والرّعود والكسوف والخسوف والمدّ والجزر.. إلخ، ضمن نظام كونيّ دقيق كآلة رياضيّة ميكانيكيّة بحسب التّعبير الديكارتيّ؛ كذلك، تمهر الحياة الاجتماعيّة الثورات والتمرّدات بخاتم الصيرورة وجدل العدم والوجود.. إلخ، مادام فحوى الحياة الاجتماعيّة هم البشر، بصفتهم جزءاً من الطبيعة تنطبق عليهم نواميسها مثلما تنطبق على بقيّة الموجودات؛ ولمّا كان الضَّغط يولِّد الانفجار فيزيائيّاً، فإنّ الذّات الإنسانيّة المقموعة تحت ركام من القهر، سوف تحين اللحظة التي تنبثق فيها الذّات تلك، مدوِّية معلنة عن سخط إيجابيّ فعّال، رادَّة إلى نفسها الاعتبار والوجود. هكذا، يصبح في إمكان العقل ربما فهم شيء عن غضب شعوب المنطقة العربية العارِم الذي اجتاحها على هيئة ثورات.
أن يكون الإنسان جزءاً من الطبيعة تنطبق عليه نواميسها انطباقها على الكائنات الأخرى؛ معناه أن ثمّة ما يدفع المرء ربما إلى تأمّل الحياة الاجتماعيّة بالآليّات نفسها التي يفكَّر من خلالها في الحياة الطبيعيّة، كون ما يشكِّل الحياة الاجتماعيّة هو اجتماع إنسان بإنسان، فالإنسان كائن حيويّ يشترك مع الكائنات الأخرى في الكثير من السِّمات الوجوديّة. هذا من جهة. لكنَّ ميزة وجود الإنسان – من جهة أخرى- تكمن في كونه وجوداً معنويَّاًّ وحرّاً مختاراً في هذا العالم، وفي كونه ظاهرة ثقافية، لغويَّة، منعتقة من الطّبيعة المحضة. هو كائن يتأثَّر بالطبيعة ويؤثِّر فيها. تكيّفه معها لا يشبه في حال من الأحوال ذاك التكيّف الذي تخضع له بقيّة الكائنات خضوعاً غرائزياً، فتكيّفه نابع من صميم العقل، حتى أنّ الإرادة الإنسانيّة تجعل من الإنسان بفضل العقل كائناً متكيّفاً مع البيئات كافة، بشكل يختلف عن بقيّة الكائنات التي لا يمكنها التكيّف سوى مع بيئة واحدة، بيئتها.

الإنسان بعقله، تكيّف مع البحر والفضاء والغابة والصحراء، ومع القطب المتجمِّد من الأرض….إلخ، وحسبنا أن نعود إلى أقدم الحضارات البشريّة لكي نتحقَّق من أن الإنسان قد سعى منذ القِدَم لكي يتكيّف مع الطبيعة عبر شعوره بأنها “شيفرة” تستدعي فكّ رموزها، وأن نفسه “أحجية” تتطلّب الشَّرح والتَّفسير، هكذا كان الذكاء الإنساني يتكيّفَ مع الطبيعة لكي يتجاوزها، فهو لم يسايرها قط؛ لأن تكيّف الإنسان، ككائن عاقل، ينطوي على رفض الواقعة المحضة، ونبذ التّصديق السّاذج. وعليه، تساعدنا خاصيّة الإنسان في رفض الواقعة المحضة، في محاولة تفسير “الربيع العربي” من خلالها.
نقول محاوَلة للتّفسير ليس إلا، نظراً إلى صعوبة التّفسير المنطقيّ مع ثورات عفويَّة لم تنطلق من مقدِّمات معيّنة لنصل عبرها إلى نتائج مساوقة لها، منسجمة وإيّاها. فهي باختصار، ثورات شعبيّة طَرحت فيها الشعوب في الشارع، الحرية كفعل. لعل أهمية هذه الثورات، تأتي مما أضافته إلى مفهوم الثورة من ارتباط الحرية والعدالة والكرامة والديموقراطية بـ(السِّلميَّة)، التي هي السِّمَة الرئيسة لها، ولم يكن حمل السلاح في بعضها، كما في الثورتين الليبية والسورية، خياراً. بل اضطرار دخيل عليها، لا داخل فيها، ولا مكوِّن لها، إذ ماهيَّتها سلمية مدنية شعبية، أساسها الأطفال والنساء والشباب والمسنّين. إنه اضطرار أجبرَ بعض الناس عنوةً على حمل السلاح لغرض حماية أنفسهم أولاً من بطش أنظمة انفلتَ من كل عقال.
إنَّ رفض الواقعة المحضة، يعني رفض الإنسان التكيّف مع واقع لا يحقّق فيه إنسانيّته؛ هكذا، تمرّدت شعوب المنطقة العربية في ربيعها وثارت على واقع سياسيّ، اقتصاديّ، واجتماعي مُزرٍ ومُهين. الواقع الذي طالما فُرِض عليها، كأنه واقع محض و”أبديّ”، وما عاد تكيّفها مع ذلك الواقع، إلا ضرباً من المستحيل، تؤطّره الرغبة في اقتلاع الاستبداد من جذوره، توقاً إلى الديموقراطية حُكماً
وثقافة. الديموقراطية التي تعيد، من خلال تعدّديّتها، الكرامة الإنسانية المهدورة في عالم الاستبداد المظلِم والظّالم.
إنّ “ثقافة” الاستبداد لا تنطفئ كليّاً ودفعة واحدة؛ وفي المقابل، الديموقراطية المأمولة ليست مسألة ناجزة، بل هي تجربة حيّة، طريق ومسار. في معنى آخر، هي ثقافة تُبنى على مرّ الزمن من خلال التربية أولاً، والجهد الحثيث؛ لذا يخطئ من يظن أنّ الديموقراطية قابلة للتحقق بين ليلة وضحاها. وعليه، يمكن المرء أن يتفهّم أن تظلّ رواسب الاستبداد موجودة، بعد سقوط الديكتاتور ونظامه حتى، وأن تظلّ الدول التي حصلت فيها ثورات شعبية من أجل الديموقراطية، تشهد ما هو منافٍ للديموقراطية، ومناقِض لمفهومها، أو مفاهيمها الأخلاقيّة والسياسيّة.
في العودة إلى السؤال المطروح آنفاً، حول إمكان إنتاج ثورات “الرّبيع العربيّ”، أنماطاً جديدة من المجتمعات، يمكن القول: إن التحوّل في المجتمعات قد يكون بطيئاً، تدرّجيّاً، وقد يكون فجائيّاً، “حدَثاً” تاريخيّاً، كحَدَث “الرّبيع العربيّ” الذي يشي بإنتاج أنماط جديدة من المجتمعات، مادام مَن يشكّلها، أي الإنسان باجتماعه مع الإنسان، قد تغيَّر من خلال ثورة، هي ليست على واقع موضوعيّ فحسب، بل أيضاً على الذّات. إنها الذّات التوّاقة إلى الانعتاق من الأصنام (السلطات). لعلّ أشدّ الأصنام مأساويَّة، ورغبة في التحرّر منها هو صنم “الخوف”، لذا قد يبدو التقهقر، أي العودة إلى زمن ما قبل اندلاع الثورات، عودة تناقِض قوانين الحياة الاجتماعيّة والطبيعيّة التي حاولنا الخوض فيها في ما سبق من هذه السطور.
القوانين التي تحكم المجتمعات البشريّة ربما تقتضي – مثل قوانين الطبيّعة- التطوّر والارتقاء الدّائم، بحيث يكون البقاء للأصلح في المعنى الدّارويني للعبارة، ومما دلّل عليه الواقع ولا يزال، أن الأصلح في الصِّراع بين الشعوب العربية وديكتاتورياتها، هو الشعوب الطَّامحة للارتقاء في إنسانيّتها من خلال ولوج عصر جديد، هو عصر الدّيموقراطيّة واحترام حقوق الإنسان. هذا المفتوح على ارتقاء لا متناهٍ، إذ كل نهاية مرحلة، تبدو كأنها مستعدّة لتكون بداية لأخرى. يبدو الكلام الأخير هذا أقرب ما يكون إلى المؤرِّخ وعالم الاجتماع ابن خلدون (1332- 1406م) في قوله: “واتَّسعَ عالم الحيوان وتعدَّدت أنواعه وانتهى في تدريج التَّكوين إلى الإنسان”.
نزوع الشعوب الثائرة إلى الارتقاء في إنسانيِّتها، قابله نكوص لدى أنظمة الحكم في اتجاه بدائيّة حيوانيّة غرائزية بحتة. تجلّى النكوص في الممارسات الوحشيّة التي مارستها الأنظمة ضدّ شعوبها. لا نبالغ إذاً، حين نقول: إنَّ ثورات “الرّبيع العربيّ” التي مثّل فيها شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” محوراً، وقاسماً مشتركاً بين الشعوب الثائرة، يؤسِّس لأوّل أفق إنسان جديد في هذه المنطقة من العالم، ومجتمع جديد، وعصر جديد متّصل بآخر أفق إنسان قديم، ومجتمع قديم، وعصر قديم، كان يحمل بين تضاعيفه، بذور تحوِّله.
2
تجدر الإشارة، في المقدمة هذه، إلى أن أصل هذا الكتاب، مقالات منشورة خلال الأعوام 2011-2012-2013-2014. جُمِعَت وأُعيدَت صياغة بعضها، وعُدِّلَ بعضها الآخر، وأُضيف إليه ما قد يُغنِي ويُثري، ليكون هدية رمزيَّة لثائري وثائرات الحرية، وإسهاماً نظريّاً في الثورة. هذا الكتاب، ربما يشبه الثورة، في عفويتها، وفي كونها مسار…، إذ فحواه أفكار، مستقاة، في أغلبها، من واقع حيّ ومعيش، وجدت نفسها في كتاب، من دون تخطيط قَبْليّ. ليس من شأن أفكار الكتاب، قطع الطريق أمام أي فكرة جديدة قد تثري ما هو مطروح وتضيف إليه، وفي هذا، ربما يكون قد قارب الثورة أيضاً. ثمة، في امتداد الكتاب، مساحة، بل مساحات، من شأنها “التحريض” على قراءات ربما تعيد كتابة المكتوب، وتساهم في إعادة إنتاج النص الناقص دوماً، والمفتوح على ارتقاء لا متناهٍ.
****
تجدر الإشارة أيضاً، إلى أننا آثرنا استعمال اصطلاح “الربيع العربي”، باعتباره بات معروفاً ومتداوَلاً كـ”اسم عَلَم” يُطلق على ثورات الشعوب في هذه المنطقة من العالم منذ اندلاعها واحدة في إثر أخرى. بيد أن ذلك لا يعني التَّسليم بالاصطلاح كما هو من دون مراجعته مراجعة نقديّة، إذ لدينا بعض التحفّظ عليه، كونه يُغفِل قوميَّات أخرى، ثارت ضد أنظمة الحكم العربية المستبدَّة، من مثل القومية الكرديّة في سوريا.
****
حاولنا التفكير في “الربيع العربي”، باعتباره ثورات، لا انتفاضات. إذ تبدو الانتفاضة كأنها مختصّة بالسطح، بينما تذهب الثورة عميقاً صوب الجذر، وما قد يُفهم من الانتفاضة على أنه مرحلة، أو تحديد عصيّ على الاتساع، يبدِّده ما قد يُفَهم من الثورة، انطلاقاً من رؤيا متفائلة معقولة لا يشوِّشها الراهن، وتثق بقدرة، أو قدرات الشعوب على إحداث تغييرات جذرية، تستشرف مستقبلاً مضيئاً. إذ الثورة نار شاملة، ونخطئ إن اعتقدنا أنها مجرَّد مرحلة، فهي تتَّسع لكل شيء، وتطال كل شيء، وهي مصير فردي واجتماعي، وإنساني.
****
لا نتحدث في هذه المقدمة عن ثورات “الربيع العربي” عموماً، ولا نتناول في الموضوعين الأولين من المبحث الأول من الكتاب، ثورات “الربيع العربي” بشيء من العمومية أيضاً، وهو المبحث الذي نحاول فيه مقاربة الثورات نفسها، مقاربة لغوية من خلال محاولة تفكيك لغة الثورة، كشعار “الشعب يريد إسقاط النظام” الذي رفعته الشعوب الثائرة كافة، أو التأمل في مفهومٍ جديد لـ”الشارع”؛ إلا لكي ندخل من خلال العمومية تلك إلى الثورة السورية على سبيل التحديد، نحاول التعمّق فيها، ونقارب بعضاً من حيثياتها من وجهة نظر فكرية فلسفية أحياناً، وسيكولوجية أحياناً أخرى، وتأملية…؛ انطلاقاً من كوننا من أبناء سوريا، وكنّا من المنخرطين في الثورة، في معنى ما. الاعتصام والتظاهر السِّلميّ في الشارع مثالان على هذا الانخراط، فقد عشنا إلى حد ما، تجربة حيّة أنتجت بعض ما نطرحه هنا من أفكار وتأملات.
****
نودّ أخيراً، تقديم اعتذارنا سلفاً من القارئة والقارىء، في شأن عدم التفصيل في وقائع مذكورة في الكتاب، والاكتفاء بالإشارة إليها كأمثلة. لكن نظن في الآن عينه، أنها وقائع معروفة ربما، إلى درجة أنه في إمكان أي مهتم الرجوع إليها والبحث عن تفاصيلها، خصوصاً أن المعلومات عنها متاحة، فهذا الكتاب ليس توثيقاً، ولا وصفاً، ولا تأريخاً في المعنى الدقيق للمفردة، بل هو في المقام الأول، ربما يكون بمثابة تأمّل في المعنى وتفكّر فيه، ومحاولة لإدراك المغزى.
المبحث الأول:
في ثورة اللغة ولغة الثورة
الشعب يريد إسقاط النظام
يشبِّه غوستاف لوبون، الجمهور النفسيّ، المحكوم بقوى اللاشعور الطّاغية، بالإنسان المنوَّم مغناطيسيّاً. فبما أن “حياة الدماغ تصبح مشلولة لدى الإنسان المنوَّم، فإنه يصبح عبداً لكل فعالياته اللاواعية، ويصبح منوِّمه قادراً على توجيهه الوجهة التي يشاء بعد أن غدت الشخصية الواعية مغمىً عليها، وأصبحت إرادة الفهم والتمييز ملغاة”([2]). يبدو كلام لوبون كأنه تأمّل لما قبل يقظة جمهور، فمع ثورات الشعوب في العالم العربي على لاشعورها، لم تعد الشعوب مُنوَّمة، و”القائد أو الزّعيم المنوِّم لم يعد خارقاً العادة ولا مرفوعاً إلى درجة العبادة”، مادام “الجمهور” قد دخل تجربة الوعي، وأدرك أنه شعب يريد، وما عبارة “الشعب يريد..” سوى ضمير “الأنا” تصريحاً وتلميحاً.
إن إضاءة اللاشعور، حيث العتمة والمكبوت، عبر الإرادة الشعبيّة، بيّنت أن “الحياة الواعية للنفس البشريّة لا تشكّل إلا جزءاً ضئيلاً جداً بالقياس إلى حياتها اللاواعية”([3])، وعلى صعيد الحياة الواعية، فإن “عالِم الرياضيات يتفوّق ذكاء بما لا يُقاس على الإسكافيّ صانع الأحذية، ولكن على صعيد الحياة اللاواعية، ولا سيّما ما يتعلّق منها بالعاطفة والوجدان والغرائز والعقائد الإيمانيّة الموروثة، فإن “البشر الأكثر عظَمة وتفوّقاً لا يتجاوزون إلا نادراً مستوى الناس العاديين”([4]). من هنا ربما تتأتّى أهمية ثورات الشعوب في العالم العربي، التي يبدو اندلاعها كان مستحيلاً لو لم ينفتح باب اللاشعور على مصراعيه، خصوصاً أن الفرد في الجَمْع يجد نفسه في شروط تتيح له أن يفكّ أسْر ميوله اللاشعوريّة المقموعة، فأن تتّجه الإرادة الشعبيّة في اتجاه إسقاط النظام؛ معناه مغادرة اللاشعور العتمة، عبر اجتماع إرادات عزمت على أن تكون حرّة وانتهى الأمر.
****
تجلّت المفارَقة من خلال تبديد العتمة تلك بـ”الكلمة” (اللّوغوس)، فإن كنّا لا نشكّ في أهمية ما حدث على أرض الواقع، واقع العالم العربي، فإننا لا نشكّ في أن ما حدث على أرض العقل – إن جاز التعبير- أهم. وبما أن الكلمة كانت في البدء، (في البدء كان الكلمة)، إذ بالكلام يصير الإنسان إنساناً في معنى ما، فالكلمة كائنة في الوسط أيضاً، وربما ستكون في النهاية. الكلمة من حيث هي عزيمة خلق وإبداع. فهي إذ تفصح عن إرادة شعبيّة، كمجموعة إرادات كانت مكبَّلة وحرَّرت نفسها بنفسها، تنتقل بالشعب، من حيث هو شِعَاب، أو “فروع”، إلى مركز ضدّ مركز، وبنية ضدّ بنية. إنه مركز يبدّد المركز وبنية تخلخل البنية من الداخل عبر إرادة الإسقاط، أي إسقاط النظام. فالبناء الذي كان شاهقاً، صار أدنى، والعلوّ المركّب الصّلب المتكتّل، صار ذائباً سائلاً، والسّرّ الذي طالما انطوى عليه البناء زمناً طويلاً، صار علناً. ربما يكون ذلك لحظة أولى في زمن تنوير عربي جديد مُقبِل.
****
تحت الهدم الذي انتهجته الإرادة الشعبيّة، بنية، أو يمكن القول (بنية هَدْمٍ مخفيّة)، تؤسّس لهَدْمٍ يُسقِط (بينة خارجيّة قديمة)، فيعود الهَدْمُ إلى تحته، محاولاً إبراز بنية جديدة عبر تقويض البنية الخارجيّة القديمة. في معنى آخر، عبر تقويض نظام معرفيّ متأصِّل، فما يعدّه الناس خطأ وما يعدّونه صواباً، ما يعدّونه حقيقة وما يعدّونه وهماً، يتغيّر كليّاً، بمثل الاعتباطيّة التي تتغيَّر فيها أنماط الخطاب والنُّظم المعرفيّة التي هي الأصل في ذلك كلّه.
هكذا؛ تبدو الشعوب العربيّة كأنها اكتشفت لغة جديدة، أو طوّرت نموذجاً لغويّاً يؤسّس لجدليّة في التفكير، عبر هدم بنية قديمة باتت الحاجة ملحّة إلى هدمها. قد يحقّ لنا وصف ثورات العالم العربي بأنها ثورات لغويّة بشكل أو بآخر، بدءاً من عالم افتراضيّ محوره الكلمة، وليس انتهاء بشعار “الشعب يريد إسقاط النظام” التي طالما زمجرت به الحناجر من قلب الشارع النابض بالحدث. أطلّت اللغة كطاقة هائلة في مدلولاتها ومحمولاتها، وفي قدرتها على خطّ أبجديّة ذهنيّة جديدة تتّسم بالتفكيكيّة، من حيث كون الذهن جزءاً من العالم، ومن حيث كون النّفس انعكاساً للعالم والإنسان.
ولئن كان “الجوهر” ميتافيزيقا وثباتاً يأبى حيويّة الأعراض وحركتها؛ سنرى أن عبارة “الشعب يريد إسقاط النظام” خالية من الجوهريّة الميتافيزيقيّة، كونها ضاجّة بالمعنى الحيّ، فهي إذ تنطلق من مفردة “الشعب” كدالّ لا ينفصل عن مَدْلولاته المفعمة بالنّبض والكثرة، تؤكّد الصّيرورة كوجود وعدم في آن واحد.
****
ثمّة لدى الذهنيّة العربية الجديدة، التي خطّت أبجديّتها الأوليّة لغة غير اعتياديّة تحتفي بالمتعدِّد والمتجدِّد والمتبدِّد أيضاً، مَيْل غير اعتيادي إلى تفتيت كتلة المفرد المتّسق. تبعاً لذلك سيغدو “المُعتَقد”، أي الرأي السائد في الأمور، عُرضة لهزّات تقوّض أركانه الرّاسخة، مفارَقة أو مغامَرة أو مخاطَرة، فاتحةً الطريق أمام كلّ تجاوز. اللّغة غير الاعتياديّة تلك، لا تطمح. فالطموح غاية، والغاية نقطة تتجمَّد عندها الحياة، بما تنطوي عليه من تجاهل لتفاصيل أخرى غير الغاية نفسها، فتشوّه معنى الحياة المديدة والعالم الفسيح، ثم إن الطموح من حيث هو غاية تنأى بنفسها عن غايات أخرى، عبر التمركز والتمحور حول الذات يقود إلى اللاتسامح.
****
حين يزمجر الشعب مُريداً إسقاط النظام لا يفضح الخطأ فحسب، بل ينزع عنه سمة “الطبيعيّ” أيضاً، السّمة التي طالما برّرت “الأنظمة” من خلالها الخطأ الكارثيّ. يخبرنا رولان بارت بـأنّ ثمة “تعمية” حاصلة، وهي نوع من الخداع الذي يمارسه البعض في خطاباتهم السلطويّة التآمريّة كأن يُقال: “طبيعيّ” أن تحصل أخطاء. الغرض اللاأخلاقي هنا، هو إعطاء الظواهر التاريخيّة أو الثقافيّة مظهر الظواهر الطبيعيّة، والرّدّ الوحيد على التَّعمية هو فضحها. إن كَوْن الشعب ينطلق من الإرادة المعقولة، يؤكّد إنسانيّته الحرّة المنعتقة مما هو طبيعي، غرائزي، مفروض من قوّة غير القوّة الإنسانيّة، وإن فضح الشعب للخطأ الذي أُسبِغت عليه الطبيعيّة كتبرير من قبَل أنظمة انفصلت عن الواقع واغتربت في وهم الأبديّة، هو وسيلة من وسائل التّنوير الاجتماعيّ والسياسيّ.
****
ليست اللّغة مجرّد إشارة إلى حالات شعوريّة، بل هي أيضاً تشكيل للعقل؛ لذا قد تبدو ثورة الشعب المتجلّية في إرادته المتّجهة إلى إسقاط النظام، ثورة لغويّة، لا تظهر اللّغة من خلالها وسيلة فحسب، بل هي أيضاً عزيمة هدْم وخلْق. هكذا؛ تهتزّ قواعد لعبة الدّال والمَدْلول، فاللغة هنا تقوم بفعل “التّحرير” من القيود المفروضة، قيود الوسيلة الآليّة التي وُضِعَت فيها. إنه نوع من “الكَدْح اللّغوي” يرحل بعيداً إلى ما وراء الحرف فيقلّص المسافة بين الدّال والمَدْلول، بين الرّمز والمعنى، بين الصّوت والشيء، وبين الذّات والموضوع، فتتبدّى حيويّة اللغة.
****
برزت الإرادة الشعبية قوّة لها قدرة لا حدّ لها على الإزاحة، فما ضجّت به الشوارع العربية يمكن وصفه بـ”طقس لغويّ”، مزّق عباءة اللغة “العاديّة”. إنه نثر ينثر، ليعيد ترتيب الأشياء محرِّراً إيّاها من كلّ حَسْمٍ وحتميّة. هو طقس يبدأ بالشعب ولا ينتهي؛ لأن اللغة الحيّة اللامتناهية، لغة شعوب، بينما لغة الأنظمة متناهية ميّتة. لغة الشعوب حياة مترعة بالتناقضات وبتعايش المعاني المختلفة، مفتوحة على احتمالات لا حصر لها، تبدِّد وهم السّكون والتّكرار.
إنّ العقل المُثقل بنصّ سلطويّ، وثبَ ينحتُ لغة خارجة على النَّص، تكسر قيد المنصوص عليه والمُبْرَم، فينحلّ كلّ “خطاب” رادماً الهوّة التي ينشئها التّمييز بين الدّال والمَدْلول. نَحَتَ العقل المتحرّر للتّو لغة ليست مبنيّة من حَرْفيّة دينيّة ولا سياسيّة ولا اجتماعيّة ولا ثقافيّة معتادة ومكرورة، بل هي لغة حرّة من كلّ جذر وقاعدة، من كلّ اتساق ونسَق.
القطع اللّغويّ مع الجذر، يعني، في معنى ما، التّمدّد والتّماهي مع السطح، عبر مغادرة الموروث والتاريخ لصالح الجغرافيا. جغرافيا تتخطّى الحدود في اتساع يرقى إلى مستوى الكونيّة.
****
قد لا تشمل الرّغبة اللّغوية في التحرّر من المنطق التقليديّ، الموروث والتاريخ فقط، فهي قد تمتد لتطال المنطق التقليديّ، في المعنى الأرسطيّ، حيث الضّرورة التي تفرض الانتقال من مقدّمات محدّدة للانتهاء إلى نتائج محدّدة، تنسجم وتلك المقدّمات وتتساوَق وإيّاها. هكذا؛ تنهض اللّغة الجديدة المتبدّية في الإرادة الشعبيّة وفي إسقاط النظام، تنهض متمرِّدة على المنطق الصّوري التقليديّ، من حيث هي لغة ترفض كلّ معرفة سابقة ومتوقَّعة في آنٍ واحد. إنها لغة وسط، والوسط هنا لا يعني حدّاً أوسط وظيفته الرّبط بين المقدّمات، ولا يَظهر في النتيجة في إطار المنطق الصوريّ التقليديّ؛ إنما هو اللّحظة الحاضرة، الواقع بحركة وحركيّة لا تنْضبان. إنه وسط لا يكترث لسبب ولا لنتيجة. هكذا؛ تتفتّح حريّة الإنسان من حيث هو كائن لا يخضع للتوقُّع، ولا يمكن حصره بسبب ونتيجة.
وبما أن الإنسان كائن لا مُتَوَقّع، فهو إذ يصنع التاريخ، يستمدّ التاريخ من صانعه، أي الإنسان، سِمَة اللامُتَوَقَّع تلك، بحيث يمكن لنا أن نتصوّر التاريخ على أنه انفصال مثلما اعتدنا على أن نتصوّره اتصالاً، فالقفز في التاريخ يبدو وارداً، وما إقدام محمد البوعزيزي على إضرام النّار في جسده إلا “طَفْرَة” لا تاريخ لها يسبقها ولا تَوَقُّع لما بعدها. وإن افترضنا جدلاً أننا نعرف أسبابها الحقيقيّة؛ فلا يمكن القول إننا من الممكن أن نتوقع نتائجها. من هنا يمكن لنا وصف اللّغة الجديدة المتجلّية في عبارة “الشعب يريد إسقاط النظام” بأنها عفويّة لامُتَوَقَّعة، فهي لا تكشف عن فضاء لم يكن في البال فحسب؛ بل هي أيضاً تحرّض على التفكير فيما ليس مَفَكَّرَاً فيه، عبر خاصيّة “الانبثاق”، وهذه لا تخضع لقواعد المنطق التقليديّ المضيء أو المُعْلَن، كونها ضوءاً غير مُكْتَشَف يقطن العتمة. إنها الإبداع وقد تجلّى، لافتاً الانتباه إلى جزء مُهمَل من الدّماغ، هو النّصف الأيمن الذي طالما هُمِّش دوماً لصالح النصف الأيسر، نصف المنطق المُعتاد والمألوف.
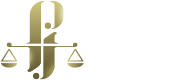
يا ترى ما الذي يمنع من إطلاق رمز كرسي (ك ر س ي)، مثلاً، على سطح بأربع أرجل قد نأكل عليه أو نكتب، اعتدنا أن نرمز إليه بـطاولة (ط ا و ل ة)؟. ما الذي يمنع من نصبِ الفاعل في اللغة العربية ورفع المفعول به؟. من قال إن قدَر المفعول بهم ألا يُرفَعوا؟!. لماذا لا يتمرّد الساكن فيتحرّك حين يُفرض عليه ألا يتحرّك؟!. ولماذا لا نمنح ما لا محلّ له من الإعراب إعراباً؟!. تلك تساؤلات قد تنبِّهنا إلى عبثيَّة اللغة ربما، أو إلى إمكان التلاعب فيها، وقد تنبِّهنا إلى أن الخطأ المعرفيّ، ناجم عن القسْر اللّغوي الذي يكمن في إلصاق رمز معيّن بشيء معيَّن، مع إغلاق الطريق أمام أيّ محاولة للخروج على هذا القسر. لذا فإن من شأن عبارة كـ”الشعب يريد إسقاط النظام” أن تدفع باللّغة إلى تجاوز اللّغة ذاتها، عبر نزع سمة “الاعتياد” عنها، فالولادة النّاجمة عن التّفكيك الحاصل من عبارة من شأنها إسقاط ما هو مبنيّ، منبثقة من الداخل، داخل البنية نفسها، فيكون الخارج من الداخل، والتّقويض يكون من الأدنى إلى الأعلى، وتنطلق الأنا المتمرِّدة من حجر الأساس.
ربما لم يعد الإنسان في العالم العربي مع عبارة “الشعب يريد..”، كائناً مُثقفاً، مبنيّاً كما بنته الثقافة السّلطويّة، وكما يروق لهذه الثقافة أن تبنيه، فعبارة “الشعب يريد..” إذ تُقرَن بـ”إسقاط النظام”، تفتّت الثقافة كبناء، وتعلن عبوديّة الإنسان المُثقَّف (المَبْني)، المفعول به دوماً، والمُجَمَّد في صورة نمطيّة شيئيّة ساكنة، فتحرّره من هذه العبوديّة.

هوامش:
[1]– محمد البوعزيزي (1984 – 2011): شاب تونسي. أضرم بتاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) لعام 2010، النار في جسده أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية في مدينة سيدي بو زيد لعَرَبة خضر وفاكهة كان يكسب رزقه من بيعها، وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد تقديمها في حق الشرطية فادية حمدي التي صفعته أمام الملأ وقالت له بالفرنسيةDégage) : أي (ارحل)، فأصبحت هذه الكلمة شعار الثورة للإطاحة بالرئيس، وكذلك شعار الثورات التي اندلعت في بلدان عربية أخرى. كان ذلك الحدث شرارة، أدّت لثورة أطاحت، بعد قرابة شهر، بالرئيس زين العابدين بن علي. أما البوعزيزي فقد توفي بعد 18 يوماً متأثراً بحروقه.
[2] – سيغموند فرويد، علم نفس الجماهير وتحليل الأنا، ترجمة وتقديم جورج طرابيشي، رابطة العقلانيين العرب، دارالطليعة، بيروت، التقديم ص13.
[3] – الكلام لغوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، التقديم ص11–12.
[4] – الكلام لغوستاف لوبون، المرجع السابق نفسه، التقديم ص11–12.

 Eng
Eng