يا للخزْي ويا لتعاسة هذا الشعب العنيد.. وزير دفاعنا لم ينتصر في معركةٍ واحدةٍ، ولا حتى في مكاسرة أيدٍ، لكنه انتصر على معتقلي تدمر، وأمر بسوْقهم إلى أعواد المشانق بالآلاف!
09 / حزيران / يونيو / 2020

*مع العدالة | محمد برو
تنطلق بنا الشاحنة في الساعة الخامسة فجراً من سجن تدمر الصحراوي، إلى جهة لا نعرفها وفد عُصبت أعيننا بعصابات مطاطية سوداء، وقيدت أيدينا إلى الخلف، لا نسمع أيّ همسٍ سوى صوتِ محرّك الشاحنة، وبعض الهمهمات الدائرة بين الحارسين.
بعد ساعةٍ ونصف تقريباً، أمضيناها ونحن مكدسون فوق بعضنا مثل الذبائح، توقّفت الشاحنة، وكان هناك ضوءٌ خافتٌ في الأفق، أميزه من طرف عصابة عينيّ، يوحي بدُنوِّ شروق الشمس، وصوتُ أبواب السيارات وأقدام الحرس ونسمات الصباح الباردة تتسرّب مع فتح الأبواب. كان هناك صوتُ صنبور ماء، واضحٌ أنهم توقّفوا للاستراحة، وربما شرْب بعض الشاي، كان هناك حارسان قريبان من مؤخرة الشاحنة، همس أحدُهما بصوتٍ خافت جداً لكنه مسموع بصعوبةٍ بسبب الهدوء المخيم على المكان:
– إلى أين نمضي بهم؟
– إلى حقل الرمي في “سعسع” (حقلٌ للرمي يقع إلى الجنوب من مدينة دمشق يتم التدريب على الرمي فيه)، هناك سيتمّ رميهم بالرصاص
– لماذا لا نرميهم هنا وننتهي منهم؟
– هكذا هي الأوامر، سيتم تصويرهم ليراهم سيادة الرئيس.
لو كنت سمعت هذه المحادثة في أول أيام اعتقالي، لربما ارتعدت فرائصي منها، ولكان وقعها على نفسي، أو نفس أي سجينٍ، كوقع الصاعقة، ولأصابني منها رعبٌ وخوف، فالسوق إلى الموت أمرٌ جلل، يهابه الجميع، لكنه اليوم أمر غابة في الاختلاف، إنَّه الخلاص في أجلى صوره، هكذا باتت الصورة واضحةً، وكما توقّعَها معظمنا، إنهم ماضون بنا إلى حتْفنا. يا مرحباً يا مرحباً.. هل يعقل هذا؟ أن تستجاب دعواتنا وننتهي من هذا العذاب اليومي الذي لا يطاق؟

- نعم هذا ما شعرنا به جميعاً، انتابني قشعريرة لطيفة سرت في كافة أنحاء جسدي، وشعرت بطمأنينة غامرة..
هو شعور يصعب وصفه، شعور أن تعرف أنك ستموت بعد قليل، شعور ما قبل الموت بلحظات، تعجز الكلمات عن التعبير عنه، فكيف بشعور الطمأنينة، بل حتى السعادة، التي لن تنالها إلا بالمرور من بوابة الموت!؟ لحظات لا تتكرر كثيراً في حياة الإنسان.
بتلقائية النفس المطمئنة، بدأنا نتلو صلواتنا وأدعيتنا، ونستعدّ في فرحٍ غامرٍ لاستقبال الموت وانتهاء البؤس والآلام.
كان يشوب هذا الحبورَ بعضُ الذكريات، التي بدأت دون استئذان تعدو عرباتُها في أخيلتِنا، وكأننا نودّع هذا العالم في غفلةٍ وانشغالٍ منه، تمرُّ حياتنا مثل شريطٍ سينمائيٍّ خاطفٍ، نتذكّر الأهل فرداً فرداً، والأصدقاءَ ورفقاء السجن، وليلةَ الاعتقال والأقبية الأولى، التي علّمتْنا كيف نبصر في أحلك الظلمات.
دقائق قليلة مرّتْ، قبل أن تتحرك الشاحنة والسياراتُ المرافقة لها مرة أخرى، لشدة ذهولنا في التطواف والتحليق في تلك اللحظات النادرة بين عالم الروح والجسد، والحياة والموت، لم نشعر كيف انتهوا وكيف ركبوا. سارت قافلتنا الصغيرة.
سلامٌ غامرٌ، وطمأنينةٌ ترين على الروح، ونحن نمضي في ساعاتنا الأخيرة، نودّع حياةً غيرَ مأسوفٍ عليها، ونمضي إلى ظلّ عدالةٍ سماويةٍ، كأننا ننظر إليها بقلوبنا. لم نكن نشكّ للحظةٍ واحدةٍ أننا سنُقتل ظلماً، وأن أسوأ مصيرٍ سينتظر قاتلينا لا محالة، إلّا أن حزناً شفيفاً لامس وجداننا، حزنَّنا على أهلٍ وأصدقاء سيُفجعون بقتلنا، وسيُفجعون برؤية قاتلينا وهم يتغطرسون أمام عجْزهم.
كانت الشاحنة تسير، والدقائق تمرّ دون أن ندرك ما يحيط بنا، فقد كنّا في ذهول عن عالم الأشياء والمحسوسات، ونحن ننتظر تلك اللحظات القليلة التي تفصلنا عن عالمٍ مشتهى، إنَّه عالمٌ خالٍ من التعذيب الصباحي ومن قلق الدقائق والساعات، ومع كلّ هذا تبقى للموت رهبةٌ لا ينْكرها إنسان.
شيئاً فشيئاً بدأنا نسمع أصواتاً كسرتْ رتابةَ الصمت التي ألفْناها في الصحراء، من الواضح أننا نمرّ بأحياء سكنية، ونسمع أصوات سياراتٍ وباصاتٍ تتحرّك، وأصواتَ بائعين جوّالين وأطفال. من الواضح أننا وصلنا إلى مدينةٍ لا نعرفها، لكنَّ هذا غير ما كنا ننتظره، فحقل الرمي في (سعسع) لا يكون هكذا أبداً!
توقفَت القافلة وترجّلَ الحرس، وسمعنا صوتَ حديثٍ وضحكٍ، إنهم يتحدثون عنا، سمعنا عبارات (حقراء.. محكمة) وأصواتَ بنادق، ثم ُفتح الباب وصرخوا بنا أن نتحرك، وأمسكوا بأوّلنا وتبعتْه بقية السلسلة ونحن نتعثر ويمسك بعضنا بعضاً، فما زالت أعيننا معصوبة.
دخلنا إلى مبنى يتردّد الصوتُ فيه وله صدى، صعدوا بنا أدراجَ طويلة، ثم أدخلونا إلى صالةٍ وأمرونا بالجلوس أرضاً، ثم حضرَ أحدُهم وقام بتحريرنا من السلسلة التي كانت تجْمعنا، وأبقونا مقيّدين إلى الخلف، وانصرفوا عنا، لكننا كنا نسمع حديثهم من الغرفة المجاورة، لقد تم نقلنا إلى الفرع العسكري في مدينة حمص، وهذا هو العميد “غازي كنعان” رئيس الفرع، يعطى أوامره للعناصر.
تقدم ضابطٌ وأبلغنا أننا سنُعرض فرادى على محكمةٍ عسكرية، كان هناك عنصر أمنٍ ينادي على اسم مَن تطلبه المحكمة، ويمسكه من يده بعد أن يفك قيده، مدْخِلاً إياه الى قاعةٍ، كنّا نتوهّم أنها قاعة محكمة، لكن الأمر الذي لم نجدْ له تفسيراً ساعتَها، أن الفاصل الزمنيّ بين الاسم والاسم التالي، لا يتعدّى ثلاثَ دقائق، وربما أقل!
حين نودي على اسمي سارعتُ للوقوف، فقبض العنصر على ذراعي وقادني إلى تلك القاعة، وهناك نزع عن عينيَّ العصابة السوداء فأبصرتُ، ويا لها من قاعةٍ مخيبةٍ للآمال، كأنك تتهيأ لمقابلةِ أسدٍ هصور، فلا تجدْ أمامك إلا هريرةً صغيرةً بالكاد تقوى على المواء! حجرةٌ صغيرةٌ مربعة لا يتجاوز طولها أو عرضها المتماثلان أربعةَ أمتار، ضعيفة الإنارة، ربما تعبر عن امتهان “غازي كنعان” رئيس هذا الفرع الأمني، لهذه المحكمة الميدانية الهزء.
وثمَّة طاولةٌ خشبيةٌ متوسطةٌ، نثرتْ عليها رزمتا أوراق بشكلٍ فوضوي، يجلس إليها ضابطٌ نحيلٌ يقطر اللؤمُ من عينيه وصفرةِ وجهه، وهو القاضي الذي يمثل المحكمة الميدانية، المتخصصة بمعتقلي تدمر، سنعرف اسمه فيما بعد، إنه “سليمان الخطيب” الذي مهرَ بقلمه خمسةً وثلاثين ألف حكْمٍ صادرٍ عنه بحقنا، ثلثا تلك الأحكام كانت الإعدام، وتمّ تنفيذ تلك الأحكام، وقبالته يجلس كاتبٌ ببزّة عسكرية رثةٍ بلا رتب.
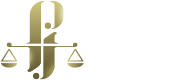
وحتى تكون تلك الأحكام نافذةً، ينبغي أن يوقع عليها القائد العام للجيش والقوات المسلحة، كما كان توصيف وظيفته العسكرية، وهو “حافظ الأسد” أو نائبه، ولأن القائد العام أذكى من أن يرتكب هذه الحماقة التاريخية، فقد أوكلها إلى نائبه وزير الدفاع “مصطفى طلاس” الذي لا يملك من أمره إلّا أن يمتثل صاغراً لأوامر سيده، وبرضى نفسٍ وطيْب خاطرٍ.
سيتبجح برعونةٍ غايةٍ في الإسفاف وهو يستعرض مذكراته ومناقبه فيها، فيذْكر أنه كان يوقّع ويصادق أسبوعياً على إعدام مئةٍ وخمسين سجيناً من الإخوان المسلمين.
يا للخزْي ويا لتعاسة هذا الشعب العنيد.. وزير دفاعنا لم ينتصر في معركةٍ واحدةٍ، ولا حتى في مكاسرة أيدٍ، لكنه انتصر على معتقلي تدمر، وأمر بسوْقهم إلى أعواد المشانق بالآلاف!
مثل هذا الخزْي لو لحقَ بضابطٍ نازيٍّ أو ياباني، لعمدَ من ساعته للانتحار دون تردّد، لكنهم وُلدوا وعاشوا وماتوا مجلّلين بالذلّ والعار، فأنّى لشريانٍ حيٍّ أن ينتفض في وجوههم!
ما أن دخلتُ حجرة المحكمة المزعومة، حتى بادرني “سليمان الخطيب” سائلاً:
– اسمك.. تولّدك.. اسم أمك.. اسم أبيك..
– محمد برو.. تولد 1963.. الأم مديحة.. الأب خالد
– أنت قرأتَ ووزعت مجلة النذير ومناشير لعصابة الإخوان المسلمين
– سيدي أنا لم …..
– خراس ولا حقير.. ولا كلمة.. أنت حكمك إعدام، تعا ابصم بإبهامك.
وبإشارة من طرف قلمه، أمسك بي العنصر الذي جلبني إليه، وكان واقفاً بمحاذاتي، وعصب عينيَّ من جديد وأعادني الى حيث كنت، مع أصدقائي الذين تمّتْ محاكمتهم. وحين رماني إلى الأرض نطقَ بكلمةٍ واحدةٍ (إعدام).. ليسمعها الذين يحيطون بنا من عناصر الفرع.
لم تنعقد المحكمة الموقّرة لأكثر من ساعةٍ واحدة، كانت جميع الأحكام الصادرة هي الإعدام، وأُقفلتْ الأضابير التي سيحملها القاضي العسكري “سليمان الخطيب” إلى وزير الدفاع ليصادق عليها. لكن وللأمانة التاريخية، فإن هذه المصادقة والتوقيع (الوزير دفاعي) ليسا على أيَّة درجةٍ من الأهمية، حيث من الممكن أن تُمهر بهذا التوقيع الشكلي بعد تنفيذ الإعدام.
بعد عدة أيام أعادوا عرضي على ذات المحكمة، وتقدم رئيس الفرع “غازي كنعان” ونادى من باب الصالة: جيبولي الحَدَث “محمد برو” “الحدث هو من لم يبلغ السن القانونية بعد”
فوقفت من ذات نفسي، أمسكَ بي من أذني وسحبني إلى حجرة القاضي قائلاً:
– ابن القحـة هذا…. لا يُعدم، إنه لم يبلغ الثامنة عشر بعد!
رمقني القاضي “سليمان الخطيب” بنظرة استخفاف:
– حدَث.. سوّدَ الله وجهك، خفّفنا لك الحكم إلى عشر سنوات! انقلع، نطقها بغضبٍ وهو أشبه بصيّادٍ أفلتت من قبضته طريدةٌ كاد أن يطْبق عليها.
مواد شبيهة:
حين أنسانا غازي الجهني رعب سلفه

 Eng
Eng