ما لفت نظري أن الحراس كانوا يصحبون أناساً منا، نحن الأهالي، ويعودون بهم بسرعة وهم يبكون! صرت أسأل نفسي إلى أين يأخذونهم هذا المشوار القصير؟ ولماذا يرجعون باكين؟!
13 / آب / أغسطس / 2020

*المصدر: رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
اليوم 22 آذار. في مثل هذا التاريخ من عام 2012 اعتقلوا أخي نايف. كان في منزلنا. ودّعني أنا وأمي وابنتي وقال إنه سيراجع الفرع الذي استدعاه ليعرف ما يريدون منه، بعدما حصل على ضمانات أن الموضوع مجرد “سؤال وجواب”، ويعود إلى منزله. حاولنا معه كثيراً ألا يذهب. كنت قد رتبت له، بالتعاون مع ضباط منشقين، أمر الخروج إلى الأردن، ولكنه رفض.
ذهب إلى فرع الدوريات بالكسوة. كنا نتصل به بشكل متواتر وكان يرد. في التاسعة مساء صار هاتفه خارج التغطية. اشتعلت النار في قلوبنا ولم نعد نعرف عنه شيئاً.
كانت أول زيارة له بعد اعتقاله بحوالي سبعة أشهر، أمّنها أخي الثاني سامر عن طريق إحدى الشخصيات النافذة. ذهبت أمي وسامر وقتها. كان قد نحف قليلاً لكن وضعه كان لا يزال مقبولاً. استطاعت أمي أن تؤثر على أحد الحراس ففتح الشبك وحضنته. همس في أذنها بشيء لم تلتقطه بسبب شدة بكائها.
عبر الشخص نفسه الذي كان أخي سامر قد توسّطه سابقاً استطعنا الحصول على إذن ثان بالزيارة. سررت أنني سأراه أخيراً. اشتريت له بعض الأغراض. قياسات متعددة من البيجامات والملابس الداخلية، فأنا لا أعرف الآن جسمه، لكن ما لن يستخدمه سيحتاجه معتقل آخر. اخترت الأنسجة الصوفية لتبعث الدفء، والألوان الداكنة ليتمكنوا من غسيلها.

في 27 آذار 2014 وضّبنا الأغراض وخرجنا باكراً، أمي وسامر وأنا. كانا يحاولان أن يعدّاني نفسياً لما سأراه، ويخبراني أنه سيكون نحيفاً ومختلفاً عن الشخص الذي أعرفه، وأن عليّ ألا أُصدَم. حاولت أن أرسم في ذهني صورته بناء على هذا الكلام، لكني لم أتخيل إطلاقاً الذي رأيته، فقد كان أسوأ من أشد مخاوفي.
عندما وصلنا إلى السجن كنت أحس أن الجبال تصرخ. كان الهواء يهب بارداً ورغم ذلك يلفك الشعور بالاختناق. قحط، جفاف، مكان موحش. جمعونا في باحة، كل الأهالي، وعيوننا تطير إلى الشبابيك؛ ابني وراء أي منها؟!! كانت وجوه العساكر تقطر سواداً، وكنت أفكر: هؤلاء من يحيطون بأخي؟
كان أمراً مؤلماً للغاية، ومتعباً بالذات لأمي المتقدمة في السن بلا كرسيٍّ تجلس عليه. بالكاد استطاعت الجلوس على طرف حجَرة. مرّ وقت طويل ونحن بالانتظار، فأخرجتُ إحدى قطع الملابس التي جلبتها لأخي ولبستها. قلت عسى أن يشمّ رائحة أحد من أهله فيها!
نادوا على الأهالي أن يدخلوا. بعد طول جلوس على طرف الحجر الواطئ لم تتمكن أمي من النهوض مباشرة فقال لها أحد الحراس: “خلص خلص خليكي!… إذا مانك مستعجلة لتشوفي ابنك ارجعي عالبيت!”. قلنا له: “طوّل بالك… مرة كبيرة وبالزور عم تتحرك… نشفوا رجليها من القعدة. طوّل بالك عم نساعدها”.

أنهضنا أمي وأدخلونا إلى صالة كبيرة تشبه صفاً مدرسياً؛ فيها مقاعد ولوح وشبابيك مكسورة. وبدأوا بتفتيش الأغراض ليحددوا المسموح منها والممنوع. قلنا لأنفسنا إن أي شيءٍ يصل إليه سيكون جيداً.
طال الوقت هنا أيضاً. في الساحة خارجاً قضينا حوالي ساعتين، أو ربما أنني قدّرت ذلك لأنني شعرت أن الزمن يمرّ ببطء. وفي الداخل انتظرنا ساعتين أيضاً.
ما لفت نظري أن الحراس كانوا يصحبون أناساً منا، نحن الأهالي، ويعودون بهم بسرعة وهم يبكون! صرت أسأل نفسي إلى أين يأخذونهم هذا المشوار القصير؟ ولماذا يرجعون باكين؟!
جاء دورنا فنادوا علينا. كان سامر يسند أمي التي لا تستطيع أن تسير بسرعة وتصعد الدرج، أما أنا فكنت أقفز درجتين درجتين عسى أن أرى أخي لمدة أطول من الدقائق الأربعة المقررة.
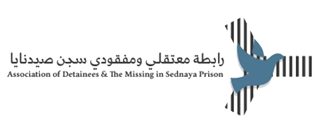
دخلت إلى مكان، على اليمين شبك مقسوم إلى ثلاثة أقسام. وراء كل شبك شخص، لكنهم جميعاً كانوا غرباء. ناداني أحد الحراس لأسلّم الأغراض التي معي عنده في صدر الغرفة. قلت: “ولكن أخي ليس هنا!”. أخذ مني الأغراض وقال “روحي لهنيك”. التفتُّ إلى الخلف فرأيت أمي تقف وراء الشبك الثاني. ذهبت إليها دون أن أقتنع، فقد تفحصت السجناء منذ قليل ولم يكن نايف بينهم! تفرّست في الواقف وراء الشبك فلم أعرفه، التفتُّ إلى أمي فوجدتها تبكي! أعدت النظر إليه من جديد: من هذا؟! ما بها أمي؟ هل جنّت؟ كانت تقول: “كيفك يا أمي؟”… قلت لها: “هاد مو أخي! مع مين عم تحكي أنت؟!”.
فجأة… أحسست أن الأرض خسفت بي والسماء انطبقت عليّ! شعور مريع ذاك الذي جاءني وأنا أقلّب النظر بين أمي و”أخي”. من المستحيل ألا يعرف المرء أخاه!
كان هزيلاً جداً. شعره يشبه شعر الأطفال أول ولادتهم، شيئاً كالوبر، كالشعر الواهي على بطن القطط! في مقدمة فمه يبدو فراغ خلّفه سنٌّ قد سقط. وعيونه تحملق في السقف! لم يكن ينظر إلينا، لم يكن معنا، كان في عالم آخر! ويداه وراء ظهره.
نظرت إليه. لم يكن فيه من نايف الذي أعرفه أي شيء! ولا أي شبه! لم تغادرني القناعة بأنه ليس أخي وأن أمي تاهت وأنها تحادث شخصاً غريباً. حاولت كثيراً أن أنظر إليه كأخي أو أن أحادثه فلم أستطع إطلاقاً.
فالتفت هو إليّ وسألني عن ابنتي داليا! إنه هو! أخي!
كان جوابه على كل أسئلة أمي وأخي سامر هو: “الحمد لله”.
“شبك؟”…
“الحمد لله”…
“شو صاير فيك؟”…
“الحمد لله”…
“لك شو الحمد لله؟!!”…
يسأله أخي: “شبك أخي؟ شو صاير معك؟”
فيجيب: “الحمد لله… الحمد لله”.
سألته أمي: “شبك ابني؟ ليش إيديك ورا ضهرك؟ إيدك مقطوعة شي؟” فصاح به الحارس: “مد إيديك خليها تشوفن!”. ببطء وتثاقل استطاع أخي أن يرفع يديه من وراء ظهره ويمدّهما ثم أعادهما إلى الخلف. كم عذّبوه حتى وصل إلى هذه الحال! كم كسروه! أولاد الكلب!!
الزيارة التي استمرت لأربع دقائق فقط كانت دهراً… دهراً من العذاب والقهر. عندما استدار ليذهب لاحظت أن بنطاله يسحل عن جسمه ولم تكن لديه القدرة على رفعه. شعرت أن رجليه حبلان ذائبان. وكنت أتخيل كم سيضربونه الآن، لأني سمعت أنهم يضربون المعتقل إثر الزيارة.
عندما خرجنا قالت أمي: “أخوكن مو مطوّل… لاقوا أي طريقة لتطالعوه!”. لم أترك باباً لم أطرقه، ولا صوتاً يمكن أن يصل، ولا محاولة يمكن تجريبها.
بعد شهر تماماً، في 27 نيسان، استشهد. ارتاح. أنا ارتحت! لأنه لم يعد بين أيديهم الآن، ولم يستمر في المعاناة التي كان فيها.
لكن وجعه ما زال يحرقنا، وطالما أن من قتله ما زال يقتل سواه، ولم يشعر بالذنب الذي فعله ولا كيف جرحنا ودمّر حياتنا. لا أنا ولا أمي يمكن أن نستعيد حياتنا السابقة. تغيرت حياتنا بعد هذه الدقائق الأربع. تغيرت بعدما رأينا كم قُهر أخي وتألم وظُلم.
في وجه من نصرخ؟ لمن نشكو؟ إذا كانوا فعلوا هذا بقاض يمثل العدل!

علمنا باستشهاده في 6 أيار، عن طريق الشخص نفسه الذي أمّن لنا الزيارة. اتصل بأخي وقال له: “يمكن أخوك فيه شي. روح اسأل عنه بالشرطة العسكرية”. عندما ذهب سامر وسألهم: “صحيح أخي توفى؟” اهتموا فقط بمعرفة كيفية وصول الخبر إليه! وفي النهاية قالوا له: “روح روح… هاد مات من تسعة أيام ودفنّاه”. بهذه البساطة! قالوا إنه كان مريضاً بالسل.
في عام 2015 استطاع بعض المعتقلين، الذين خرجوا نتيجة عفو، التواصل معي كما كان أخي قد أوصاهم. فرأيتهم وحكوا لي ما حصل له في السجن بالتفصيل.
الأهم أنهم قالوا لي ماذا همس في أذن أمي في الزيارة الأولى. كانت تلك حرقة في قلبها لأنها لم تستطع سماع كلامه ذلك اليوم. كان قد قال: “يا جبل ما يهزّك ريح”.
صحيح أنهم كسروا الجبل ولكن يكفي أنه دخل السجن مؤمناً بفكرة الحرية، واستشهد وغادر إلى ربه وهو مؤمن بها، ولا أعتقد أنه ندم يوماً على خياره.
بدأنا بتجهيز مراسم العزاء في بيت والدتي فاقتحمه الشبّيحة ومنعونا! إذ كيف سنتلقى العزاء في شخص “خائن… مات في السجن”!!
لقراءة مدخل وأجزاء الكتاب

 Eng
Eng