بعد مدة أصابتني الهلاوس أنا الآخر ولم أعد أميّز من حولي. اعتنى بي محمد قسوم رحمه الله، سمعت بعد خروجي من السجن أنه استشهد.
09 / آب / أغسطس / 2020

*المصدر: رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
أخذونا إلى الفرع 248 برسم الإيداع. كنا نسمع أن ذلك يستغرق يوماً أو اثنين قبل التحويل إلى سجن صيدنايا، لكننا أمضينا فيه شهراً وبضعة أيام. كانت أياماً شديدة القسوة إلى درجة أننا صرنا نحلم بالتحويل إلى صيدنايا، أو نتمنى العودة إلى الفرع 293 حيث كنا. صحيح أننا تعرضنا فيه للضرب والتحقيق إلا أن الاحتجاز في المنفردات دون أي كلمة كان أمراً صعباً للغاية. عندما أخرجونا في النهاية لم نكن نستطيع الرؤية بشكل طبيعي بسبب اعتياد عيوننا الظلام.
إلى صيدنايا
تحقق “حلمنا” أخيراً بالتحويل إلى صيدنايا. قيدونا بالكلبشات وسلسلونا في جنزير، كنا حوالي 25-30 شخصاً، واقتادونا إلى السيارة المغلقة (براد اللحمة) وكأننا غنم. طول الطريق ونحن نتمنى أن تحدث معجزة فتنقلب بنا السيارة ونموت أو نتمكن من الهرب، لكنها لم تحدث. كنا نسمع أصوات السيارات ونفكر كيف أن الناس يمارسون حياتهم الطبيعية.
وصلنا إلى صيدنايا. لم نر شيئاً من السجن ونحن في قلب البراد. حتى أنزلونا في ساحة ثم أصعدونا درجتين وأدخلونا إلى بهو كبير. أمرونا أن نحني رؤوسنا فلم نر ملامح أحد منهم. أجروا التفقد على الأسماء بالتوازي مع أضابيرنا المرفقة. أمرونا أن نخلع جميع ملابسنا ثم أخذوا بضربنا منذ حوالي الثانية عشرة ظهراً إلى قرابة الخامسة مساء ونحن عراة.

بعد ذلك صاروا يوزعوننا على مجموعات تضم كل منها 7-8 سجناء. أنزلونا حوالي 20 درجة في الظلام والأرض مبتلة وأصوات الضرب مسموعة. أعادوا بطحنا على الأرض وكرروا ضربنا ثم أدخلوا كل مجموعة إلى منفردة لا تتجاوز المترين طولاً و170 سم عرضاً، وفيها مرحاض صغير. بعدها أخذ السجان ينادي أسماءنا واحداً تلو الآخر، يسأل كلاً منا عن تهمته ويصفعه بشكل مدوّخ ثم يعاقبه بالفلقة التي تستمر حتى يفقد المرء سيطرته على جسده.
تركونا في المنفردات. لم نكن نعرف نظام السجن فظننا أننا سنقضي حياتنا المتبقية كلها هكذا. كان البرد شديداً والأرض مبتلة ولا توجد بطانيات. وكان الطعام قليلاً ولا يوجد ما نملأ به أمعاءنا سوى الماء. كان سجاننا يرمي لنا الطعام رمياً فيأكله من اشتد به الجوع. وكان يضربنا يومياً بحجة إصدار الأصوات أو دون حجة على الإطلاق.
في المهجع
في أواخر الشهر الثالث من عام 2012، بعد حوالي 11 يوماً، أخرجونا من المنفردات وصعدوا بنا درجات كثيرة ونحن في غاية الإنهاك، ووسط الضرب. وصلنا أخيراً إلى مهجع لا يحوي أي شيء. أدخلونا. ودون أن نرى وجوههم قالوا: “بتقعدوا هون وأكلكن بيوصل لعندكن. صوت ما في وهمس ما في”. علمونا الوضعية التي يجب أن نتخذها عند دخول السجانين؛ وهي أن تجلس جاثياً ووجهك إلى الجدار ويداك خلف ظهرك. بعد قليل رمى أحدهم لنا بأربع صابونات وقال: “عرصات.. تحمموا”. وبعد قليل رموا لكل منا بطانيتين عسكريتين كريهتي الرائحة جداً. تشارك كل اثنين بطانياتهم؛ واحدة على الأرض وثلاثة لنتغطى بها. بعد ما عانيناه في الأسفل شعرنا هنا أننا في الجنة!
في اليوم التالي وزعوا علينا الفطور، بيضة كاملة للشخص! وكمية كافية من الخبز. كان الغداء من البرغل الذي أشعرنا بالشبع بعد جوع طويل.
بعد عدة أيام دخلوا علينا فجأة وأشاعوا جواً من الرعب. طلبوا من الذين يرتدون ملابس عسكرية أن يخلعوها ورموها خارجاً، ثم ضربونا جميعاً بالدولاب. وصاروا يكررون هذا الأمر كل أسبوع.
عينوا العقيد السجين نضال الحاج علي رئيساً للمهجع، وكان عليه أن يقدم ثلاثة أسماء “مخالفين” يومياً، أو أن يتبرع اثنان أو ثلاثة لتلقي العقوبة التي يجب أن تكون يومية.
كان رئيس الجناح مساعداً شديد السمرة، طوله 170 سم وبجسم ممتلئ، أسميناه “الديري” ثم عرفنا أنه من منبج بريف حلب.
مرت الأيام وصرنا نتجرأ أن نتجمع في الزوايا ونتكلم همساً. وإن فتح أحد الشرّاقة علينا نلتفت فوراً إلى الحائط.
بعد مدة بدأ الطعام يسوء. وبعد أشهر من دخولنا المهجع أخذ التعامل معنا يصبح أشد. كما دفعت الظروف المحيطة إلى ظهور بعض الخلافات شديدة السخف بين المعتقلين.
دخلوا علينا ذات يوم وقالوا إنه بإمكاننا شراء المنظفات عبر ما يسمونه بلغة السجون السورية “الفاتورة”، أي أن ندفع نحن ثمنها المبالغ فيه من النقود التي نملكها في الأمانات. تبرعنا وصارت عندنا حتى فراشي الأسنان والمعجون. ثم سمحوا لنا بشراء “فاتورة” أدوية. كان أمراً جيداً أن نأخذ الأدوية بأنفسنا دون الحاجة إلى الطبيب الذي كنا نتشاءم من قدومه، فقد كان علينا أن تكون عراة تماماً عند دخوله. كانت هناك إمكانية للتسجيل للذهاب إلى المشفى لكننا لم نكن نجرؤ. في إحدى المرات ذهب أحدنا ولما عاد قال إنه أوقف في “نظارة” المشفى ثم أعطوه ظرفين من حبوب الالتهاب وظرفين من المسكن دون أن يعاينه أحد.
- ورغم ذلك كله، تلك كانت مرحلة من “الدلال”!
الموت
صارت المياه تنقطع، أحياناً لسبعة أو ثمانية أيام متوالية، فصرنا نقننها. وبدأ الطعام يقل، وصار السجان يرميه علينا. أخذ السجناء يمرضون ويموتون بعد أن تراجعت مناعة أجسادهم.
في 2013 صار الضرب يومياً، وكان مبرحاً جداً، وصارت الدماء على الجدران. أول من استشهد أمامي كان خليل علوش من درعا، مقدم في الجيش بجسم رياضي. دخلوا في إحدى المرات فتكلم. ضربوه فكسروا كتفه ويده. في الصباح نقلوه إلى المشفى حيث تلقى ضرباً على كليتيه أعاده أسوأ مما ذهب. ورغم مرضه البادي كانوا يدخلون ليضربونه. بعد عودته من المشفى بيومين أو ثلاثة مات.
مرض الملازم أول عبد العزيز سويد من كفرنبل، وكان رئيس مهجعنا الآن. أخذ يهلوس لمدة شهر وأثناء ذلك كانوا يضربونه. كان المرضى يتعرضون الضرب أكثر من الباقين بسبب ما يصدر عنهم من “مخالفات”! كان عبد العزيز طويلاً ذا جسم جيد قبل أن يضمحل. في هذه المرحلة كان أثقلنا وزناً لا يتجاوز 50 كيلوغراماً. عندما مات وضعوه إلى جانبي. كانوا قد سحبوا البطانيات واللباس. كنا عراة بالكامل. وشعرت بالانهيار.
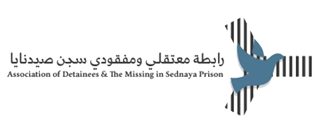
انتشر الجرب وأخذنا بالحك حتى ينزف الدم. اشتد عليّ الجرب لدرجة أنني تجرأت وأجبت عندما سأل الرقيب عمّن أصيب بالجرب بيننا. أريته جسمي المحفور من شدة الحك وطلبت دواء فأحضر لي علبتين من البنزوات وعشرين حبة التهاب. سألني إن كنت أعرف طريقة استخدامها فقلت لا. أرشد أحد زملائنا المساجين إلى أسلوب التدليك المترافق مع الاستحمام بالماء البارد. قلت له إنني لن أنسى له هذا المعروف. صرنا نطلب منه الخبز والأدوية. وكان يعاملنا بشكل جيد نسبياً. بعد مضيّ شهر لم نعد نسمع صوته وعلمنا أنه نقل.
بعد مدة أصابتني الهلاوس أنا الآخر ولم أعد أميّز من حولي. اعتنى بي محمد قسوم رحمه الله، سمعت بعد خروجي من السجن أنه استشهد.
في أحد الأيام نادوا باسم أحمد خالد طرية وسألوه من أين هو فأجاب من الرستن. أمروه بالبصم على ورقة لا يسمحون له بقراءتها. كان هذا السلوك مألوفاً ولم نكن نعرف ما تحويه هذه الأوراق. كانت وجوهنا نحن المتبقين إلى الحائط ولم نعرف أنه ضربوه. بعد أن يخرجوا بدقائق تستطيع الالتفات ثانية وفق التعليمات. عندما استدرنا وجدناه على الأرض فظننا أنه متعب أو مريض، لكنه كان ميتاً.
في المحكمة
بعد أن دخلنا بحوالي 3 أشهر بدأ العرض على المحاكم والزيارات. كانت مدة الزيارة 3 دقائق. وكنا نسأل العائد منها ونؤول أي كلمة قالها الأهل بقرب الإفراج عنا أو سقوط السجن بيد مقاتلي الجيش الحر.
أما الذين يعودون من المحكمة فيكونون قد تعرضوا لضرب شديد، كما كانوا يحملون معهم درجات أشد من الجرب الذي كان منتشراً في سجن الشرطة العسكرية في القابون.
ظللت لمدة سنة ونصف مخفياً قسرياً لا أحد يعرف عني أي شيء، حتى عرضت على المحكمة. نمت ليلة هناك. كان طول الغرفة خمسة أمتار وعرضها أربعة تقريباً، وكانت تحوي حوالي 200 موقوف يتكومون فوق بعضهم ويتناقلون الجرب والقمل.
في اليوم التالي أُدخلت على القاضي الذي أمر برفع الطماشة عن عيني ثم سألني عن التهم الإحدى عشرة الموجّهة لي فأنكرتها كلها. قال: “انقلع ولاك” ففعلت.
الزيارة
بعد شهر جاءتني زيارة لأول مرة. كنت قبلها أحلم بالزيارة وأمثّل أمام زملائي في المهجع كيف أمشي إلى الباب للذهاب إليها. كانت الزيارات في أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. ذات ثلاثاء دخل السجان ونادى اسمي. قال “ارفع كنزتك لتغطي رأسك” ففعلت. “امشي ولاك” فمشيت. لمّوا حوالي 6 أو سبع سجناء من الأجنحة لديهم زيارات وأوقفونا في بهو كبير تلتقي عنده الأجنحة. عرفت الآن أننا في الطابق الثالث.
كانت زيارتي في 7/7/2013. أنزلني الرقيب “الآدمي” نفسه. اكتشفت حينها أنه نقل إلى جناح آخر لا خارج السجن. قبل الزيارة يحلقون للسجناء. جُرحت شفتي أثناء ذلك وتلقيت صفعة. أدخلونا إلى صالة كبيرة جداً بالانتظار. كان عليك أن تبقى جاثياً وكلما هممت بالجلوس على الأرض تأتيك الضربة أو الركلة لا تدري ممن. استمر الوضع كذلك من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً. شعرت أنني أموت. نودي على اسمي في نهاية الأمر وقيل لي أن أعيد الكنزة إلى وضعها الطبيعي.
في غرفة الزيارة أمامك شبك معدني، وآخر أمام الزائرين، وبينهما ممر صغير يمشي فيه أحد الحراس، بينما يقف آخر وراءك. عندما رأيت أسرتي أخذت بالبكاء بحرارة. شاهدت زوجتي وبنتيّ؛ سنا ونهيدة. أحب هذا المشهد كثيراً وأحب استرجاعه بشغف، رغم أنه يدفعني إلى البكاء في كل مرة. لم أعرف البنتين على طول المدة التي تركتهما فيها ونموهما. هل عرفت ما الذي دفعني إلى رفض أن أتحدث أول مرة؟
ظننت أن ابنتي الصغرى هي الكبيرة كما تركتها، أما الكبرى فلم أعرف من هذه! صرت أرجو الصغيرة أن تكلمني قائلاً لها: “أنا بابا يا حبيبتي يا روحي” لكنها لم ترد. كان عمرها عدة أشهر عندما تركتها. كان الإرهاق الشديد يبدو على وجه زوجتي.
انتهت الدقائق الثلاث المخصصة. ودعتهم وأنا أبكي فسألني أحد السجانين: “ليش عم تبكي يا عرصة؟”، وأخذ بضربي!
بعد الزيارة أعطوني كيساً يحوي منشفة وغيارين داخليين فقط. كان من المستحيل أن تجلب العائلة أغراضاً قليلة كهذه بعد كل هذه المدة. علمت في ما بعد أنهم أحضروا لي ثلاث بيجامات من نوعيات جيدة وكمية كبيرة من الملابس الداخلية وأغراضاً أخرى. لقد أخذها “أولاد الحرام”.
صعدت الطوابق وأنا متعب. كنت قد تناسيت أسرتي قليلاً خلال المدة الماضية، أما الآن فصرت أتخيلهم وأنتظر الزيارة التالية التي قال بعض زملائنا في المهجع إنها ستتاح لأي سجين كل ثلاثة أشهر. صرت أعدّ الأيام بل الساعات. مرّت هذه الشهور وكأنها سنوات.
الإعدام والعقوبات
في هذه المرحة تفشى الجرب وكان الطعام قليلاً وزاد الموت. صار السجانون يذيعون أسماء المنشقين ويقتادونهم إلى مكان مجهول، للإعدام بالتأكيد. نقص عددنا فنقلونا إلى مهجع آخر. أصبح أحدنا مسؤولاً عن توزيع المياه كي تكفي الجميع. ونظمنا دوراً نتناوب فيه اثنين يومياً “سخرة” لتنظيف المهجع ومسحه إن توفر الماء. ثم شكلنا “محكمة” لحل المشكلات التي أخذت تحصل بيننا نتيجة قلة الطعام والشراب. كان السجناء يتبادلون الضرب أحياناً، ولو وصلت أصواتهم إلى السجان كان يضرب جميع أفراد المهجع لليلة كاملة، أو قد ينزلنا إلى المنفردات.
تزايدت عقوبات السجانين بسبب ودون سبب. كان الحرمان من البطانيات متكرراً. وقد يدخل السجان فيأمر رئيس المهجع أن يسكب علينا الماء البارد، أو يصدر إيعازه: “الذراعين جانباً رفع” فنبقى هكذا ليوم أو يومين ربما، وأثناء ذلك يحضرون الطعام كالعادة ويضعونه وسط المهجع دون أن يسمحوا لنا أن نقربه!!
كيف كنا نعيش
عانينا من نقص شديد في السكريات فصارت الحلويات تراودنا أثناء النوم. منذ خرجت وأنا مغرم بالأكل!
سأحدثك كيف كنا “نطبخ”. لا تذهب بأفكارك بعيداً فليست لدينا أي إمكانية للطبخ المعروف. كنا نستعيض عن ذلك بالخيال. نتجمع ثلاثة أو أربعة فنتهامس عن طريقة طبخ الرز، أو البامية، وأحياناً الحلويات!
كنا نصلي جماعة رغم أن ذلك ممنوع. في أسفل الباب شبك معدني مخرّم وكان أحدنا يجلس للمراقبة وتنبيهنا إن جاء أحد. في إحدى المرات أحس السجانون أن أربعة يصلون جماعة فانهالوا عليهم بضرب لم يستطيعوا بعده الوقوف لمدة شهرين، كما احتجزوهم في حمام المهجع لأيام.
لم نكن نعرف الوقت، فلا أحد منا يحمل ساعة بالطبع. كنا نقدّر وقت صلاة الفجر من يقظة العصافير.
صارت آثار الدماء على الجدران. كنا نضمد جراح بعضنا بخرقة قذرة إن وجدت. لم يعودوا يحضرون أي نوع من الدواء. وصارت معاملتهم لنا سيئة جداً. لم يعد أحد منا يجرؤ على التطوع كرئيس للمهجع لشدة ما يتلقى من ضرب وركل، فتناوبنا على هذه المهمة.
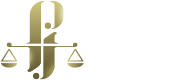
نشأت بيننا عمليات مقايضة، فمثلاً لو ملكت نصف رغيف زائد عن حاجتي كنت ربما أشتري به زيتوناً من سجين آخر. فصاروا يفتشون المهجع وإن وجدوا زيتوناً كانوا يرمونه في الخارج ويقولون: “عم توفروا؟ يعني الأكل اللي عم يجيكم زيادة عليكم؟”.
صاروا يحرمون بعض المهاجع من الطعام كيفياً أو ليوفروا على أنفسهم عناء التوزيع. حُرمنا في مرات، وفي أحد الأيام أعطونا كل حصة الجناح، المكون من عشرة مهاجع، وحرموا الآخرين. على كل حال كان الطعام المخصص للجناح يكفي مهجعاً واحداً.
- خصصنا اثنين منا يومياً لتوزيع الطعام. وكانت الخلافات تدور حول حجم الحصص.
في أيام رمضان أو العيد كنت تستلقي على المساحة المخصصة لك، والتي تتراوح بين البلاطة وربع والبلاطة ونصف حسب العدد؛ فترى من على يمينك يبكي. تلتفت إلى الجانب الأيسر فترى الآخر يبكي أيضاً. فنهمس “يا الله”!
جمعنا عجو الزيتون وصرنا نلعب الضامة والشطرنج بمربعات رسمناها على قميص داكن. فاجأنا السجانون مرة ورأوا ذلك فضربونا حتى الموت.
بعد دخولنا إلى السجن بشهرين أو ثلاثة صاروا يأخذوننا إلى الحمام داخل الجناح عراة. هناك يُدخلون كل سبعة أو ثمانية سجناء إلى إحدى غرف الحمام سوياً ويفتحون عليهم ماء مغلياً يسلخ الجلد. وفي طريق الذهاب والعودة لا يتوقف الضرب بينما كنا ننزلق بسبب ضعف أجسادنا ووجود المياه على الأرض ونحن حفاة. من يقع يتناولونه بالضرب بالأنابيب البلاستيكية الخضراء. كنا نعود من الحمام جرحى.
الزيارة الثانية
مرت الشهور الثلاثة وأذيع اسمي للزيارة في يوم أحد. أخذوني، بعد أن ضربوني بشدة طبعاً. دخلت إلى الغرفة فرأيت أبي وشقيقتي وزوجتي وبنتيّ. كان والدي قد قارب الثمانين، وطلب من رئيس الجناح أن يعتني بي لأنني بريء فأجابه: “تكرم يا حجي”. كانوا يُظهرون اللطف أمام الناس. كانت الزيارة تستلزم من عائلتي الإقامة لعشرين يوماً في دمشق بين تقديم الطلب ومتابعته لدى الجهات المختلفة حتى الموافقة عليه، وكانوا يستأجرون منزلاً لهذه المدة أو يقيمون عند بعض الأقارب. كان ذلك مرهقاً جداً لهم ومكلفاً. وكل ذلك مقابل ثلاثة دقائق فقط.
سألتني زوجتي: “لماذا ترتدي ملابس الزيارة السابقة نفسها؟!”. لم أدر بم أجيبها فقلت: “هيك أحسن”. التفتتْ إلى السجان وسألته: “أين الملابس التي أحضرناها له في المرة الماضية؟ لماذا لم تعطوها له؟”. يا للورطة! استدار السجان محوّلاً السؤال لي فأجبت بسرعة: “ثيابي فوق، ولكن ما أرتديه الآن أريح لي”!
كلفني هذا الحديث ضرباً أشبه بالموت الأحمر بعد الزيارة وهم يقولون: “بدك تياب جديدة يا ابن العرصة؟!”.
هذه المرة أعطوني كيس الأغراض وقد سرقوا الملابس المشتراة حديثاً فقط، وتركوا ما أحضرته زوجتي من ملابسي من المنزل.
أصبت بالصداع الآن. كم يتحمل الإنسان! كيف مر علينا كل هذا؟!!!
لقراءة مدخل وأجزاء الكتاب

 Eng
Eng