فُتح باب الزنزانة. أخذت الوضعية جاثياً وأنا خارج من المرحاض. دخل طبيب وسأل عمّن كان يصرخ فأبلغه الشاويشية أنه أحد الذين ماتوا. كان يمنع قتل المرضى، فهو طبيب في النهاية، لكن المساعدين والعساكر هم من ابتدع نظام التصفية كي لا يبذلوا جهداً في جرّ المحتضرين والضعفاء إلى المشفى.
25 / آب / أغسطس / 2020
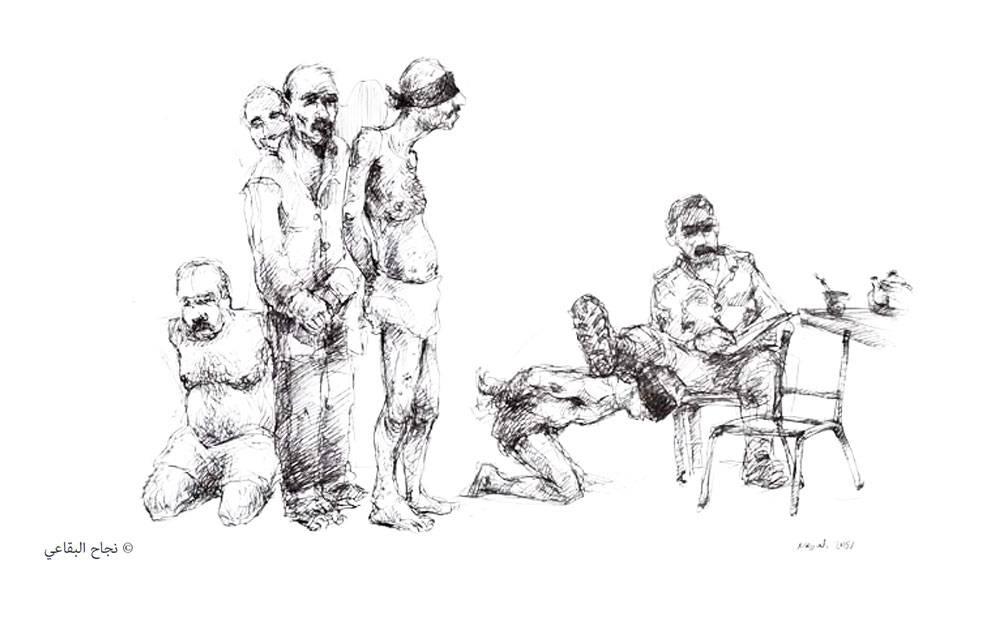
*المصدر: رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا
قبل أن أبدأ بسرد قصتي أتمنى من أي إنسان يستطيع أن يفعل أي شيء للمعتقلين ألا يقصر في ذلك أبداً، لأن وضع المعتقلين في السجون السورية سيئ للغاية وصعب جداً. من يركز على أن النظام يقصف السوريين ويقتلهم محقٌّ بلا شك، لكن ذلك جزء بسيط من الظلم الذي يمارسه داخل السجون حيث تجري أشياء مريعة لا تُصدّق ولا يمكن أن يتخيلها العقل. أتمنى أن نتمكن من إيصال الصورة الحقيقية وألا يتهمنا أحد بتضخيم الأمور، إذ يصعب على أحد الاقتناع بأن ما سأسرده موجود فعلاً، ولذلك سيعتقد البعض أن كلامي مجرد وهم. وفي الواقع أننا مهما قلنا لن نستطيع تجسيد صورة ما يجري إلا لمن عاشها.
الاعتقال والتحقيق
كنت قد تجاوزت ستة عشر عاماً من عمري، حائزاً للتو على شهادة الثانوية العامة بمعدل 90%، عندما اعتقلتني إحدى المفارز. كان نمط الحياة الذي رباني عليه والدي هو المدرسة شتاء ومعهد القرآن الكريم في الصيف، فكانت معرفتي بالعالم الخارجي تساوي الصفر. كنت قد شاركت في المظاهرات ضد النظام في منطقتنا ولكنني بعيد تماماً عن السلاح ولا أجيد استخدامه. وبسبب أن عدداً كبيراً من أقاربي شاركوا في العمل المسلح تم اعتقالي في 27 آب 2014.
حُوّلت إلى فرع الأمن العسكري في محافظتي وهناك صاروا يوجّهون لي تهماً أسمع بها لأول مرّة؛ من أنني قمت بضرب حاجزين لجيش النظام وزرع عبوة ناسفة استهدفت ضابطاً. لم تكن لي علاقة بكل هذا ولكن مسيرة الاعتقال العشوائي معروفة؛ إما لأنك لم تعجب العسكري أو بسبب تقرير يكتبه أحد المخبرين لإحدى الجهات الأمنية لسبب شخصي. ثلاثة أرباع الذين صادفتهم في المعتقلات لم تكن لهم علاقة بالثورة لا من جهة المظاهرات ولا في التسليح. ولم أقابل مسلحين إلا من “الشبيحة” الذين كانوا يقاتلون في صف النظام فتجاوزوا حدوداً معينة مما أدى إلى سجنهم. أما من مسلحي الثورة فلم أقابل في المعتقل إلا نادراً.
في الفرع قال من استلمني: “اخلع ثيابك” فخلعت الكنزة حتى أمرني بخلع البنطال. كان الوضع الذي يجلس فيه المعتقل هو الوضعية العسكرية “جاثياً” التي لم أكن أعرفها ببساطة. صار يصيح: “جاثياً… جاثياً” وأنا لا أعرف ما الذي عليّ فعله. أخذ يضربني فقلت: “قل لي كيف أتصرف وسأفعل… لماذا تضربني؟”. فأجاب: “أوَتردّ في وجهي أيضاً!” وعاود ضربي. أمرني بخلع ملابسي الداخلية فلم أستوعب الأمر! كان الأمر جديداً وغير معقول لي، لكنني استجبت في النهاية من شدة الضرب. أحسست بالخجل الشديد والانزعاج عندما كشفت عورتي، بينما كان مشغولاً بتفتيش ملابسي.
قادني أخيراً إلى مكان مجهول سأكتشف أنه المنفردات في الأسفل. أُدخلت إلى “المنفردة” فيها شخصان قبلي؛ أحدهما منذ 47 يوماً والآخر منذ 13. كانت مساحتها متراً ونصف طولاً، ومتراً واحداً عرضاً، وفي آخرها حنفية وحفرة مرحاض. كان هناك صحن أو طاسة لجميع الاستعمالات؛ يضعون فيه الطعام ويستخدم للشرب كما للغسيل بعد قضاء الحاجة. لم أستطع أن آكل أو أشرب منه ليومين بسبب ذلك، وبعد ذلك لم أجد حلاً وتنازلت مضطراً.
بينما كنت أنتظر دوري في التعذيب، في أول أيامي هنا، سمعت صوت امرأة يجري تعذيبها وهي تصرخ مستغيثة تناشد المحقق: “كرمال الله يا سيدي… التوبة يا سيدي”، وبعدها سمعت صوت امرأة أخرى. اقشعر بدني وارتفع الأدرينالين في دمي، أريد أن أفعل شيئاً. وعندما أدخلوني وضربوني لم أهتم لما يحدث لي بقدر ما كنت أتذكر صوت “الحرمة”. عندما أعادوني إلى الزنزانة حكيت لزميليّ فيها ما سمعته وأنا في غاية الانفعال. ضحكا وأخبراني أن في الفرع من الموقوفات ما يساوي نصف عدد المحتجزين الرجال. في ما بعد صرت أرى هؤلاء النسوة عندما يصطحبهن السجانون إلى المراحيض القريبة منا ليقضين حاجتهن مرة في اليوم. عندما رأيتهن يهرولن والسجان يضربهن شعرت أن سجني لا شيء. صار التعذيب أهون عندي من فكرة أن هذه المرأة قد تكون إحدى قريباتي وهي تتعرض لهذه المهانة والتعذيب.

استدعيت للتحقيق في اليوم التالي. أنكرت كل التهم الموجّهة لي. في البداية حاول المحقق إقناعي بالاعتراف دون ضرب. وفي الجلسة الثانية ضربني قليلاً. وفي الثالثة “نفد صبره” فأخذوا يضربونني بالعصي وبأنابيب التمديدات الصحية المعدنية بعرض 3 إنش، وبالكرباج وهو نوعان؛ الأول مكوّن من نحاس رباعي ملفوف بلاصق والثاني جزء من دولاب سيارة. عُذِّبت كذلك بالفلق والكهرباء والشبْح والدولاب، وأنا مطمّش ويداي مقيدتان إلى الخلف. في إحدى اللحظات أمر المحقق العسكري أن يرفع الطمّاشة عن عينيّ. كنت وقتها منهكاً للغاية، لا أكاد أعرف من أنا، أشعر بالدوار، متوتراً بشدة. قال المحقق: “انظر إلى يمينك”. كان هناك شخص بدأوا بالتحقيق معه قبلي. قال: “شايف هداك؟” فأجبت: “نعم سيدي شايفه” فقال: “هداك ميت”!! صُدمت! كان جسده منتفخاً من شدة التعذيب، وكذلك كنت أنا، لا يمكن أن تستبين معالم وجهي، ويداي ملونتان بالأزرق والأحمر والأخضر.
قال المحقق: “يا بتصفّ جنبه وبتصير متله.. يا بتعترف”. كان هذا بعد عشرة أيام وأنا تحت التعذيب. كنت شاباً طرياً لم أمارس أي عمل شاق، بين المدرسة والمنزل فقط، ورغم ذلك كنت أصررت على الصمود وعدم الاعتراف بما لم أفعله. ولكنني الآن قررت أن أعترف فراراً من الموت، لعلّي أُسجن لعدة أشهر وأخرج إلى أهلي الذين لا يعرفون عني شيئاً.
اعترفت بالتهم التي كان يرددها على مسمعي وأنا لا أعي ما أقول. بان عليه الرضا وطلب لي طعاماً وماء. ظننت وقتها أن عذابي انتهى وأنه سيحوّلني إلى سجن عادي لكنه أعادني إلى الزنزانة. بعد ساعتين، وكان الوقت منتصف الليل، أرسل ورائي فقال: “لقد اعترفتَ أنك ضربت حاجز كذا وحاجز كذا وأنك زرعت عبوة”، فأجبت: “نعم سيدي، اعترفت”. كنت حينها أشعر بشيء من الارتياح بسبب توقف الضرب لكنه فاجأني بالسؤال: “احكي لنا هلق كيف عملت ما اعترفت به ومع من؟”. لم يكن عندي أي جواب فاضطررت إلى اختراع قصة خيالية راعيت فيها ألا أتحمل مسؤولية قانونية كبيرة. زعمت أننا، كيافعين، نوضع في الصف الثاني للمسلحين نملأ الذخيرة ولا نطلق النار، إذ لو قلت إنني أطلقت الرصاص على جنود من الجيش كان سيقتلني في مكاني.
في سجن البالوني
بعد يومين أو ثلاثة حوّلوني من الفرع. في الطريق إلى دمشق مررنا بمركز احتجاز مؤقت شهير هو “البالوني”. هنا لا تتعرض لضرب شديد، فقط بعض الكرابيج عند “الاستقبال”. كنا نقف في دور لتسليم “الأمانات” التي تكاد تقتصر هنا على الهوية الشخصية بعد أن تكون النقود التي كانت بحوزتك عند الاعتقال قد تبخرت بالسرقة. كان أحد العناصر يسجّل معلوماتنا على ورقة وبجانبه ضابط علوي ضخم بشوارب كثة. سألني: “ما اسمك؟” فأجبت. فسأل: “أنت شو عامل؟ لساتك ولد… شو عامل؟” فبدأت إجابتي بقولي: “أستاذ ماني عامل…” فقاطعني قائلاً: “شو؟ شو قلت؟ عيد عيد”. كررت قولي: “أستاذ…” فنكزني السجين الذي يقف خلفي منبهاً إلى أن أخاطب الضابط بلفظة “سيدي”. لم أكن أعرف أن لفظة “أستاذ” في عرف الجيش السوري ذات معنى تحقيري. كنت أظن العكس! كنت أعتقد أنني أبجّله. حاولت الاعتذار مكرراً لفظة “سيدي” مراراً، لكنه أمرني أن أجلس في الزاوية. جاء وأخذ بشتمي بألفاظ لا تخطر على بال بشر ولم أسمعها في حياتي، ثم بدأ بضربي، لم يترك مكاناً في جسمي لم يضربني عليه. أثناء ذلك قدم اثنان من العساكر وسألا الضابط: “أمرك سيدي… شو عامل هادي؟” فأجابهم: “اضربوه… عم يقول لمعلمينه أستاذ!”. صارا يضرباني وهما يخاطباني بلهجة علوية غير متقنة، لأنهما ليسا علويين. يستحيل أن أنسى هذا اليوم، فأنا قادم من المدرسة في نهاية المطاف، وقد اعتدت على استخدام كلمة “أستاذ” للاحترام!
في فروع دمشق
سندني اثنان من زملاء الرحلة وأدخلاني وأنا مضعضع إلى مهجع “البالونة” الذي بقينا فيه أكثر من عشرة أيام. ثم حوّلونا إلى فرع فلسطين مروراً بالقابون. في أي فرع تمرّ به هناك ما يدعى “الاستقبال”، وهو حفلة تعذيب ابتدائية تزداد شدتها كلما صعدتَ درجة في سلم أهمية الفرع ومستواه. أصبح موضوع التعرّي والوضعية “جاثياً” أشياء أوتوماتيكية تتكرر عند الدخول لأي فرع. تعرّفنا على “الأخضر الإبراهيمي”، وهو أنبوب تمديدات صحية بلاستيكي لونه أخضر وقطره 3 إنش، سمّي كذلك نسبة إلى مبعوث أممي للقضية السورية.
كان “الاستقبال” في فرع فلسطين هو الأشد. عندما أدخلونا كنا 95 سجيناً في “جنزير” واحد، قتل منا ثلاثة أثناء “الاستقبال”! كان الطعام “معقولاً” نسبياً هنا، أي أن أحدنا كان يحصل على رغيفين أو ثلاثة من الخبز في اليوم، ولذلك كانوا يضربوننا كي لا نشعر أننا موجودون هنا لمجرد الأكل والشرب! فإما أن يدخلوا على المهجع، كل أسبوع أو عشرة أيام، ليضربونا جميعاً فيه، أو أن يخرجونا، فرادى أو اثنين أو كل ثلاثة، فيضربونا في الخارج ويعيدونا، دون سبب ولا تحقيق.
حوّلونا بعدها إلى الفرع 248، التابع لجهاز الأمن العسكري كذلك. هناك “استقبلونا” ثم لم نتعرض للضرب بعدها. ولذلك تفاءلنا بالإفراج عنا قريباً. في أحد الأيام نادوا على بعض الأسماء وكنت بينها. كنا حوالي 100 سجين تقريباً. سلكونا في “جنزير” واحد، وهو أن تبقى إحدى حلقتي الكلبشة في معصمك والحلقة الثانية في الجنزير المعدني. صعدوا بنا إلى سيارة “البراد” المخصصة لنقل السجناء، حيث نكون في صندوق مغلق إلا من فتحات صغيرة جداً وعالية يدخل منها قليل من الضوء والهواء. نظرنا منها لنعرف وجهتنا. قال أحد المقيمين في دمشق والذين يعرفون طرقها: “يا شباب… الله يستر!” ولما سألناه ونحن قلقين أجاب: “نحن ع طريق صيدنايا”. لم أكن قد سمعت بشيء من هذا من قبل فسألت: “شو هاد صيدنايا؟”. أجابوني: “هلق بتشوف شو هو!!”. وصاروا يدعون الله أن يكون نصيبنا في “الأبيض”! لم أفهم شيئاً من هذا الحديث أيضاً! ما صيدنايا! وما الأبيض والأحمر! لاحظت معالم الخوف على من حولي فاستغربت ذلك بعد كل الذي مرّ بنا. ولما أبديت لهم ذلك سألني أحدهم: “شقد صار لك مسجون؟ وعلى أي أفرع مرّيت؟” فلما أجبته قال: “بتعتبر الفترة اللي سجنتها والأفرع اللي مريت فيها أنك كنت عند بيت أهلك”! ذهلت من كلامه فكرر: “اعتبر أنك كنت ببيت أهلك أو بسياحة بالنسبة للي رايحين عليه”! أحسست بالخوف وأخذت ألهج بالدعاء.
في صيدنايا: حفل الاستقبال
عندما نزلنا من البراد أمرونا أن نخلع عراة بالكامل ثم أن يمسك كل منا بيديه خصر زميله الذي أمامه وينحني ويضع جبينه على مؤخرة هذا السجين، وبهذه الطريقة كان من المستحيل أن ترى أحداً. كانوا يطمشون أعيننا في الأفرع، أما في سجن صيدنايا فلم يفعلوا ذلك. صرنا مثل قطار مكون من مائة شخص. أول ما واجهنا في صيدنايا درج عال صعدناه ثم أصبحنا في صالة كبيرة جداً في وسطها مكتب ليسلم فيه القادمون الجدد “أماناتهم”.
“الاستقبال” في صيدنايا فظيع للغاية، من ينجو منه سيتمكن من الحياة في هذا السجن المريع. هنا تعرفت إلى ما يسمونه “الهروانة”، وهي أنبوب مصمت من السيليكون المضغوط الذي يستعمل للحم البلاستيك في الأصل. الهروانة لا تجرح، فهي غير حادة، ولا تكسر عظماً، لكنها إما أن تميت الشخص مباشرة أو تسبب له ألماً غير عادي، أشد من كل وسائل التعذيب الأخرى.
كان مكاني قريباً من آخر الدور لتسليم “الأمانات”. أثناء ذلك كان الضرب لا يتوقف، لنكتشف لاحقاً أنه مجرد ضرب “تمهيدي”. أثناء تسليم الأمانات يبدأ الضرب الجدي، وبعد ذلك يتوجه السجين إلى حائط فيسجد على الأرض باتجاه الجدار بينما يظل جسده العاري مكشوفاً. وهنا يتناوله حوالي 15-20 من السجانين بالضرب حتى يأتي سجين آخر من تسليم الأمانات فينتقلون إليه، ثم يعاودون ضرب القديم والأقدم، وهكذا.
كنت أصغر القادمين في “الجنزير”، ووصلت أعمار البعض إلى الخمسين أو الستين عاماً. عندما اقترب دوري لتسليم أماناتي جاء عنصران يحمل كل منهما هروانة وسألاني عن مواليدي فأجبت إنها 1997، فقالا: ما الذي جاء بك إلى هنا وأنت في هذا السن الصغير؟ ماذا فعلت؟ أجبت أنني لم أرتكب شيئاً وأنني هنا خطأً. أثناء ذلك كنت مطأطئ الرأس، يمنع أن أرفعه أو أن أتلفت يميناً أو يساراً ولذلك لم أر من يتحدث معي. في صيدنايا إذا صدف ورأيت وجه السجان سيكون مصيرك الموت. سألاني عن قصتي فسردتها، وتخيلت أنهما قد تعاطفا معي بحكم عمري. قالا “اخرج من الدور وأعطنا ظرفك”. وقفت جانباً وأعطيتهما الظرف الذي يحوي الأمانات. أمراني فرفعت يديّ إلى أعلى وباعدت بين فخذيّ وأخذا بشتمي وضربي على أعضائي الجنسية. ضربا قضيبي سبع ضربات بالهروانة يستحيل أن أنساها. مع الضربة الأولى شعرت أنني على وشك الموت، وتمنيت أن يقتلاني لأتخلص من هذا الألم الفظيع.
في الأفرع كانت الاستغاثة والبكاء ومعالم الانهيار والتوبة تجدي بعض الأحيان، أما في صيدنايا فالحال هو العكس، إذ زاد الضرب عندما لاحظا أن جسدي صار يرتجف لا إرادياً.
وسائل الضرب هنا هي الهروانة والأنبوب المعدني و”قشاط الدبابة”، وهو السير الجلدي الذي يلتف على محرّك الدبابة، وهو يسلخ الجلد كلياً، والكبل الرباعي المكون من كبل من النحاس يجدل مرتين، عندما يضربونك به تشعر أنك ستموت، وبعد الضربة الأولى يتخدّر جسمك فلا تعود تشعر بالألم إلا بعد انتهاء حفلة التعذيب ويهدأ جسمك فتحس.
استمر “الاستقبال” حوالي أربع أو خمس ساعات. ومن المائة الذين وصلنا سوياً قتل ما لا يقل عن خمسة عشر شخصاً! كل يومين أو ثلاثة يصل “جنزير” كهذا إلى السجن ويسقط عدد مقارب من الضحايا. قتل الناس في صيدنايا كان أمراً تافهاً.
إلى المنفردات
عندما انتهوا من ضربنا سحبوا الجثث إلى طرف وصاحوا: “واقفاً واقفاً… قطار قطار قطار”، فاستجبنا كما حصل عندما وصلنا في البداية. وجّه العسكري أول واحد في “القطار” فنزلنا درجاً. كانت أعضائي التناسلية قد تورمت بتأثير الضرب وكنت أشعر بألم شديد عند المشي وكان نزول الدرج صعباً، خاصة مع وجود عناصر من السجانين منتشرين على طرفي الدرج وهم يضربون من يمر. نزلنا حوالي 3 أو 4 طوابق تحت الأرض. وصلنا إلى زنازين يقف أمام كل منها عسكري يُدخل إليها عدداً من القادمين.
كانت هذه هي “المنفردات”. أدخلونا إلى واحدة مساحتها ثلاثة أمتار في ثلاثة ونصف أو أربعة أمتار، وبداخلها حفرة المرحاض. كنا 28 شخصاً. كانت خصيتاي قد تورمتا ولم أعد أتمكن من المشي أو الجلوس أو الوقوف. كان وقتاً صعباً جداً.
كانت حصة الواحد منا بلاطة فقط، فكنا نتناوب الوقوف والجلوس. كنا عراة متلاصقين متزاحمين. رجوت من حولي أن يقدّروا وضعي فتبرع ثلاثة ووقفوا كي أتمكن من مد فخذيّ والمباعدة بينهما. كانت الظلمة مستمرة في هذا المكان تحت الأرض لولا “نواسة” حمراء صغيرة داخل “المنفردة” التي حوت كل هذا العدد.
ظللنا في البداية ليومين دون طعام ولا ماء. وفي اليوم الثالث أحضروا لنا ماء وأعطونا، كلنا، رغيفاً ونصف من الخبز وخمس عشرة زيتونة! كنا نتضور جوعاً ولم نعرف ما نفعل بهذه الكمية الغريبة! صار الاثنان يتقاسمان الزيتونة. وزعنا الخبز فكانت حصة الواحد لقمة! أكل البعض وآخرون لم يأكلوا. كنت مشغولاً بألمي الذي كان لا يتوقف أثناء النوم أو الجلوس أو الوقوف. منذ اليوم التالي صارت حصتنا ثلاثة أو أربعة أرغفة من الخبز. وفي اليوم الذي يحضرون لنا فيه طاسة صغيرة من الرز، لا تتجاوز السبعة أو الثمانية ملاعق، كانوا يقطعون الخبز.
الشاويش
عيّنوا لكل واحدة من المنفردات “شاويشاً”. يتم ذلك بأن يدخل السجان فيختار شخصاً لا على التعيين ويأمره أن يتخذ الوضعية جاثياً على ركبتيه ووجهه إلى الحائط، ثم ينهال عليه بالضرب المفرط حتى يعجز عن الوقوف، فيجبره على ذلك ويخبره أنه صار شاويش الزنزانة، ويبلغه التعليمات التي يجب عليه اتباعها تحت طائلة قتله إن تمت مخالفتها. باختصار، الشاويش شخص ميت.
أحد الموجودين في المنفردة بجوارنا كان دائم الصياح بسبب فقده السيطرة على عقله، وكنا نطلق عليه “الفاصل”. في أحد الأيام جاء السجان نتيجة الصوت فسأل شاويش زنزانته الذي أجاب إن “الفاصل” هو من صرخ. يطلق السجانون في صيدنايا على الشاويش لقب “العرصة”. قال السجان: “يا عرصة… بعد 5 دقايق إذا بسمع صوته؛ يا أنت بتموت يا تنيناتكن بتموتوا”. فهم الشاويش أنه ميت لا محالة إن لم يتخلص من هذا السجين المضطرب، وهو ما حصل… أمسك برقبة “الفاصل” فلواها وأجهز عليه. عندما عاد السجان في المساء سأل الشاويش عما حدث فأجاب: “مشي حاله”! لم يستطع عقلي تخيل حصول هذا الأمر بين سجناء، فقد قتل الشاويش شخصاً كي يحافظ على حياته. أما السجان فأعجب بالشاويش ورفع صوته مخاطباً الجميع: “اسمعوا يا عرصات… أنتو كنتوا رح تضلوا من 25 يوم إلى 30 يوم في هالمنفردات، بس بكرة الصبح رح نطالعكن منهن، مكافأة مني لشاويش الزنزانة”.
في المهجع
هكذا ظللنا في “المنفردة” 13 يوماً فقط ثم صعدوا بنا إلى مهاجع كبيرة طول الواحد منها أحد عشر متراً وعرضه ستة أمتار وفيه حمام. كان المهجع نظيفاً وكأنه لم يستعمل من قبل، ووجدنا فيه بعض المنظفات التي كانت ضرورية جداً لنا بعد كل هذا. صرت أمشي وأمارس الرياضة فبدأ ورم أعضاء التناسلية بالتراجع تدريجياً.
خلال الأربعة أو الخمسة أيام الأولى في المهجع لم يحضروا لنا أي طعام! عشنا على الماء. لم يدخل علينا أحد! في اليوم الخامس أحضروا الفطور الذي كان مكوناً من الخبز وجاط زيتون كان نصيب الواحد منه زيتونتان ونصف.
كنا هنا 35 شخصاً، وهو، كما علمت لاحقاً، الحد الأعلى للعدد في المهاجع. نقلوا الثمانية وعشرين شخصاً الذين كنا سوياً في “المنفردة”، وأضافوا إلينا سبعة من الزنزانة التي كانت مجاورة لها، بينهم الشاويش الذي قتل سجيناً لينجو! كان شاباً بشعر طويل. نسيت اسمه ولكني عرفت عندها أن أصله من “الفوعة” بإدلب، وكان “شبيحاً” في دمشق يفعل ما يشاء حتى اختلف مع من هو أقوى منه في التشبيح فكان مصيره السجن معنا.
عندما دخل سجان المهجع ليعين شاويشاً له اصطففنا، كما هي التعليمات، جاثين على ركبنا ووجوهنا إلى الجدار المقابل للباب. وقفنا صفين فاختار السجان هذا الشاب نفسه. أخرجوه من بيننا وتناوله ثلاثة بالضرب حتى صار يتكلم بصعوبة فقال له المسؤول: “ولاك… أنت عرصة المهجع” وبدأ يلقنه التعليمات التي كانت أن أي صوت يصدر أو مخالفة تحدث سيعاقب عليها.
بعد أن صار هذا الشاب شاويشاً أخذ بالتنمر علينا وصار يريد أن يضربنا هو الآخر! وفي أحد الأيام استنكر أحد السجانين عليه طول شعره وأمره بحلاقته خلال يومين تحت طائلة الموت. لم يكن هذا مفهوماً لأي منا، فكيف يمكن أن يقص الشاويش شعره وليست في المهجع أي وسيلة لذلك من مقص أو سكين أو أي أداة حادة! لكن الكلام كان جاداً فبدأ الشاويش بنتف شعره وهو يتألم ولا يجرؤ على الصياح، والسجان يذكّره بالموعد في الغد كلما مرّ!
حل الصباح التالي وجزء قليل من الشعر فقط قد زال. كانت مشاعرنا مختلطة؛ فهو شبيح وقد قتل السجين “الفاصل” وحاول إذلالنا والتحكم بنا، لكنه في النهاية روح تعيش بيننا. كنا نتمنى أن يُعاقب بشيء ما لا أن يموت! اقترح عليه أحدنا أن يكسر إحدى قطع السيراميك الموجودة في الحمام ليستخدمها كأداة حادة فاقتنع. أخذ يلكم السيراميك حتى دميت يده ولم يستفد شيئاً. أخذنا نحاول الواحد تلو الآخر، بمن فيهم أنا الذي كنت أكرهه. دميت أيادي بعضنا أيضاً حتى كُسرت إحدى القطع. بدأوا بحلاقة شعره بها فصار يتألم بشدة. ولأنه لا يستطيع الصراخ أخذ يبكي. لكنه نجا بذلك من الموت وتغير تعامله معنا.
الدولاب
كان هذا هو اليوم السابع لنا في المهجع. في الغد سيضربوننا لأول مرة هنا. كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة ليلاً عندما بدأوا بضرب السجن كله، من أول مهجع في الطابق الأول وحتى آخر مهجع في الطابق الثالث. كانت هذه الطريقة تسمى “الدولاب” بسبب أنها تشمل السجن كله، وذلك بخلاف العقوبة التي قد تطال جناحاً محدداً أو مهجعاً بعينه. عندما بدأ الضرب كانت الأصوات مرعبة. كنا ندعو الله أن ينتهوا ممن قبلنا بسرعة ويأتي دورنا كي ننتهي من الذعر. كنا في المهجع السابع من الجناح الثالث من الطابق الثاني. عندما كانوا يصلون إلى طابقنا كان علينا أن ننتظر حتى ينهوا الجناحين الأول والثاني وستة مهاجع! كنا نموت ألف ميتة من سماع الصوت فقط! لكنهم دخلوا أخيراً! لا أستطيع وصف الضرب لكن ربما يكفي أن أقول إنه خلّف قتيلين من بيننا! في مرات قادمة ربما يُقتل خمسة أو سبعة من مهجعنا خلال حفلة من عشر دقائق!
في الصباح التالي نقوم بإبلاغ السجانين بوجود الجثث ليجري إخراجها. في جناحنا أبلغت جميع المهاجع عن جثث من الليلة الماضية؛ من المهجع الأول خمسة ومن الثاني ثلاث وهكذا… أخذنا نتعرّف على نظام السجن بالتدريج، ومنه أننا سنتعرض لموجة من الضرب مرتين أو ثلاثاً في الأسبوع، ولن تمرّ إحداها دون جثة واحدة في حال كان الضرب “معقولاً”. وكلما نقص عدد نزلاء المهجع كانوا يرممونه بسجناء جدد لا ينتهي تواردهم.
الطعام
في البداية كنا نأكل فرادى حتى اكتشفنا ما يسمّى نظام السفرة، وهي أن يقسّم نزلاء المهجع على مجموعات يرأس كلاً منها من يُطلق عليه لقب “رئيس السفرة”، وهو من يتلقى حصة هذه المجموعة من الطعام من شاويش المهجع ويقسمها على أفراد سفرته أو مجموعته. كنا 35 كما أسلفت، فتوزعنا على سبع سفر تتألف كل منها من خمسة سجناء. وهكذا كان على شاويش المهجع أن يقسم ما يأتي من طعام على سبع حصص للمجموعات.
بعد مدة من وجودنا في صيدنايا نسينا العالم الخارجي، نسينا أهالينا، نسينا لماذا نحن هنا، بل وتأقلمنا مع الضرب. صار الأمر الوحيد الذي يشغل بالنا هو متى سيأتي الطعام، بعد أن تراكم علينا الجوع وفقدنا أوزاننا التي كنا قد حافظنا عليها حتى في الأفرع الأمنية.
في أحد الأيام اكتشفنا أن الشاويش، وآخر كان قد عيّنه مساعداً له، يقتطعان لنفسيهما حصصاً من الطعام أكبر مما يصل عادة إلى الواحد منا. اختلفنا معهما وارتفعت الأصوات فقدم السجانون. دخلوا إلى الجناح وسألوا عن مصدر الضجة وعرفوا أنه من مهجعنا. دخلت علينا مجموعة من 10-15 عسكرياً وبدأت بضربنا. كنا لا نزال عراة.
أثناء الضرب كانوا يشتموننا بسبب خلافنا على الطعام وكأننا نشير بذلك إلى تقصيرهم فيه! كانت حصة أحدنا على الفطور ربع رغيف وعدة زيتونات. أما على الغداء، المكوّن من البرغل أو الرز، فكان الشاويش يغرف بيده حفنة من الجاط ويسكبها في يديّ كل منا المفتوحتين ونحن قادمون بالدور. لم تكن هناك أي أدوات للطعام وكان على الواحد منا أن يتدبر أمر تقريب يديه من فمه ليأكل الكمية المخصصة له فيهما.
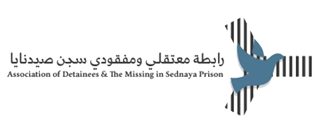
بعد الضرب في ذلك اليوم أدخلونا إلى الحمام. كنت قد قلت إن في زاوية المهجع حماماً ومرحاضاً. لا أدري كيف أصف حشر 35 شخصاً في مساحة بطول مترين وعرض مترين. نبهونا إلى أن من يخرج من الحمام سيموت. كان الأمر مستحيلاً في الحقيقة، إذ كان بعضنا يضطر إلى الاندفاع خارج الحمام بسبب الزحام غير المعقول. وعندما يأخذون بضربه كان يندس بكل قوته في كتلة الأجساد المتراصة، مما يؤدي حكماً إلى إخراج سواه بسبب التدافع فيقع عليه الضرب، وهكذا حتى خرج السجانون.
مرت حوالي النصف ساعة ونحن لا نجرؤ على التحرك حتى بدأ بعضنا يشجّع الآخر على الخروج من الحمام لأن الأمر انتهى كما ظننا. لم نكن نعلم أنهم يستمعون إلينا من وراء باب المهجع. دخلوا من جديد وكانوا يحملون عصاً كهربائية. كانت في أرض الحمام كمية من المياه بارتفاع حوالي 4-5 سم، وكانت أجسادنا متلاصقة ومتداخلة طبعاً، ولذلك عندما لسعوا أول سجين من جهتهم بالعصا سرت الكهرباء فينا جميعاً… أما هو… فمات!
ظلت الحال هكذا خمسة أيام! نحن محشورون في الحمام وممنوعون من الخروج منه إلى “رحابة” المهجع. عندما كان الواحد منا يريد قضاء حاجته كان ينتقل إلى المرحاض ويعود إلى الحمام. لم يحضروا لنا أي طعام، وعندما كان واحدنا يعطش كان يتحرك إلى الحنفية الواقعة بين الحمام والمرحاض فيشرب منها ويعود.
كان الشاويش ومساعده قد صنعا ما أسمياه “اليطق”. يبدو أن الشاويش كان قد تولى المهمة نفسها في الأفرع الأمنية سابقاً وكان فيها “سلطان زمانه” وظن أن الحال هنا يشبه ذاك. اليطق هو مجلس مرتفع قليلاً مكوّن من جمع عدة بطانيات عسكرية وحزمها بحبال قماشية تؤخذ من تمزيق بطانيات أخرى كذلك.
عندما دخل السجانون لمعاقبتنا لاحظوا هذين اليطقين وبقايا البطانيات الممزقة. كان هذا أمراً عادياً في الأفرع أما في صيدنايا فالبطانية أهم من أي سجين. بمجرد أن تمزق بطانية فأنت ميت. سأل السجانون عن هذا ومن فعله. امتنعنا عن الإجابة فأقسم أحدهم إننا سنموت جميعاً إن لم نعترف. قال أحدنا أخيراً إن هذه “يطقات” من فعل الشاويش ومساعده. بدأت شتائم السجان تطال الاثنين وأمرهما بالخروج من الحمام. تلقيا ضرباً لم أكن قد رأيت مثله في حياتي. صار السجانون يتناوبون عليهما، كلٌّ بما يحمل من أداة. في العادة يكفي للتعذيب بالعصا الكهربائية لسعة واحدة، لكن أحدهم ثبتها على جسم الشاويش لمدة 45 ثانية إلى دقيقة، ظل بعدها شبه مشلول لأيام.
أخيراً تشجّع أحدنا وقال إنه سيطلب من المساعد العفو عنّا. استجاب المساعد لتوبتنا وسمح لنا بالخروج من الحمام. نبّهنا إلى الحذر من إصدار أي صوت في المستقبل، وقال إنهم سيعاودون جلب الطعام لنا ابتداء من الغد. كان ذلك مصحوباً بالشتائم لكننا اعتبرنا هذا المساعد “جيداً” لأنه لم يقتل من تجرأ وخاطبه طالباً العفو!
في مهجع الجوع
بعد حوالي خمسة عشر يوماً في المهجع سمعنا بما يقال له “فرط المهاجع”. لم نفهم المعنى في البداية حتى صاروا يُخرجون كل أربعة منا وينقلونهم إلى مهجع آخر يختلف عن الباقين. وهكذا نُقلت، مع ثلاثة، إلى مهجع كان يحوي ثلاثين سجيناً من قبل. وهنا تبدأ قصتي!
في المهجع الجديد رأينا موتى يسيرون على أقدامهم. خفت عندما رأيتهم. كانوا شديدي النحافة وخدودهم غائرة وقفصهم الصدري بارزاً، لا يتجاوز وزن أسمنهم 35-40 كغ. كنت أزن سبعين كيلوغراماً وقتها، وهو وزني الطبيعي الذي لم ينقص في الأفرع، فقد كان الغذاء مقبولاً وكنت أواظب على الرياضة حتى لو كانت حصتي من المساحة بلاطة واحدة.
أخذنا بالحديث معهم وأنا لا أزال خائفاً منهم ومن أني قد أصبح مثلهم. أما هم فقد استغربوا الامتلاء الواضح لجسدي، فقد كنا لا نزال عراة تماماً. كانت في المهجع ست سفر تتألف الواحدة منها من خمسة أشخاص، وصرنا، نحن القادمين الجدد، سفرة سابعة. كان الثلاثة الذين معي “أولاد دعوى” واحدة كما يقال بلغة السجون السورية، أي أنهم متهمون في قضية جماعية واحدة مشتركة. كانوا من جسر الشغور بريف إدلب، وكان أكبرهم يدعى نادر نديم كحيل، وهو من سأصبح قريباً منه بسبب أخلاقه الطيبة. واكتشفت أن أحد قدامى المهجع يتحدر من منطقتي نفسها. كان اسمه محمد هاشم الأقرع، وكان يحظى باحترام الباقين ومحبتهم بسبب أخلاقه وقدمه، إذ كان مسجوناً منذ 2011.
جاء أبو هاشم الأقرع وتعرّف عليّ وعلى قصتي، ثم أعطاني بنطالاً وقميصاً لأرتديهما. عرفنا هنا أن هناك نظاماً للزيارات في صيدنايا، فقد كان بعض الذين انتقلنا لعندهم يرتدي بيجاما أو كنزة أو قميصاً… إلخ. شعرت بسعادة بالغة بمجرد ارتداء الملابس التي جلبها لي أبو هاشم من شاب من منطقتنا أيضاً اسمه حسام موّاس كان قد تلقى زيارة. كان انكشاف عورتي أمراً يثير حساسيتي، وكنت أغطيها أثناء الصلاة التي لم أنقطع عنها حتى في أحلك الأوقات، أما الآن فصار بإمكاني أن أصلي بشكل طبيعي!
- توضأت وصليت وجسدي مستور… سررت بشكل كبير جداً.
أعلن أبو هاشم في المهجع أنني ابن منطقته وأنني محسوب عليه، وأن من يمسّني بسوء سيكون وكأنه نال منه. لم أفهم شيئاً، إذ ما الذي قد يحدث! ستمر مدة قبل أن أعرف أن الأمر كله يدور حول الطعام. كان السجناء قد تحولوا إلى ما يشبه الذئاب التي يحاول أحدها الاستيلاء على حصة سواه كي يبقى على قيد الحياة. لكن تحذير أبو هاشم كان كافياً، وفي المستقبل ربما سيظل طعامي ملقى على الأرض أمام الجميع دون أن يقربه أحد. لم يكن أبو هاشم شاويشاً للمهجع ولكنه كان متطوعاً لتنظيفه، وكان يقوم بذلك بشكل ممتاز.
بعد قليل جاء الطعام المكون من البيض والزيتون. كانت حصة “سفرتنا”، المكونة من أربعة أشخاص، بيضة ونصف بيضة، ونصف رغيف من الخبز للواحد.
قال لي أبو هاشم ألا أبادل الطعام بنفسي بل أن أخبره عن ذلك إن رغبت. لم أفهم أيضاً، حتى عرفت بالتدريج أن في السجن “تجارة” تقوم على عملةٍ هي الخبز. فمثلاً قد يشتري أحد السجناء من آخر -وصلته زيارة- كنزة ليستر بها جسده أو يتقي البرد، مقابل ثلاثة أو أربعة أرغفة تُسدّد بمعدل ربع رغيف يومياً! وقد يبيع من لا يحب البيض حصته مقابل نصف رغيف… وهكذا.
بعد أن تناولنا فطورنا الأول هنا، وكنا قد وضعنا قشر البيض وعجو الزيتون جانباً، أتانا ثلاثة من السجناء وسألونا “أتحتاجونها؟”. استغربنا وسألناهم عن ماذا يدور هذا الحديث؟ فأجابوا إنه قشر البيض. ظننت أنهم ينبهوننا إلى النظافة فقلت إنني سأرميه بعد قليل ولكني لا أعرف أين، فأنا جديد في المهجع. كرروا السؤال عن حاجتنا إليه فأجبت بتلقائية: لا. كان المشهد مرعباً عندما تناوشت أياديهم المتنافسة قشر البيض. شعرت أن دقات قلبي وصلت إلى 1000 لشدة فزعي. قفزت إلى الوراء وصرخت بهم: “ما الذي تفعلونه؟!”. أجابوا: “أنت جديد وستعرف في المستقبل”. “ما الذي سأعرفه؟!”. قالوا إنهم يأكلون قشر البيض وعجو الزيتون وأي شيء!
أتى أبو هاشم وقال لي أيضاً إنني جديد، وعليّ أن أهدأ وسأفهم كل شيء لاحقاً. صرخت: “ما الذي سأفهمه؟ ماذا يحصل أمامي؟!”.
بعد شهر أو شهر ونصف سيشح الطعام بشدة. قد تمضي أربعة أو خمسة أيام دون أن يحضروا شيئاً، ثم تصل وجبة تكون حصة الواحد منها ربع رغيف أو نصفه. اعتدت تناول قشر البيض وعجو الزيتون، مثل الآخرين.
مرت أربعة أشهر في هذا المهجع لم تحدث فيها إلا هذه الدورة؛ ننام، نستيقظ، ننتظر الطعام القليل جداً، نتناوله كاملاً بشرهٍ ونختلف عليه. لن أسترسل في الحديث عن الضرب فقد كان متكرراً حتى صار بالنسبة إلينا أمراً طبيعياً. حتى الموت صار شيئاً معتاداً، يموت البعض نتيجة الضرب أو المرض أو الجوع… وهكذا.
وفاة أبو هاشم
في أحد الأيام مرض محمد هاشم الأقرع، الشاب الذي كان قد علمني الكثير ورعاني في كل شيء. كان قد علّمني الاقتصاد في الخبز وتوفيره للأيام الصعبة. وكان يحفظ لي مخزوني عنده لئلا يسرقه أحد، إذ كان بعض الجائعين لا يحتملون رؤية خبز لدى أحد زملائهم، وكان اعتمادنا الرئيسي في الطعام على الخبز. ولأنني كنت أمارس الرياضة كنت أشتري البيض منه ويتساهل معي في التسديد. في إحدى المرات أخذت من عنده بيضة، بيضة كاملة، على أمل دفع ثمنها قريباً ولكن الأيام اللاحقة توالت وحصتي اليومية ربع رغيف فقط، وكان يرفض أخذه. ظل الوضع هكذا لأسبوع حتى تمكنت من تسديد ثمن البيضة، الذي كان نصف رغيف أو ثلاثة أرباعه.
قبل مرضه كان لدينا مرضى. كانوا يصابون بالضعف الشديد حتى يعجزوا عن القيام والحركة والطعام، بالتزامن مع الإسهال. وكنت قبلاً أساعد أبو هاشم في تنظيف المهجع وإزالة فضلات من يضطرون لقضاء الحاجة في أمكنتهم لعجزهم عن التحكم بأنفسهم. وكذلك كان يساعده حميد مروان يسوف من الغاب، الذي سيموت لاحقاً وأتولى إبلاغ هذا الخبر لأهله بعد خروجي.
عندما مرض أبو هاشم وعجز عن الحركة توليت وحميد تنظيف المهجع. لاحقاً سأعرف أن ما أصاب أبو هاشم هو السل. أما الآن فصرت أعتني به وأدلك جسمه لتخفيف الألم عنه.
زاد مرض أبو هاشم. وقبل أن يتوفى بيوم ارتفعت درجة حرارته بشدة وصرت أعالجه بكمادة هي القميص في حقيقة الأمر. وفي اليوم التالي قضى بين يديّ وأوصاني أن أبلغ أهله بذلك إن قيّض لي الخروج. وهو ما فعلته.
عند حدوث وفاة في المهجع عليك أن تبلغ السجان حين يأتي بالطعام. لاحقاً سيرسلون لك عسكريَّين معهما نقالة عسكرية يضعانها خارج المهجع ويأمران بإخراج المتوفى. كان على أهل المهجع مصالبة قدمي الجثة وربط يديها على صدرها. حين يصيح السجان لإخراج الميت يتولى ذلك اثنان من السجناء، كان عليهما أن يفعلا ذلك خلال خمس ثوانٍ يرافقها التعداد الصادر من السجان، فإن لم يكفِ الوقت سيتعرض السجينان لضرب وحشي.
كانت أمور السرعة والتعداد شديدة الأهمية للسجانين، ودائماً تحت طائلة الضرب المبرّح. عندما يُحضرون الطعام كان السجان يعدّ حتى ثلاثة، وخلال ذلك على الشاويش أن يُخرج الجاطات الفارغة من الوجبة السابقة ويُدخل الجديدة. بعد أن ينهي السجان العدّ سيغلق الباب الموارب على كل حال، سواء أغلق بشكل طبيعي أم أثناء حركة الشاويش الذي قد يُكسر أحد أعضائه بهذه الحركة وقد يموت فوراً. ولذلك كان أكثر القتلى من “الشاويشية”. ألم أقل إن الشاويش شخص ميت!
ومات حسين
في هذا المهجع كان شاويشنا حلبياً، وكان معنا أحد أقربائه، وهو شاب اسمه حسين كان طالباً في كلية التربية بجامعة حلب. صار صديقي وكنا نتبادل قراءة القرآن. كنت قد حفظت كثيراً من السور من السجناء في الأفرع. وخلال الأشهر السبعة التي قضيتها في هذا المهجع صرت أبحث عمّن يحفظ بعض سور القرآن ليحفّظني إياها، وعلى من لا يعرف ما أحفظه منه لأتلوه عليه. وكان هذا أمراً يبعث على الراحة.
كان حسين يرغب أن أحفّظه سورة يس. بدأنا بذلك وكاد أن ينهي حفظها عندما مرض وظهرت عليه الأعراض نفسها. عجز عن الأكل فصار يهبني حصته من الطعام لكنني كنت أرفضها فيعطيها لقريبه الشاويش الذي كان يأكلها أو يعطيها للأشد حاجة ومرضاً وضعفاً في المهجع.
في منتصف إحدى الليالي سمعت من ينادي باسمي فصحوت من النوم. كان حسين يتدثر بالبطانية في زاوية المهجع ويشير لي بيده. ذهبت لأرى ما يريد فقال: “لا أريد شيئاً.. فقط اجلس بجواري واقرأ لي سورة يس”. لن أنسى هذه الليلة مهما عشت. قال: “اجلس بجواري. ضع يدك على جبيني واقرأ سورة يس”. فعلت ذلك ولما انتهيت سألته إن كان يحتاج شيئاً آخر فلم يرد. ظننت أنه غفا فعدت إلى نومي أنا الآخر. في الصباح اكتشفنا أنه مات بينما كنت أقرأ له السورة. بكيته بحرقة ولا أزال.
غسلناه وأخبرنا السجان عندما أتى بالطعام: “سيدي في عندنا ميت”، فأجاب بلهجة علوية: “في عندكِن فاطِس؟ خلوه فاطِس. بعدين تانشيلو”. ظلت جثة حسين في المهجع يومين قبل أن يأمروا بإخراجها. خلال هذا الوقت كنت أنظر إليه ولم أستطع أن آكل أو أن أتكلم مع أحد.
وقُتل محمد
كما سبق أن أوضحت؛ حين يدخل السجانون كان علينا أن نتوجه بسرعة إلى الجدار المواجه للباب. نأخذ الوضعية جاثياً ووجوهنا إلى الحائط وظهورنا للسجانين. بحكم العدد كنا نتوزع على ثلاثة صفوف، وكان العرف أن يكون الجدد في الصف الثالث الذي يتعرض للضرب أكثر بحكم استقباله للداخلين. كان مكان أبو هاشم في الصف الأول المواجه مباشرة للجدار بسبب أقدميته وكان مكاني في الثالث. لصغر سنّي ورعايته لي أراد أن نتبادل الأماكن كي لا يقع عليّ الضرب المباشر، مما يرفع من احتمال الموت، فلم أقبل. تدخل أحد السجناء من الصف الثاني فبادلني بمكانه وقال إنه سيقف خلفي ليتلقى الضربات. كنت قد عرفته للتو إثر دخولي المهجع. كان أسمر طويلاً، من ريف حماة الشرقي، متزوجاً ولديه ابنتان. أظن أن اسمه محمد. سأخبرك الآن لماذا لا أحفظ اسمه جيداً ولا أعرف عنه الكثير، إذ لم يتسنّ لي أن أخالطه.
بعد أن اتفقنا على تبادل الأماكن، وأتى السجانون لنوبة ضرب في اليوم التالي؛ أخذت موقعي في الصف الثاني وكان محمد ورائي. عندما يضربوننا تتساقط الأجساد فوق بعضها فاستغللت صغر حجمي وانبطحت لتغطيني أجسام الآخرين. عندما خرجوا كنت مبللاً بدم غزير بينما جسد محمد الضخم يقبع فوقي. خاطبته قائلاً: “محمد خلص راحوا… بعّد عني خليني أتحرك… رح تفطسني”، فلم يرد.
مات محمد بدلاً عني… ومات حسام موّاس الذي أخذت منه الملابس التي سترت بها عورتي. مات حسين… ومات محمد هاشم الأقرع… وبقيت وحيداً.
ومات محمد الآخر
تزايدت الوفيات يوماً وراء آخر، ولأسباب متعددة.
قلت إنني دخلت هذا المهجع مع ثلاثة من جسر الشغور “أولاد دعوة” واحدة. كانوا أقارب في الحقيقة، وقد اعتقل أولهم فاعترف، تحت التعذيب، باسمي الاثنين الباقيين وهما نادر نديم كحيّل وشاب اسمه محمد أيضاً، من مواليد 1995. كان وحيد أهله، يدرس الهندسة في جامعة خاصة. أصبحنا أصدقاء نسبياً بسبب تقارب العمر.
في أحد الأيام نودي على محمد للزيارة. لكنه عاد منها مصفرّ الوجه، جاحظ العينين. صار دائم الشرود والبكاء. عجز عن الأكل والشرب وكنا نجبره على الطعام فتظل اللقمة في فمه نصف ساعة دون أن يتمكن من بلعها. لم نعرف ما حصل! لم يتكلم إلا بعد مدة؛ ففهمنا أن من زاره كان أمه وخالته، وأنه لاحظ معالم الحزن الشديد على والدته، وكان متعلقاً بها جداً، فانتقلت إليه عدوى الاكتئاب الذي أنهكه بالتدريج أمام أعيننا حتى مات.
المهجع دون شاويش
لشدة الضرب الذي تعرض له الشاويش عجز عن أداء مهامه. تبرّع شاب من دمشق للحلول محله لكنه كان بطيئاً قليلاً في سحب الطعام فأغلق السجان عليه الباب، عند الانتهاء من التعداد، فكسر ظهره.
لم يعد أحد يجرؤ على التعيين كشاويش. اقترح أحدهم أن يصبح شاويشاً شرط أن يأخذ حصة زائدة من الطعام مقابل المخاطرة فلم نقبل. كان الأكل محور حياتنا ولا يمكننا المساومة عليه. قررنا أن نعيش دون شاويش وأن يتولى كل منا هذه المهمة يوماً بالدور، وأن نقسم الطعام بالتساوي. أثناء ذلك كان نقص الخبرة يلعب دوره في أن يُغلَق على الباب على الكثيرين أثناء إدخال الطعام، فصار نصف المهجع من المعطوبين. كان دوري متأخراً، وكنت أدعو الله ألا يأتي.
كنت قد انتقلت من الصلاة السرية، بتحريك عيوني فقط، إلى الصلاة جالساً مع السجود، وأخذت أشجّع سواي على ذلك. الصلاة في السجن ممنوعة نهائياً وعقوبتها الضرب المؤدي إلى الموت، لكنني فكرت أن ضربنا حاصل ومستمر مهما فعلنا أو لم نفعل.
كان معنا شاب اسمه أحمد. روى لنا قصة حزينة جداً عن حياته منذ غادر بيت أبيه وهو في التاسعة وسافر إلى دمشق حيث عاش حياة أطفال الشوارع بكل تفاصيلها ومعاناتها ثم انتقل للعيش مع أخواله في لبنان حيث عمل وتحسنت أحواله المادية. وعندما بدأت الأحداث في سورية قرر أن يعود للخدمة في الجيش كي “يدافع عن بلده” كما هي أفكاره المؤيدة للنظام. وأثناء عودته اعتقلوه على الحدود بتهمة التخلف عن أداء الخدمة الإلزامية وقادته الأمور إلى صيدنايا. بسبب التشرد الذي عاشه منذ طفولته كان “قلبه ميتاً”. كان يتحمّل الضرب ولا يأبه لشيء. كان سيئ الأخلاق ومن الذين يسرقون الطعام، لكنه طيب نسبياً.
في أحد الأيام جاء دور أحمد لسخرة الطعام، وبعد أن أنهى هذه المهمة نادى السجان الذي كان قد مشى مسافة عدة مهاجع فتوعّد أحمد بالضرب إن كان سبب النداء غير مهم.
عندما رجع أخبره أحمد أن مهجعنا دون شاويش. صار السجان يكفر ويشتم بألفاظ مقذعة، ونادى زملاءه وهو يقول لأحمد: “شو؟ ما عندك شاويش وَلا؟ بدك تصير شاويش؟! هلق بفرجيك كيف بتصير شاويش!!”. كان الطعام الذي أحضروه منذ قليل هو البرغل والشوربة. أجلس السجانون أحمد في وسط المهجع وصبوا فوقه الشوربة الحارة جداً ثم صاروا يضربونه. كانوا خمسة. أثناء ذلك صار يستغيث طالباً إيقاف الضرب ليقول أمراً ضرورياً. استجاب السجانون فأبلغهم أحمد أن في المهجع “ناس عم تصلي”!!
عندما سمعت هذه الجملة عددت نفسي بين الأموات. لكن أحمد تدارك نفسه فلم يذكر أسماء محددة بل زعم أن المهجع كله يصلي، كي لا تقع التهمة على أحد بعينه وكي ينقضي الأمر بحفلة ضرب جماعية اعتدنا عليها. عندما لم يستطع السجان الحصول على أسماء من أحمد ضربه بالهروانة على فمه فكسر حنكه وسقط مغمياً عليه. سكب السجان البرغل على جسد أحمد المتهاوي وخرج وهو يعطي الإيعاز: “باشر طعام”!!
كان الطعام فوق أحمد وحوله، مختلطاً بدمائه، ورغم ذلك أكل منه الكثيرون واندفعوا ليشربوا المرقة كالعادة، فقد كان أول وجبة تصل إلينا بعد انقطاع يومين.
توقعنا أن يموت أحمد لكن بنيته كانت قوية. خلال عشرة أيام كان بعضنا يتبرّع له بحصته من الشوربة فيحتسيها بصعوبة. عندما التحم حنك أحمد حصل ذلك بشكل مائل وعشوائي، مما صعّب عليه الكلام والأكل حتى بعدما شفي.
الطعام مرة أخرى
هناك طريقتان لإدخال الطعام؛ الأولى أن يضربونا ثم يعطوننا الوجبة، والثانية أن يرموها علينا عندما لا توجد لديهم الحماسة لضربنا. فمثلاً عندما يجلبون ما يسمّونه “الشاي” على الفطور كانوا يحملون القدر الذي يحويه ويدلقونه على رؤوسنا ونحن في الوضعية جاثياً. كان ساخناً جداً وكانت بقايا أوراقه تلتصق برأس من هو أمامي أو بكتف الذي بجانبي، وكنا نأكلها. كما كنا نصنع من أيادينا ما يشبه المغرفة التي نجمع فيها ما نستطيع من الشاي المسكوب ونشربه. كانت الأرض قذرة وكنا نجلس عليها بأجساد شبه عارية، لكننا كنا في أمس الحاجة إلى السكريات وإلى أن نشعر بطعم سائل سوى الماء. وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى الشوربة التي قد تصل في الغداء. حاولت الامتناع عن ذلك بداية لكنني رضخت وفعلت كالآخرين. أحياناً بسبب السرعة كنا نضع أفواهنا على السائل المصبوب على الأرض ونشفطه مع ما اختلط به من شعر وقاذورات.
يجب أن أضيف أنهم كانوا يحددون طريقة التعامل مع السائل حسب سخونته، فإن كان بارداً سكبوه على الأرض وإن كان حاراً صبوه على رؤوسنا.
صار عدد الذين يموتون من الجوع أكبر من عدد من يقضون تحت الضرب.
مرة تركونا دون طعام لثلاثة أيام. في اليوم الثالث جلبوا لنا وجبةً لم يسبق أن أحضروا مثلها! ملأت رائحة السمنة الزكية المبنى كله، إذ كانت تفوح من البرغل ومن شوربة العدس المرافقة. صرنا ننتظر دورنا ونحن نتضور شهيةً. بعدما أُدخل الطعام تراكضنا عليه، حتى ربما قبل أن يقفل المساعد باب الجناح كله كما تقتضي التعليمات. صدرت عنا أصوات بسبب ذلك فعاد المساعد ونادى سرية السجانين وأخذوا يضربوننا. ثم حمل سطل الشوربة الساخنة التي كنا نتمنى أن تدخل أجسادنا أخيراً، فسكبه على الأرض. أما البرغل فكبّه في المرحاض. تسارع البعض على مد أياديهم إلى حفرة المرحاض وصاروا يغرفون.
صرت أبكي… أردت أن أصيح… احترت ماذا أفعل!! يستحيل أن أنسى هذا المشهد في حياتي…
كانت كمية الطعام قليلة جداً. قد يمر يوم واثنان وثلاثة دون أن يحضروا لنا شيئاً، وبعد ذلك تكون حصة الواحد في الوجبة التالية نصف رغيف أو ثلاثة أرباعه. في مرات نادرة كنا نحصل على رغيف كامل. خلال سنتين لا أذكر أن هذا حصل إلا مرة أو اثنتين.
أعتقد أن التجويع أصعب طريقة تعذيب في العالم. يعتاد المرء على الضرب. قد يستغرب من يسمع هذا الكلام ولكنه حقيقة، ورغم أن الضرب في صيدنايا كان يفضي إلى الموت في كثير من الأحيان. في البداية كنا نخاف طبعاً، لكن بعد مدة صار الأمر عادياً. حتى عندما يُقتل رفيقك صرت تكتفي بالقول: “مات… الله يرحمه”. أما ما لم نستطع اعتياده فهو الجوع. وصلنا إلى درجة أن يطلب الواحد من الآخر أن يجلس على بطنه كي يتحمل الجوع قليلاً.
كان الإفطار هو الزيتون أو البطاطا مع شاي. نادراً ما كانوا يرمون الزيتون والبطاطا على الأرض، أما الشاي فمكانه الطبيعي فوق رؤوسنا إن كان ساخناً والأرض إن كان فاتراً أو بارداً. أما الغداء فمكون من الرز أو البرغل مع الشوربة أو المرقة. يسري على الشوربة ما يسري على الشاي برميها على الأرض أو علينا حسب درجة حرارتها. لشهور لم نشرب شيئاً ساخناً، حتى صار ذلك حلماً. صرنا نعتقد أن شرب أي سائل ساخن كفيل بوقف الإسهال الذي كان يصيب الكثيرين منا ووسيلة لتنقية الجسم من الجراثيم.
كانت حصة الواحد من الشوربة التي يشربها من الأرض لا تتجاوز الأربعة أو خمسة ملاعق. وعدداً أكثر بقليل من ملاعق الرز. لا وجود للملاعق ولا لأدوات الطعام بالتأكيد، لكنني أصف الكمية فقط.
داخل المهجع توجد مياه عادية في معظم الأوقات، وكن نقاوم الجوع بالإكثار من الشرب. لكنها كانت مياه مفعمة بالكلس، لونها غير رائق، وسببت لنا الإسهال الأمراض وأحياناً وجعاً في الكلى.
الحمام
كنا نستطيع الاغتسال داخل المهجع، لكن هذا كان صعباً على الكثيرين بسبب البرودة الشديدة للمياه. من المعروف أن صيدنايا منطقة ثلجية، ويقع السجن على مرتفع فيها تحيطه الجبال التي قد لا يذوب الثلج عن بعضها حتى صيفاً. وهو ما كان يسبب انقطاع المياه حين تتجمد في التمديدات والأنابيب. حافظت على الاستحمام رغم أنه كان أصعب من حفلة الضرب، وذلك بسبب الجرب الذي انتشر.
ولكن كانت توجد حمامات مياه ساخنة في السجن! نعم. لكننا كنا نتمنى ألا يأتي موعد الحمام أبداً. كان الجناح يتكون من تسعة مهاجع مأهولة أما العاشر فحوّلوه إلى حمامات.
أتمنى أن أستطيع تصوير الطريقة التي كنا نستحم بها. يأمروننا بالتعري ثم يُخرجوننا المهجع تلو الآخر بدءاً من المهجع الأول. يخرج أفراد المهجع بطريقة القطار التي وصفتها في “الاستقبال”، يمسك كل منهم بخصر الذي أمامه ويضع رأسه على مؤخرته كي لا يرى شيئاً ولا أحداً. أثناء سير القطار يرافقه سبعة إلى عشرة عساكر بضرب لا يتوقف. من يتعثر ويقع كانوا يضربونه وربما يجهزون عليه ويرمونه في المهجع، أما طويلو الأعمار فيصلون إلى الحمامات أخيراً.
غرف الحمام سبعة أو ثمانية. يدخل كل ثلاثة أو أربعة أو خمسة تحت الدوش الواحد الذي يقذف ماء فاتراً هو وسيلة الاستحمام الوحيدة. كنا نتدافع للاستحواذ على المركز والوقوف تحت مصب المياه الصغير والبطيء، كي نشرب شيئاً ساخناً ولتوقي الجرب وتنظيف الجلد ما أمكن. ولك أن تتخيل حصة الواحد من الماء طالما أن مدة الحمام المقررة هي عشر ثوان فقط والسجان يعد:
“واحد… اثنين… ثلاثة… أربعة… يلا يا عرصة! خمسة… ستة… سبعة… ثمانية… يلا يا عرصة!!… تسعة… عشرة!!”.
عندما يلفظ الرقم الأخير كان علينا أن نكون خرجنا جميعاً، المهجع كله أو من تبقى منه، وأخذنا وضعية القطار للعودة!! من يتأخر للحظة يتلقى من الضرب ما يدمّيه أو يكسره، وقد يقتله.
سبق أن قلت إنني كنت في المهجع السابع. كان هذا يعني أن ستة مهاجع تكون قد “استحمت” قبلنا وأن الأرض تكون مبتلة، مما يزيد من احتمال أن ينزلق أحدنا ويقع. وفي هذه الحالة يصبّ عليه غضب السجان حتى يغمى عليه أو يموت. ولذلك كنا ندعو الله ألا نخرج إلى الحمام.
محمد الثالث
كان اسمه محمد أيضاً، وهو ذو أصل تركماني من حلب. كان عنصراً في الجيش التابع للنظام. وكان معه شاب آخر من الجيش كنا نلقبه أبو إسكندر، كان لا يداوم على قطعته مقابل مبلغ يدفع لقائده، وهو ما يطلق عليه وصف “مفيِّش”. كان محمد وثلاثة من زملائه ينامون عند رفيقهم أبو إسكندر حين يحصلون على إجازة بسبب صعوبة السفر. في أحد الأيام أودت وشاية بأبو إسكندر، وتطور التحقيق معه من مجرد التهرّب من الخدمة إلى الاتهام بالتعامل مع “المسلحين”. وتحت التعذيب اعترف، ولما طلبوا منه أسماء شركائه في التآمر على الدولة رمى التهمة على زملائه الأربعة فقبض عليهم جميعاً وصاروا معنا.
قال لي محمد: “كنا نقاتل مع الجيش على خط الجبهة وبيننا وبين أعدائنا خمسون متراً فقط. كنا في خيمة وراء الدشم حين ألقوا القبض علينا. كيف هذا؟! من هؤلاء الذين نطلق النار عليهم إذاً؟ كيف نتعامل معهم؟ طيب ورفاقنا الذين قتلوا هنا؟”.
حين خرجت من السجن كان محمد ما يزال فيه، ولا أعلم مصيره بعد ذلك. أما أبو إسكندر فقد شهدت وفاته بسبب الهزال والمرض.
طبيب السجن
يأتي العناصر ومعهم طبيب أحياناً. نكون في الوضعية جاثياً ووجوهنا إلى الجدار. يأمروننا بتكرار الوقوف والجثو والقفز والهرولة في المكان، وأثناء ذلك يراقب الطبيب من يعجز عن الحركة أو يؤديها ببطء فيناديه. يسأله الطبيب عن اسمه، ومهما كان الجواب يضربه بضع ضربات ويكتب له على بطن زنده رقماً ويقول: “أنت اسمك مو فلان! اسمك 11833 (مثلاً). إياك أن تنساه”، ثم يأمره بالعودة إلى الصف. أذكر هذا الرقم لأنه كان رقمي حين مرضت.
في اليوم الثاني أو الثالث، عندما سيمشي “جنزير” إلى المشفى الذي يرتبط به السجن، وهو مشفى تشرين العسكري؛ يصيح السجان بالرقم. حين يجيب المريض “حاضر سيدي” كالمعتاد، يدخل السجان إلى المهجع وينهال عليه ضرباً حتى يميته ويتركه في مكانه أو يقوده إلى المشفى مدمىً!
هل قلتُ “مشفى”؟ كان مشفى تشرين العسكري فوبيا، مجازر جماعية، هولوكوست، مسكن موتى. في الحقيقة أعجز عن وصفه. كان سجن صيدنايا لكن بأسلوب آخر. لم يذهب أحد من مهجعنا إلى المشفى وعاد!
ورغم ذلك قررت الذهاب إليه! ربما مللت من المهجع بعد أن مات فيه من كانوا عزيزين عليّ واقتيد آخرون قريبون إلى قلبي إلى مكان مجهول، لا أذكر بالضبط.
كنت رياضياً نسبياً، كما قلت، لكنني قررت أن أبطئ حركتي لينتبه إليّ الطبيب، وبالفعل ناداني. كتب على يدي ثم سألني عن اسمي فقرأت الرقم المسجّل، ولما فعلت ذلك سرّ مني.
إلى مشفى تشرين العسكري
في اليوم التالي نودي على رقمي وخرجت. يجمعون المرضى من كل المهاجع في غرفة انتظار واحدة. بعضهم كان يحتضر وبعضهم يتنفس بصعوبة بالغة، أما من يعجز عن المشي فيشحطونه على الدرج وهم يضربونه. هناك لاحظت أن لهجة أحد المرضى تشبه لهجتي. تعرّفت عليه فاكتشفت أنه من قرية لصيقة لقريتي وأخذنا نتكلم. حين يخرجوننا من غرفة الانتظار إلى السيارة المغلقة (البراد) التي ستحملنا كان العساكر لا يعينون أحداً على الصعود. كانت مهمتنا أن نجرّ بعضنا. كانت أوزاننا خفيفة على كل حال؛ في حدود الثلاثين كيلوغراماً.
يستغرق الطريق إلى مشفى تشرين العسكري بين الثلاث والأربع ساعات. حين وصلنا اكتشفت أنهم لا يُدخلوننا إلى المشفى بل إلى زنزانة خارجه بطول 4 أمتار وعرض مترين ونصف وبزاويتها مرحاض. في هذه المساحة يضعون ما متوسطه 25-30 سجيناً قدموا إلى المشفى. ونحن ندخل الزنزانة كان آخرون يخرجون منها للعودة إلى صيدنايا، وبقي البعض.
تولى أحد السجناء من القدامى صفّنا لكنه أخطأ الترتيب والعد. غضب المساعد وصاح: “مين بيصير شاويش؟” فتبرع ابن منطقتي هذا، لأن زيارته للمشفى لم تكن الأولى وكان يعرف النظام. أخذ يرتبنا بسرعة فأعجب المساعد بذلك وقال له أن يختار مساعداً له فاختارني. وهكذا أصبحت “مساعد شاويش”.
لم أكن أعرف ماذا يعني هذا هنا!!! عندما خرج المساعد أتاني ابن منطقتي، ولأسمّه “الخال”، وقال لي إن مهمتنا بالغة الصعوبة! سألته: “خير؟ شو بده يصير؟!” فأجاب إن المساعد سيدخل بعد قليل ويأمر المرضى بالهرولة في المكان والوقوف والجثو، فمن كانت حالته معقولة سيدخل إلى المشفى، أما الضعفاء فستقع علينا مهمة تصفيتهم!
صُعقت وسألته: “كيف يعني بدنا نصفيه؟” فأجاب: “يعني بدنا نقتله… نموّته”. سألت من جديد: “لك شو عم تحكي يا زلمة؟!” فكرر كلامه وقال إننا إن لم نفعل ذلك فسنُقتل، أما إن فعلناه فسنأكل كثيراً!
اكتشفت أن الشاويش في زنزانة مشفى تشرين العسكري قاتل مأجور. هو سجين كالآخرين لكنه مستعد أن يقتلهم كي يأكل طعاماً جيداً يُقدَّم هنا بكمية وفيرة.
للتخلص من هذا المأزق اقترحت على الشاويش تغذية المرضى الموجودين وتمرينهم في الوقت القصير جداً المتاح كي لا يبقى بينهم ضعفاء. كان الشاويش ومساعده اللذين قبلنا قد ادخرا كمية مهولة من الطعام بالنسبة إلينا؛ حوالي 40 حبة بطاطا ونصف كيلو زيتون وأشياء أخرى. قسمنا الكمية بيننا، نحن الخمسة وعشرين، فكانت الوجبة تساوي ما يُقدَّم في صيدنايا لأسبوع أو لأيام. بعد الطعام شرحت لهم الوضع بصراحة كما أبلغني به الخال وقلت لهم إن عليهم أن يتحركوا.
كنت قد عرفت من الشاويش السيناريو القادم. في المساء يأتي المساعد الذي سيصحبنا إلى باب المشفى سائراً بنا الطريق، وطوله 150 إلى 200، وهو مفروش ببحص أبيض كبير. ولأن السجناء حفاة سيقع بعضهم ويعجز عن المشي فيضطر العساكر إلى شحطه أو سنده. وتوفيراً لهذا “العناء” كان المساعد يأمر المرضى بأداء بعض الحركات في الزنزانة استباقياً، فمن توقع أنه سيعجز عن المشي يشير إلى الشاويش بشحطه جانباً ثم يأمره: “اشتغل شغلك”!!
كانت طريقة التصفية في زنزانة مشفى تشرين العسكري هي أن يُلقى المريض على ظهره ويمسك واحد يديه وآخر قدميه، ثم يأتي الشاويش ومعه لفحة قماشية وعصا قصيرة، متروكين لهذا الغرض. يضع العصا على رقبة المريض ويلف الاثنتين، الرقبة والعصا، باللفحة. ثم يبرم العصا دورات عديدة واللفحة تشتد على الرقبة حتى يختنق المريض ويموت.
بهذه الطريقة يقتل السجين زملاءه، أربعة أو خمسة في اليوم.
لأجل ألا يضطر الشاويش إلى قتل أحد ذلك اليوم، وأقول “يضطر” لا “نضطر” لأنه من المستحيل أن أقتل، لجأنا إلى الآلية التي وصفتها. وعندما أتى المساعد استغرب. اصطحب أول دفعة منا ثم عاد لأخذ الثانية، دون أن يأمرنا بتصفية أحد.
في صباح اليوم التالي أُخرج الشاويش من المشفى وأُعيد إلى السجن مع “جنزير الصباح”. وهكذا أصبحت شاويش الزنزانة. أتوا بالفطور وكان كيساً كبيراً من الزيتون يزن خمسة كيلوغرامات وربما أكثر. لم يكن هناك داع لتقسيمه. وضعته وسط الزنزانة ليأكل كل واحد قدر ما يشاء ورغم ذلك لم ينته. وعند الغداء كانت حصة الواحد من البرغل تساوي خمسة أضعاف حصته في صيدنايا، أي أنها تشعر بالشبع قليلاً.
لأعترف هنا أنني خصصت نفسي بحصتين، إذ كان على شاويش الزنزانة أن يبقى ساهراً ليجده المساعد يقظاً في أي وقت، ولهذا كان الأمر يحتاج إلى شخصين، شاويش ومساعده. لم يكن عندي مساعد فاحتفظت بكمية قليلة من الطعام لتعينني على السهر. في المساء جاء شاب صغير يشكو من الجوع فقسمت هذه الحصة بيني وبينه نصفين. وبعد قليل جاء آخر فقسمت النصف الباقي نصفين. ثم أعلنت أنني مضطر إلى ما تبقى ليعينني على السهر.
تلك المرة الوحيدة التي عيّنت فيها شاويشاً، لساعات فقط، وفي الصباح التالي أذيع اسمي (رقمي) للعودة. كنت أظن أنهم سيرجعون بي إلى مهجعي لكنهم اقتادوني إلى ما يسمونه “مهاجع العزل”! وما هذه؟! هنا سيصبح سجني مضاعفاً.
في مهجع العزل
أدخلوني إلى مهجع لا أعرفه فوجدت من سمّيته “الخال” قبلي. سألته لماذا نحن هنا فأجاب إن نتيجة فحص لعابنا في المشفى بيّنت إصابتنا بالسل فحولونا إلى مهجع العزل الخاص بهذا المرض. هنا يعطون السجين بطانية واحدة، وجرت العادة أن يتشارك اثنان فيمدا بطانية على الأرض ويتغطيان بأخرى، وهو ما فعلناه أنا والخال، وصرنا نأكل سوياً. لكن ما هي إلا يومان حتى عجز عن تناول الطعام. صار يعطيني حصته فأرفضها وأحاول إجباره على تناولها. في اليوم الثالث أبدل فطوره والغداء الذي لم يأت بعد، بالشاي مع أحد الشباب. عمل فتة من الخبز المنقوع بالشاي وتناولها كلها. سررت لذلك جداً. في المساء تبادلنا حديثاً طويلاً عن قريتينا المتجاورتين وتخيلنا كيف سنزور بعضنا بعد الإفراج عنا حتى غلبنا النوم. في الصباح أخذت أوقظه فلم يرد عليّ. قفزت من مكاني وكشفت البطانية فإذا هو ميت.
لم أعرفه كثيراً لكنني كنت قد ارتحت إليه بسبب طيبته ولهجته القريبة، عدا عن أن الشعور أنه مات في الليل وأنني كنت نائماً بجوار جثة كان إحساساً مرعباً. بالإضافة إلى أنه مات بعد ثلاث سنوات قضاها في السجن. كان هذا يخيفني أيضاً فكنت أدعو الله ألا يطيل مدة سجني إلا إذا كانت ستنتهي بخروجي سالماً. كانت فكرة أن يموت المرء بعد معاناة كل هذا لسنوات فكرة صعبة جداً.
مات الخال إذاً… رحمه الله… “ربّعناه” وفق الطريقة التي شرحتها سابقاً وأخرجوه. لا أدري أين يذهبون بالجثث.
ظننت أن الضرب هنا سيخف لأننا مرضى، لكن ما أثار استغرابي أنه كان أكثر. لا أدري لماذا. واعتقدت أن كمية الطعام ربما تكون أكبر للعناية بنا لكنه صار يقل إلى درجة مخيفة! وصل الأمر إلى درجة أن يتركونا ستة أيام دون طعام ثم يحضروا للواحد ربع رغيف وزيتونة!! كانوا يزودوننا بالعلاج اللازم ولكن كيف؟ كان على الواحد منا أن يتناول ثلاث حبات في اليوم من الدواء، لكنهم كانوا يحضرون له حبة كل يومين.
أحسست أنني بدأت السجن من جديد. كان معظم الناس هنا ذئاباً أنانية مفردة رغم مرور أشهر على بعضهم في مهجع العزل، لكن ظروف المجاعة كانت تدفع الواحد إلى تمني موت رفيقه كي يأخذ حصته من الطعام. صرت أحن إلى مهجعي القديم وما يشبه الصداقة والتآلف الذي كنا فيه، وأراه رحمة بالقياس إلى حيث أنا الآن.
عندما أفكر في سيرة سجني أراها درجات هابطة لأسفل، تدفعني كل واحدة منها إلى النظر إلى الوراء واعتبار المرحلة التي مضت وكأنها جنة! عندما كنت في المهجع السابق لم أكن أتخيل أن هناك ما هو أسوأ من صيدنايا، أما الآن فقد عرفت أن في السجن نفسه مستويات من الشقاء. ولكن الحمد لله أن مهجع العزل سيكون محطتي الأخيرة.
إلى مشفى تشرين مرة أخرى
بعد دخولي هذا المهجع بحوالي شهرين أدخلوا علينا شاباً عائداً من المشفى. أخذنا نحادثه عما جرى معه فقال إنهم أكلوا هناك كمية وافرة من “مفرّكة البطاطا”، وهي البطاطا المطبوخة بالزيت. كان قد مضى علينا يومان دون طعام. وكان حلمي… كان حلمي في السجن قد انحصر في أن آكل مفرّكة بطاطا.
منذ زمن طويل لم أعد أفكر في الخروج. لم أعد أفكر في رؤية أهلي. لم أعد أفكر في التحرر من هذا المكان. هذا جوّي وهؤلاء مجتمعي.
عندما سمعت كلام الشاب، الذي أضاف أن زنزانة المشفى دون شاويش حالياً، قررت أن أذهب إلى هناك. حاول الزملاء ثنيي وذكروني بالقتل الذي قد يحدث ولكنني أصررت. سألني أحدهم عن السبب فقلت إنه “مفرّكة البطاطا”، فأخبرني أنها تقدّم يومي الاثنين والخميس. كنا في يوم الثلاثاء فقررت الذهاب يوم الخميس التالي.
بالطريقة نفسها، جاء الطبيب فتباطأت في الحركة. ناداني ومنحني رقماً. في اليوم اللاحق جمعونا في غرفة الانتظار التي حوت مرضى متفاوتين، بينهم محتضرون ومنهكون. هؤلاء ذاهبون إلى الموت، إلى التصفية، لكنهم لا يعرفون ذلك الآن. صعدنا إلى البراد وساعدناهم على ذلك كما في المرة الماضية. سار البراد. وصلنا إلى المشفى.
كان “جنزيرنا” هذه المرة أربعة عشر مريضاً، بينهم سبعة محتضرين أدخلوهم إلى الزنزانة فوراً، أما نحن الباقين فقد لاحظ عسكري “ابن حلال” لون جلودنا فأجلسنا في الشمس. كانت قد مرّت عليّ مدة سنة وثلاثة أشهر دون أن تمس الشمس جسدي. كنت ألمحها أحياناً دون أن أتعرض لأشعتها. صار كل همي في هذه اللحظة أن تدخل مسام جلدي لأكبر درجة. لو كانت الشمس قريبة وقتها لحضنتها!
كنا سبعة. وبجوار آخرنا على اليمين كيس قمامة شفاف. نكزني الجالس جانبي منبهاً إياي. عندما نظرت إلى الكيس تمنيت لو أن فيه بقايا طعام. لم أتخيل نفسي منكباً على القمامة آكل، لكنني لم أتناول في الأيام الثلاثة الماضية سوى الماء. خططنا، نحن الأقرب إلى الكيس، أن نتحيّن الفرصة عند عدم وجود عساكر فنهبش الكيس ونأكل ما قد نجده فيه، إذ لو رأونا لربما صفونا مباشرة.
حين رأينا الوقت مناسباً سحبنا الكيس وأخذنا ننبشه بسرعة. وجدنا فيه قشور برتقال، ثفل متة، أعقاب سجائر، وأكلنا كل ذلك! كنا نريد أن نشعر بأي طعم مختلف عن الكميات القليلة من البرغل والرز والزيتون في السجن.
وجدت ستة أشرطة صغيرة من بقايا البصل الأخضر! سحبتهم فرآهم زميلي وشدّهم من يدي! قلت: سأعطيك، ولكن اترك لي منهم. تسارعت أيادينا وارتفع حماسنا. تمزق الكيس واندلقت محتوياته مصدرة أصواتاً فأتى العسكري من خلفنا.
أخذ يكفر ويشتمنا لأننا نأكل من القمامة ويتساءل بغضب: “ليش نحن منقّصين عليكن أكل؟!”، ويتوعدنا بالحرمان من الطعام عند العودة!
كان ما تبقى من شرائط البصل الأخضر في يدي. خشيت أن يأمرني برميها فسارعت إلى التهامها. شعرت بطعمها الحدّ يمنحني طاقة هائلة.
أدخل الآخرين إلى الزنزانة وتركنا، نحن نابشي الكيس، في الخارج. أتى بأنبوب تمديدات صحية كبير، ذلك الذي يسميه السجانون “الأخضر الإبراهيمي”، بطول مترين أو ثلاثة، وصار يقفز ويضربنا جميعاً ضربة واحدة بأقصى ما يستطيع. كنا هياكل عظمية متلاصقة وكان الألم شديداً. شعرت أنني أموت. كان أصعب ما تعرضت له من ضرب بعد استقبال صيدنايا.
بعد حوالي خمس عشرة ضربة أمرنا بالدخول إلى الزنزانة بسرعة. كانت حالتنا مأساوية. لماذا نتعرض لكل هذا؟ لأننا أكلنا من كيس قمامة؟!
كنا قد جلسنا في الشمس نحو نصف ساعة، ثم تعرضنا للشتائم والضرب نحو ربع ساعة أو أكثر قليلاً. باختصار، تأخرنا عن دخول الزنزانة ساعة كان شديدو المرض قد صُفّوا خلالها…
اقتادونا إلى المشفى مطأطئي الرؤوس، يضع كل منا يديه على طرفي رأسه كي لا يرى شيئاً. لكنني شعرت أننا نمر إلى جانب بشر فخاطرت باستراق النظر. كنت أريد أن أرى أي شخص طبيعي. عندما لمحت امرأة ترتدي ثوباً أسود ورجلاً بقميص وبنطال شعرت بفرح غامر. حتى لو ضربني الآن لن أنزعج، فقد رأيت شيئاً جديداً، رأيت بشراً.
صوروا لي صدري هذه المرة. وفي اليوم التالي أعادونا إلى السجن. في المهجع سألني رفاقي: “أكلت مفرّكة؟” فأجبت: “لا والله”. كانت الوجبة التي قدِّمت لنا في المشفى شحيحة جداً تكاد تقتصر على الخبز ولم آكل شيئاً لليوم الخامس.
عندما وصلنا كان المساعد يهمّ بإدخال وجبة الغداء إلى المهجع. كنت مع أحد الزملاء عائدَين من المشفى وفي منتهى الضعف. بالكاد نجرّ أجسادنا ونوشك أن نتهاوى. قلت لزميلي: ما رأيك أن نطلب من المساعد أن نأكل من الطعام الذي مر أمامنا قبل توزيعه؟ فرفض الفكرة لأننا لن نقوى على تحمّل الضرب الذي قد يحصل نتيجة ذلك، وربما نموت. قلت: فلنمت إذاً!
قلت للمساعد: “يا سيدي ببوس إيدك! يا سيدي كرمال الله” فأجاب ناهراً وهو يصيح: “إيش بدك ولا؟”. شرحت له حالتي وصرت أتوسل أن يعطيني أي شيء؛ حبة بطاطا، حفنة برغل؛ قطعة خبز، أي شيء. صرخ في وجهي وشعرت أنه يهم بضربي فقلت: “يا سيدي اقتلني، اضربني، إيش بدك اعمل فيني… بس خليني آكل”. قال بعصبية: “هلق بتاكل بالمهجع!”. أجبت إننا كنا في المشفى ولن يحسبوا حسابنا بحصة الآن.
أحسست بطاقة هائلة هنا، فقد حققت إنجازاً كبيراً بمجرد أنني تحدثت إلى مساعد! شاركني زميلي في الكلام والتملق لكنه أسكتنا.
دخلنا مع جاطات الطعام إلى مهجعنا. كان زملاؤنا جاثين ووجوههم إلى الجدار. بمجرد دخولنا المهجع سقطنا أرضاً في شبه إغماء. لا يستطيع أحد أن يلتفت إلا بعد أن يخرج المساعد ولا أن يأكل لقمة إلا عند سماع إيعازه: “باشر طعام”. لكنه قال هذه المرة: “مهجع أربعة!”، فأجاب الزملاء: “حاضر سيدي” فقال: “الكلبين اللي فوّتتهن هلق بيقعدوا عالجاط بياكلوا ليشبعوا وبعدين بتوزعوا الأكل”!

عندما خرج انقضضنا على الطعام بشراهة بالغة لكن الأيادي امتدت لتمنعنا. بصراحة كان الحق معهم، فنحن جميعاً متساوون في المعاناة من الجوع، ولا يهم ما قاله المساعد، لكنني لم أستطع الابتعاد. غرفت غرفتين من البرغل وهم يسحبونني. التقطت حبة بطاطا ومضغتها بسرعة كي لا يتمكنوا من إخراجها من فمي. توقفت في حلقي فخنقتني. عجزت عن الكلام والتنفس فصرت أشير بيدي للآخرين لينقذوني لكن أحداً منهم لم يساعدني عقوبة لي، حتى سارع شاب حسن الأخلاق فقدّم لي الماء وصار يخبط على ظهري. وأخيراً… بلعت حبة البطاطا!
لم يكن ينبغي لي أن آكلها. كان ذلك خطأً ولكنك لن تميز الصحيح من الخاطئ هناك. كنت أظن يومها أنني ربما أموت لو انتظرت توزيع الطعام الذي يستغرق نصف ساعة. اعتذرت من زملائي وشرحت ما حصل في المشفى. تدخل بعض الأكبر سناً فشرحوا موقفنا… وسامحنا المهجع.
هل أقول “سامحونا”؟! على أي شيء؟ على أني أكلت حبة بطاطا دون توزيع. تخيل إلى أي درجة صار تفكيرنا محدوداً!
الحرمان من الطعام
خلال الأيام الأربعة القادمة استمر وصول الطعام، بكمية شحيحة طبعاً. وفي اليوم الخامس اختلف اثنان على اختيار بيضة بناء على لون قشرتها، الأبيض أو الأحمر، وعلا صوتاهما فقرروا معاقبة المهجع، وتوفقوا عن تقديم الطعام له خمسة أيام. انهارت قوانا وتوفي البعض. شعرت أيضاً أنني أموت. عجزت عن المشي فصرت أزحف تقريباً حين أتوجه لشرب الماء.
عندما يحرمون مهجعاً من الطعام كانوا يسلكون على الشكل التالي: يحضرون حصة المهجع في الجاطات، يضعونها على بابه دون أن يعرف نزلاؤه إن كانوا سيدخلونها اليوم أم سيحملونها ويعطونها للمهاجع الأخرى كما جرت عادة العقوبات. وهكذا كنا نسمع حصتنا تستقر وراء الباب لبرهة، ثم نشعر أن الآخرين يأكلونها!!
مرة أخرى تشجعنا، أنا وزميل المشفى نفسه، على مخاطبة المساعد! أخذنا نضرب على الباب ونستغيث. صار زملاؤنا يسكتوننا توقياً للضرب، لكن آخرين كانوا من رأينا: فليدخلوا ويقتلونا وينهوا عذابنا الطويل هذا!
جاء المساعد، ودون أن يفتح باب الجناح صار يخاطبنا ليفهم ما يجري. كان شخصاً غير الذي عاقبنا فلم يعرف القصة. أخبره الزملاء أن أحدنا قد اختلف مع آخر وعلا صوته، وكان الرجل قد مات خلال هذه الأيام، وأننا ما زلنا معاقبين بسبب ما فعله. كانت مهمتنا، نحن الأصغر سناً، أن نبكي بصوت عالٍ لنسترحمه. أجاب أخيراً: “تمام… تمام. أنا اليوم بحلّها”. حين سمعنا هذه الكلمات صار أملنا معلقاً بانتظار الغد، إذ كان احتجاجنا هذا بعد توزيع الغداء ولا يوجد طعام تالٍ اليوم.
في الغد أدخلوا لنا الفطور، وبعده الغداء، وعدنا إلى حياتنا “الطبيعية”.
سورة يس التي أنقذتنا
كنا نقضي يومنا بتبادل الروايات عن حيواتنا قبل السجن وعن آمالنا بعده. وكذلك بالطبع عن الأكل؛ كيف تُطبَخ الوجبة الفلانية وماذا يوضع فيها وكيف يُصنَع الحلو… إلخ. صرت أبحث عن جلسات دينية أو لحفظ القرآن. كنت أصلي جالساً لا بعينيّ، إذ كنت قد يئست من حياتي بعد كل ما جرى.
تحدثت سابقاً عن سورة يس. حفّظني إياها أحدهم في الفرع وقال لي: “يس لما قرئت له”. سألته ماذا يعني هذا؟ فقال إنك إذا أردت دعاء الله في أمر فاقرأها على نية أن يجيب الله طلبك أو يبعد عنك الشر. بدوري حفّظتها للكثيرين وصرت أقرأها قبل الخروج للتحقيق وعند أي دعاء أو حاجة.
في صيدنايا يُمنع أن ننام قبل أن يصدروا الإيعاز: “ناموا”. كان يفعلون ذلك في أوقات مختلفة؛ الواحدة ليلاً أو العاشرة أو قبل ذلك. مهما يكن الوقت علينا أن ننام، ولو سمعوا أي صوت بعده يكون مصيرنا الضرب.
في أحد الأيام تجاوزت الساعة الواحدة والنصف دون أن نسمع الأمر بالنوم. قلنا إنهم ربما كانوا سكارى ونسوا الإيعاز، أو ربما صدر الأمر ولم ننتبه له، خاصة أننا أخذنا نسمع أصوات تقاذف البطانيات لفرشها من المهجع المجاور. غلبنا النعاس وصرنا ننام في أماكننا بينما الشاويش يتنقل من هذا إلى ذاك ليوقظه، لأن السجانين يتسللون بهدوء أحياناً ويفاجئوننا، فإن وجدونا نائمين يصفّونه لأنه المسؤول. صار يحاول إيقاظنا لكن النعاس غلب الجميع تقريباً. قلنا له إنهم ربما نسونا ولن نستطيع أن نبقى ساهرين حتى الصباح، فأسقط في يده ووافق على مد البطانيات. وبينما أخذ البعض ينام سمعنا أصوات “دولاب” للسجن كله، وهي حفلة الضرب المتتالية لجميع المهاجع. كان هذا هو سبب غياب الإيعاز. بدأ الدولاب من الطابق الأول في الساعة الثانية. قلت سابقاً إن سماع أصوات التعذيب أشد من تلقيه بنفسك. كان صوتاً مرعباً جداً جداً أتمنى لو أنني أستطيع نقله أو وصفه. كأنك تدخل إلى مدينة خاوية فتسمع أصوات الأشباح وسط الرياح والعواصف، بل أشد من ذلك بكثير.
كنت جالساً مع شابين هما “جاريَّ” في وقفة الجاثياً، أحدهما إلى يميني والآخر إلى يساري. قلت لهما: فلنقرأ سورة يس على نية ألا يدخلوا علينا. قالا إن ذلك مستحيل فالدولاب يطال كل السجن وسيأتي دورنا مهما فعلنا. شجّعتهما بالقول الرائج: “أنت أكرم من رب العالمين؟”. كنت خائفاً مثلهما وربما أكثر، ولكن هذا ما كان بوسعي فعله! بدأنا بقراءة السورة بسرعة شديدة حتى أنني لم أعِ ما أقرأ منها، ولا أين وصلت. صرت أتعثر فيها فأعاود قراءتها منذ البداية، وهكذا قرأتها ثلاث مرات مضطربة.
أقسم بالله إنهم عندما دخلوا جناحنا ضربوا المهاجع الثلاثة التي قبلنا، وتجاوزوا الرابع، الذي كنا فيه، إلى الخامس، دون أي مبرر أو سبب سوى القرآن.
إثر ذلك غلبني بكاء لم أعرف مثله طيلة مدة سجني. عندما كنت أقرأ السورة كنت ألمح الأبواط العسكرية تروح وتجيء من أسفل الباب وكأنه لا يوجد مهجع هنا، لم يفتحوا الشرّاقة ولم يذكروا المهجع الرابع مجرد ذكر! شعرت أن معجزة قد حصلت، شعرت وكأنني خرجت من السجن، فقلت: يا رب، كما مننت علينا بالاستجابة اليوم، أخرجنا من هنا.
في المشفى لآخر مرة
بعد مدة، ولا أدري لماذا للمرة الثالثة، قررت الذهاب إلى مشفى تشرين العسكري! كان الزملاء ينصحونني أن الذهاب إلى المشفى ليس لعبة! كنت أعلم ذلك ولكن نجاتي من المرّتين السابقتين شجّعتني. ربما ذهبت لآكل “مفرّكة البطاطا” التي لم أحظ بها في المشوار السابق، لم أعد أذكر.
جرت الأمور على المنوال نفسه حتى صعدنا إلى البراد ومشى. تعرّفت إلى بعض من حولي فاكتشفت أنهم قادمون مما أسموه “الجناح الملكي”! فهمت أن هذا الجناح مخصص كي تزوره الهيئات الدولية إذا اضطر النظام للسماح لها بدخول السجن. يوضع فيه من يحظون بواسطات قوية، ويشبه السجون العادية، فيتوافر فيه الطعام والشراب والرياضة، وتكون أجساد نزلائه طبيعية.
بين الذين كانوا معنا في البراد من هذا الجناح رأيت شاباً كنت تعرفت إليه في أحد الأفرع وظننت وقتها أننا صرنا أصدقاء، وتعرّفت إلى زميل له آخر أحسست أنه كرهني بعد بضع كلمات. وعندما وصلنا صار يتبادل الكلام والمزاح مع المساعدين بطلاقة، وأصبح شاويشاً، بل صاروا كلهم “شاويشية”!
بوجودهم صارت كمية الطعام التي تصل إلى زنزانة المشفى كبيرة غير أننا لم نر منها شيئاً. قبل إدخال الأكل كانوا يأمروننا أن نلتفت إلى الجدار ثم يجلسون، كانوا خمسة أو ستة، وينكبون على الطعام بشراهة حتى ينتهي! أظن أنه كان طعاماً طيباً، ربما “مفرّكة بطاطا”!
أحياناً كانت الوجبة تتضمن زيتوناً أو بطاطا مسلوقة، مما ملوا من تناوله في السجن، فيعطوننا نصفه ويحتفظون بالباقي. كنت دون طعام لثلاثة أيام قبل مجيئي إلى المشفى حتى شعرت أن معدتي تكاد تقفز من جسدي ونحن نسمع أصوات أفواههم تمضغ الطعام. طلبت من الذي كنت أظن أنه صاحبي منهم، واسمه أبو حيدر على ما أذكر، لقمة واحدة… واحدة فقط، فأمرني بالوقوف. ظننت أنه سيأخذني ليطعمني فوقفت. كان الذي كرهني ينظر إلينا ليرى ماذا سيفعل صاحبي الذي فوجئت بأنه أمسكني من رقبتي ورفعني وهو يقول بلهجة علوية مصطنعة: “بدك أكل؟!!”.
كانت هذه آخر جملة سمعتها قبل أن أفقد الوعي وأسقط على الأرض. لم أدر ما حدث بعد ذلك، لكن من كانوا معنا من المرضى رووا ما سأنقله الآن.
اجتمع الستة عليّ. صار بعضهم يضربني وآخرون يقفزون على جسدي. كان وزن الواحد منهم سبعين أو ثمانين كيلوغراماً. ثم صاروا يحملوني ويخبطونني بالأرض. استمر هذا ربع ساعة توقعوا بعدها أنني انتهيت فوضعوني مع الموتى. كانت الجثث توضع فوق بعضها فجاء نصيبي فوق جثتين، ثم وضعوا عليّ اثنتين أخريين لمريضين صفّوهما بعدي. بعد حوالي نصف ساعة أخذت أصحو. سرت قشعريرة مؤلمة في جسدي منذ أصابع قدميّ.
في ما بعد سأحكي لأحد الأطباء فيشرح لي أن قلبي توقف ثم عاد إلى الحياة وبدأ بضخ الدم مجدداً. أظن أن هذا صحيح، لأنني صرت أشعر بأعضائي بالتدريج كلما ارتفعت القشعريرة. تحركت قليلاً فوقعت الجثتان من فوقي. صرت أصيح بشكل مهول بصوت لا أدري من أين أتى. أظن أن المشفى كله سمعني يومها. شعر الشاويشية الشبيحة بالخوف فهرعوا إليّ ثانية، يضربونني على رأسي وبطني وكليتيّ، على كل مكان، وأنا لا أتوقف عن الصراخ. صار أحدهم يبكي ويقول: “مشان الله سكّتوه!” وهم مستمرون بضربي. كنت عارياً أو بالسروال الداخلي القصير، وكنت قد تبولت وتبرزت لا إرادياً.
كانت القشعريرة قد ارتفعت من القدم إلى الساق إلى الفخذ، وصرت أشعر أنني رِجلان فقط، إذ لم أكن قد استعدت الإحساس بوسطي ونصفي الأعلى بعد. عندما وصل جريان الدم إلى قلبي شعرت به ينبض بألم شديد. لم أكن قد استعدت رأسي ويديّ كذلك. عندما اكتملت الدورة ووصلت القشعريرة إلى رأسي انتفضت وفتحت عينيّ. واجهتني قدم تهم بضربي لكنها نزلت بسرعة دون أن تفعل. ابتعدوا عني لأنني عدت من الموت وخافوا بشدة. ارتجفت وتوقفت عن الصراخ.
سمعنا صوت باب الزنزانة. قلت إن صوتي لا بد أنه وصل إلى المشفى، بل ربما إلى نصف دمشق! أثناء فتح الباب عاد إليّ الخوف وخلال ثانية فكرت. كانت فضلاتي قد لوثت الأرض وخشيت أن يسأل المساعد عمن تسبب فيها ويخبره هؤلاء فيضربني أو يقتلني. انحنيت لأجمعها وأرميها في المرحاض ثم أغسل يديّ وأعود ثانية.
فُتح باب الزنزانة. أخذت الوضعية جاثياً وأنا خارج من المرحاض. دخل طبيب وسأل عمّن كان يصرخ فأبلغه الشاويشية أنه أحد الذين ماتوا. كان يمنع قتل المرضى، فهو طبيب في النهاية، لكن المساعدين والعساكر هم من ابتدع نظام التصفية كي لا يبذلوا جهداً في جرّ المحتضرين والضعفاء إلى المشفى.
أوعز الطبيب لنا: “واقفاً” فاستجبنا. ثم أمرنا أن نلتفت إليه. لم يصدّق كلام الشاويشية وأراد معرفة من الذي كان يصيح. استدرنا فأمر: “راسك بالأرض!”. أطرقنا. يُمنع أن نرى الطبيب أيضاً. نظر إلينا ثم قال لي: “تعا لعندي”. لم أرد فكرر: “أنت… آخر واحد عاليمين… تعا لعندي”، فأجبت: “أمرك سيدي”. ذهبت إليه فقال: “ارفع راسك لفوق”. قلت: “سيدي… ممنوع”، فقال: “أنا عم قلك ارفع راسك… وشوفني معليش”. رفعت رأسي ورأيته. كان شاباً في حوالي السابعة والعشرين بلحية شقراء خفيفة. سألني: “مين عم يضربك؟” فأجبت: “ما حدا سيدي”. كرر سؤالي مراراً ولكنني خفت فلم أبح بشيء. سألني عن اسمي ومنطقتي وتهمتي وأخذ يحادثني ثم سألني: “جوعان؟”. أحسست أنه تعاطف معي فأجبته نعم، وقلت إنني لم آكل منذ أربعة أيام. قال: “ما عم يطعموكن هدول الشاويشية الكلاب؟”. خفت ثانية وخشيت أنه يستدرجني فأجبت: “والله يا سيدي… طعمونا… بس أنا جوعان كتير”. أمر العسكري أن يذهب فيحضر ما يجده عندهم من خبز فعاد بكمية كبيرة وضعها على طاولة خارج الزنزانة. تحرك أحد الشاويشية لإدخالها فنهره وأمرني أنا أن أفعل. عندما أدخلت الخبز قال لي أن آخذ رغيفاً لي في البداية ثم أقسم الباقي بالتساوي وتكون لي فيه حصة كالآخرين. أجبت: “أمرك سيدي”.
بمجرد أن خرج الطبيب انقض الشاويشية الشبيحة عليّ وانتزعوا مني الخبز وأوعزوا لي بالعودة إلى مكاني. كان الخبز يكفي لإعطاء كل سجين رغيفاً كاملاً لو وُزِّع بالتساوي، لكنهم استأثروا به وأعطوا كلاً منا ربع رغيف. أما أنا فأعطوني نصف رغيف لأني لم أشِ بهم. ثم نظر إليّ أبو حيدر وأعطاني ربعاً آخر. أكلت وقتها ثلاثة أرباع رغيف، وهو ما لم يحصل لي خلال كل مدة سجني في صيدنايا!!
لقراءة مدخل وأجزاء الكتاب

 Eng
Eng